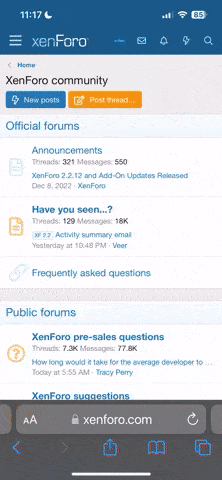أيمن الشيخ
New member
بسم1
تلبية لطلب بعض الدكاترة والإخوة الفضلاء أحببت أن أتحف موقعكم المتميز بهذه الإطلالة التعريفية برسالتي المقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير، من خلال النقاط الآتية:
أ- عنوان الرسالة:
( الجامع المقدَّم في شرح الجوهر المنظَّم في رسم الكتاب المعظم) لأحمد بن محمد الحاجي الشنقيطي (تـ 1251هـ)من قوله فصل في ذكر الألف المحذوفة بعد النون إلى آخر شرح نظم الرسم, دراسة وتحقيقاً
بإشراف:فضيلة شيخنا، أ.د/ محمد بن سيدي محمد بن محمد الأمين العام الجامعي: 1432- 1433هـ
ب- أهميتها في مجال علم الرسم:
1- اعتماد مؤلفه على عدة مصادر في علمي الرسم والضبط تعد من المصادر الأصلية في هذا الفن، مثل كتابي المقنع, والمحكم، للإمام أبي عمرو الداني، وكتاب التنـزيل، لأبي داوود سليمان بن نجاح، وعقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي, والمنصف للبلنسي، وأيضاً المصادر الأخرى، كالمقدمة الجزرية، وشروحها، كشرح زكريا الأنصاري، وكتاب مورد الظمآن للخراز، وشروحه.
2- بيان المؤلف لما بين علمي الرسم والقراءات من علاقة ضرورية لازمة لارتباطهما ببعض.
3- تبرز في الكتاب شخصية المؤلف العلمية باعتماده الدليل الصحيح المنقول عن أئمة هذا العلم، دون النظر إلى ما هو متداول من الخط بين الناس بحجة العمل، بل أحياناً يخطئه.
4- أن هذا الكتاب يحتوي على نظم وشرح, وهذا الشرح للناظم نفسه, فهو أدرى من غيره بمحتوى كل منهما وأوضح بياناً حين يفك عباراته، ويشرح قصده منها، وهذا مما يجعل الكتاب نظماً وشرحاً واضحاً يسهل تناوله ويحقق مطلوبه.
5- أن المؤلف ضمَّن شرحه هذا كثيراً من نظم له أسماه مبين المشهور في خط المسطور, نظمه الشيخ في رسم المصاحف وبيان الخلاف بينها، وعدة أبياته (770) بيتاً، يعتبر شرحاً للجوهر المنظم وشواهد للجامع المقدم, ويكون الجوهر المنظم بمنـزلة الحاشية على مبين المشهور, وقد ذكر ذلك المؤلف - رحمه الله - في مقدمة هذا المخطوط.
6- تلقي العلماء هذا الكتاب بالقبول, واعتماد بعضهم على نظمه، كما فعل الشيخ الدنبجة بن معاوية التندغي في نظمه المسمى (المقرب المبسوط في المرسوم والمضبوط) حيث صرح بالاعتماد عليه في مقدمة نظمه فقال:
بالمحتوي الجامع فيه أَءْتمي @ وأَءْتمـي بالجوهر المنظّم
وربــما بمـورد الظمآنِ @ وشرحه ابن عاشر في آنِ
7- أن المؤلف له في هذا العلم عدة مؤلفات تجعله في هذا الميدان فارسه فقد ألف فيه هذا النظم والشرح الذي بين أيدينا، وأنظاماً أخرى عديدة منها:
8- أ- مبين المشهور في خط المسطور، وهو نظم في رسم المصاحف والخلاف بينها تصل أبياته إلى 770 بيتاً.
9- ب- اللؤلؤ المنظوم في علل الرسوم.
10- ج- القول المعد فيما للرسم لا اللفظ يمد, في ضبط القرآن.
11- د- جوهرة الإملاء، وهو نظم فريد في الضبط للصبيان.
12- هـ- تحفة الأصاغر في ذكر ما يخفى من النظائر, وقد شرحه بكتاب هداية الحائر.
13- ويلاحظ أن أغلب مؤلفات هذا العلامة لا تزال مخطوطة، لم تلق ما تستحقه من مزيد عناية بالدراسة والتحقيق ليعظم نفعها.
14- أن المؤلف عاش في عصر اهتم علماؤه بالنظم والشرح في علوم القرآن الكريم, وفي علم رسمه وضبطه خاصة كالعلامة الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين، المتوفى 1250هـ مؤلف نظم المحتوى الجامع، رسم الصحابة وضبط التابع، وشرحه الإيضاح الساطع, الذي عليه جرى العمل عند المغاربة، وقد اعتمده أيضاً مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة، في طباعته، لروايتي ورش وقالون، ومع ما للمحتوى الجامع من أهمية في تجريده عن ذكر المصادر وفي اقتصاره على المشهور الذي عليه العمل عند المغاربة تسهيلا لأخذه على طلاب العلم, فإن مؤلف الجامع المقدم – موضع الدراسة- قد سلك في نظمه وشرحه مسلكاً آخر تمثل فيما يلي:
15- أ - تصريحه بالمصادر التي اعتمد عليها، وهي مصادر أصلية عمدة في بابها.
16- ب- تنصيصه في كل فصل على مسائل الخلاف فيه، والتزامه نسبة الأقوال إلى أصحابها، وذكره الراجح منها, وبيانه للمعمول به لدى المغاربة.
17- كون القصيدة المشروحة من بحر الرجز, فهي سهلة الحفظ على الطلاب واضحة الألفاظ سلسة العبارة، ليس فيها غموض.
18- وإنني أرجو بعملي هذا مثوبة الله بأن أقدم لدارسي علوم القرآن الكريم جديداً من إحدى لبناته التي ألفها الشيخ في علم الرسم, مساهمة في التعريف بجهود علمائنا وإخراج تراثهم وتسهيله لطلاب العلم, وبالله أستعين طالباً منه التوفيق والسداد.
ت- منهج المؤلف في كتابه:
موضوع كتاب الجامع المقدم في شرح الجوهر المنظم هو علم الرسم, وفيه يشرح مؤلفه نظمين منفصلين: أحدهما في الرسم, والآخر في الضبط. وافتتحه المؤلف بمقدمة ضمنها أهمية علم الرسم والحاجة إليه, بعد أن عرف فيها بنفسه وحمد الله وصلى وسلم على الرسولr , ثم شرع في بيان بواعث تأليفه فقال: "وبعد: فلمّا رأيت الناس اليوم قد اتخذوا القرآن مهجوراً، ولم أَلْفه عند أكثرهم منصوراً, لَمَّا رأيت ذلك كله وأكثر، نظمت رسم الكتاب المطهَّر, ثم ما ضبط به بعد ذلك, وكنت سميته بـالجوهر المنظّم في رسم الكتاب المعظّم, ثم طلب منّي جماعة من الإخوان, أن أضع لهم عليه شرحاً يوضح معانيه, فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة, وسميته بـالجامع المقدَّم في شرح الجوهر المنظَّم".
ولأن المؤلف يتناول علمي الرسم والضبط للمصحف الشريف, وبيان مسائلهما, فإنه قد سلك في هذا البيان مسلكاً علمياً تتضح أماراته شكلا ومضموناً فيما يلي: -
1- اعتمد المؤلف في موضوع الكتاب على مصادره الأصلية, التي هي الأمهات فيه, ثم على مصادر أخرى في الرسم والضبط وعلوم اللغة, وقد ذكر بعضها بقوله:
فإن في تنـزيلِنا والمنصــفِ @ ومُقنعٍ لَمَقْنَعاً للمنصــفِ
وما ذكرتُ فيه إلا ما كُتب @ في هذه أو شبهِها من الكُتب
2- قدم المؤلف كتابه مصنفاً إلى أقوال وفصول، فهو يشرع في ذكر الموضوع بقوله: القول في ... , فالأقوال عنده كالأبواب التي تندرج تحتها الفصول, وفيها يقدم المؤلف محتواها من المسائل والفروع, ورتب الحروف المحذوفة بالترتيب الهجائي (الألفبائي) على طريقة المشارقة عكس ما هو معهود في بلده ومحيطه المغاربي, وأحياناً يذكر في الشرح بعض التنبيهات والفوائد, مرتباً بطريقة جامعة وافية.
3- مزج المؤلف -رحمه الله- في كتابه بين الشرح والنظم مزجاً يصعب معه تمييز أحدهما عن الآخر.
4- استعمال أسلوب الإجمال والتفصيل, فهو يذكر عناصر الموضوع في أول الكلام عليه مجملة, ثم يفصلها بعد ذلك.
5- التحديد الدقيق في عزوه للمراجع فمن ذلك تحديده موضعاً في كتاب النشر بقوله: ثم قال بعد أربعة أسطر ونصف.
6- اصطلح المؤلف على ذكر لفظ (غير) في الإشارة إلى الموضع القرآني المتكرر حيث يمثل له بمثال, أو أكثر ثم يقول "وغير" طلباً لاختصار.
7- استعمل المؤلف مصطلح (الشيخان), ويعني بهما الشيخين الجليلين: أبا عمرو الداني، وأبا داود بن نجاح, وأحياناً يصفهما بالإمامين, كما استعمل مصطلح (الأخَوان) لحمزة والكسائي كذلك.
8- إذا لم يُقيد المؤلفُ اللفظَ المكررَ بقيد مَّا فإنه يقصد بذلك إطلاقه في سائر القرآن فهو يقول في ذلك -رحمه الله-:
واللفظُ إن لم تلْفه مُقيَّدَا @ فهو كما ذكرتُ حيث وُجدَا
ومن أمثلة القيود التي ساقها المؤلف أسماء السور والأحزاب والأثمان وغيرها كالمجاورة والحرف والأوائل والأواخر.
9- التزم المؤلف قراءة الإمام نافع -رحمهما الله- فيما يذكره من الرسم, معللا ذلك بأنها هي التي عهدت في قطره وضبطت بها المصاحف وانتشرت, يقول رحمه الله:
وفقَ قراءةِ الإمامِ نافع @ إذْ عُهِدتْ في سائر المواضِع
10- ذكره للقراءات التي يتفق معها وجه الرسم تعليلا لوروده بالحذف أو الزيادة أو نحوهما, فهو كثيراً ما يقول: إشارة إلى قراءة كذا، مقتصراً على القراءات السبع.
11- اقتصاره على المشهور فقط مما وقع فيه الخلاف في المسطور والمرسوم عن المشايخ المعتمدين, إلا إن ترجح لديه كلا القولين وتساويا في القوة عنده فعندئذ يطلق القولين ويصرح بهما، قال رحمه الله:
مختصراً على الذي منها اشتهر @ من غير ذكر الْخُلف إلا ما ندر
ودون عزو خِيفة التطويــلِ @ بذكر أهله سوى القليــلِ
12- ذكره ما جرى به العمل غالباً عند المغاربة في المسائل التي يذكر فيها خلافاً.
13- إكثاره النقل عن كتاب ابن القاضي: بيان الخلاف والتشهير, خاصة في مسائل الترجيح أو الاستدراك على مورد الظمآن.
14- استشهاد المؤلف بكثير من المنظومات الرجزية له أو لغيره, وبخاصة من نظميه: مبين المشهور, واللؤلؤ المنظوم, وكثيراً ما يُعقِب نقله عن ابن القاضي في بيان الخلاف والتشهير بشاهد من نظمه مبين المشهور؛ تأييداً له في الغالب.
15- إعراب المؤلف ما في بعض الأبيات من ألفاظ تحتاج إلى توضيح وبيان لدلالتها في المعنى.
16- مراعاة المؤلف التبسيط والتقريب في المسائل التي قد يستغني فيها بالتقييد باللغة, فيبينها بطريقة سهلة بوضع علامات لفظية واضحة وجلية, لا يحتاج صاحبها إلى معرفة نحو ولا صرف، كالمبتدئين والصبيان فهو يقول -رحمه الله-:
آثرتُ في ذاكَ من العبارة@ما يفهمُ الصبيانُ من إشارة
17- سوق الفوائد اللغوية المتعلقة بعلم الرسم, وكذلك حصر بعض المسائل.
18- اعتناؤه بعلم العروض واستطراده أحياناً في ذلك.
19- تأثره بصاحب مورد الظمآن, وشروحه كفتح المنان لابن عاشر في طريقة عرضه في النظم وفي الشرح.
ث- القيمة العلمية للكتاب:
تظهر قيمة كتاب الجامع المقدّم في شرح الجوهر المنظّم بمعرفة موضوعه, وما يقدمه مؤلفه فيه من جهد يجمع بين دفتيه من علمي الرسم, والضبط, واستعان بعلوم أخرى على توضيحهما, وهي: القراءات, والتوجيه, واللغة من نحو وصرف وعروض, ويعتبر هذا الكتاب خلاصة زبدة مؤلفات الشيخ أحمد الحاجي -رحمه الله- في هذا الجانب.
وهذه القيمة العلمية للجامع المقدم في شرح الجوهر المنظم تجعله يضيف جديداً مفيداً, مؤثراً فيمن بعده, يُثري المكتبة العربية الإسلامية عامة, ومكتبة علوم القرآن الكريم خاصة بما امتاز به بين الكتب المشهورة في القطر الموريتاني من ميزات عديدة لعل من أهمها:
1- جمعه ما تفرق في كثير من كتب الرسم, وبخاصة ما لم يذكره صاحب مورد الظمآن, وما استدركه عليه من جاء بعده من شرَّاحه، أو من ألف خصيصاً فيما أغفله الخراز كابن القاضي وغيره.
2- تضمينه من مهمات مسائل الضبط ما تمس الحاجة إليه في كتابه.
3- ذكر ما عليه العمل عند المغاربة من مسائل الخلاف التي يذكرها.
4- الترجيح في بعض الكلمات المختلف فيها سواء في الرسم أو الضبط.
5- ذكر بعض إحصائيات عديدة للكلمات القرآنية مما يساعد في حصر الأمثلة, وتسهيل حفظها.
6- بيانه للعلاقة الضرورية بين القراءات والرسم وارتباطهما ببعض، وقد امتاز المؤلف في هذا الجانب إذ لم يترك من هذا النوع شيئاً إلا وحصره.
7- ذكره للقواعد الكلية في الموضوع ثم بيان ما يخرج عنها من جزئيات ومواضعها, كأسباب الحذف ونحوها.
8- نقله عن كتب في الرسم تعتبر مفقودة ككتاب عثمان الدخيسي المغربي في الرسم.
ج- النتائج والتوصيات:
1- بيان المؤلف للعلاقة الضرورية بين علم رسم القرآن وعلم القراءات, واستصحاب المؤلف لهذه العلاقة, بياناً لها وتعليلا بها, فعلما الرسم والقراءات صنوان متلازمان.
2- شمول الكتاب المحقق لكثير من الأمور المهمة التي يحتاج إليها من علم الضبط إلى جانب علم الرسم, وتضمينه فوائد وتنبيهات وإحصاءات تتعلق بالكلمات القرآنية أو اللغوية ونحوها.
3- إن باب (الحذف) من علم الرسم هو أكبر أبوابه, فقد استغرق أكثر من نصف الكتاب الذي اشتركت في تحقيقه أنا وزميلي محمد محمود ولد الداه.
4- حسن انتفاع المؤلف بكل أجزاء وقته من ساعات عمره وأيامه, وما حباه الله فيه من بركة, فمؤلفاته ضعف سِنِيِّ عمره القصير نسبياً, مما يؤكد أن العمر ببركته لا بطوله.
5- متابعة المؤلف خطوات العلماء السابقين عليه في الأخذ عن بعضهم, ونقل اللاحق منهم عن السابق, بأمانة وموضوعية, فقد نقل المؤلف عن أسماء لم تكن معروفة لعلماء سابقين كالدخيسي مما يوحي بسعة اطلاعه, ويدعو إلى متابعة البحث.
6- دعوة الباحثين والدارسين إلى استكمال موضوع كتاب الجامع المقدم دراسة وتحقيقاً لنظم الضبط, فقد قرنه المؤلف بنظم الرسم وشرحهما جميعاً في الجامع المقدم.
وقد أخذ أحد الطلاب بهذه التوصية مشكوراً، الجزء المتبقية من الكتاب في رسالته التكميلية في نفس القسم بكلية القرآن الكريم.
7- ضرورة متابعة الدراسة والتحقيق لما ذكرته من كتب للمؤلف ليعظم الانتفاع بها, وتخرج في رسائل جامعية أو بحوث علمية.
هذا وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
تلبية لطلب بعض الدكاترة والإخوة الفضلاء أحببت أن أتحف موقعكم المتميز بهذه الإطلالة التعريفية برسالتي المقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير، من خلال النقاط الآتية:
أ- عنوان الرسالة:
( الجامع المقدَّم في شرح الجوهر المنظَّم في رسم الكتاب المعظم) لأحمد بن محمد الحاجي الشنقيطي (تـ 1251هـ)من قوله فصل في ذكر الألف المحذوفة بعد النون إلى آخر شرح نظم الرسم, دراسة وتحقيقاً
بإشراف:فضيلة شيخنا، أ.د/ محمد بن سيدي محمد بن محمد الأمين العام الجامعي: 1432- 1433هـ
ب- أهميتها في مجال علم الرسم:
1- اعتماد مؤلفه على عدة مصادر في علمي الرسم والضبط تعد من المصادر الأصلية في هذا الفن، مثل كتابي المقنع, والمحكم، للإمام أبي عمرو الداني، وكتاب التنـزيل، لأبي داوود سليمان بن نجاح، وعقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي, والمنصف للبلنسي، وأيضاً المصادر الأخرى، كالمقدمة الجزرية، وشروحها، كشرح زكريا الأنصاري، وكتاب مورد الظمآن للخراز، وشروحه.
2- بيان المؤلف لما بين علمي الرسم والقراءات من علاقة ضرورية لازمة لارتباطهما ببعض.
3- تبرز في الكتاب شخصية المؤلف العلمية باعتماده الدليل الصحيح المنقول عن أئمة هذا العلم، دون النظر إلى ما هو متداول من الخط بين الناس بحجة العمل، بل أحياناً يخطئه.
4- أن هذا الكتاب يحتوي على نظم وشرح, وهذا الشرح للناظم نفسه, فهو أدرى من غيره بمحتوى كل منهما وأوضح بياناً حين يفك عباراته، ويشرح قصده منها، وهذا مما يجعل الكتاب نظماً وشرحاً واضحاً يسهل تناوله ويحقق مطلوبه.
5- أن المؤلف ضمَّن شرحه هذا كثيراً من نظم له أسماه مبين المشهور في خط المسطور, نظمه الشيخ في رسم المصاحف وبيان الخلاف بينها، وعدة أبياته (770) بيتاً، يعتبر شرحاً للجوهر المنظم وشواهد للجامع المقدم, ويكون الجوهر المنظم بمنـزلة الحاشية على مبين المشهور, وقد ذكر ذلك المؤلف - رحمه الله - في مقدمة هذا المخطوط.
6- تلقي العلماء هذا الكتاب بالقبول, واعتماد بعضهم على نظمه، كما فعل الشيخ الدنبجة بن معاوية التندغي في نظمه المسمى (المقرب المبسوط في المرسوم والمضبوط) حيث صرح بالاعتماد عليه في مقدمة نظمه فقال:
بالمحتوي الجامع فيه أَءْتمي @ وأَءْتمـي بالجوهر المنظّم
وربــما بمـورد الظمآنِ @ وشرحه ابن عاشر في آنِ
7- أن المؤلف له في هذا العلم عدة مؤلفات تجعله في هذا الميدان فارسه فقد ألف فيه هذا النظم والشرح الذي بين أيدينا، وأنظاماً أخرى عديدة منها:
8- أ- مبين المشهور في خط المسطور، وهو نظم في رسم المصاحف والخلاف بينها تصل أبياته إلى 770 بيتاً.
9- ب- اللؤلؤ المنظوم في علل الرسوم.
10- ج- القول المعد فيما للرسم لا اللفظ يمد, في ضبط القرآن.
11- د- جوهرة الإملاء، وهو نظم فريد في الضبط للصبيان.
12- هـ- تحفة الأصاغر في ذكر ما يخفى من النظائر, وقد شرحه بكتاب هداية الحائر.
13- ويلاحظ أن أغلب مؤلفات هذا العلامة لا تزال مخطوطة، لم تلق ما تستحقه من مزيد عناية بالدراسة والتحقيق ليعظم نفعها.
14- أن المؤلف عاش في عصر اهتم علماؤه بالنظم والشرح في علوم القرآن الكريم, وفي علم رسمه وضبطه خاصة كالعلامة الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين، المتوفى 1250هـ مؤلف نظم المحتوى الجامع، رسم الصحابة وضبط التابع، وشرحه الإيضاح الساطع, الذي عليه جرى العمل عند المغاربة، وقد اعتمده أيضاً مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة، في طباعته، لروايتي ورش وقالون، ومع ما للمحتوى الجامع من أهمية في تجريده عن ذكر المصادر وفي اقتصاره على المشهور الذي عليه العمل عند المغاربة تسهيلا لأخذه على طلاب العلم, فإن مؤلف الجامع المقدم – موضع الدراسة- قد سلك في نظمه وشرحه مسلكاً آخر تمثل فيما يلي:
15- أ - تصريحه بالمصادر التي اعتمد عليها، وهي مصادر أصلية عمدة في بابها.
16- ب- تنصيصه في كل فصل على مسائل الخلاف فيه، والتزامه نسبة الأقوال إلى أصحابها، وذكره الراجح منها, وبيانه للمعمول به لدى المغاربة.
17- كون القصيدة المشروحة من بحر الرجز, فهي سهلة الحفظ على الطلاب واضحة الألفاظ سلسة العبارة، ليس فيها غموض.
18- وإنني أرجو بعملي هذا مثوبة الله بأن أقدم لدارسي علوم القرآن الكريم جديداً من إحدى لبناته التي ألفها الشيخ في علم الرسم, مساهمة في التعريف بجهود علمائنا وإخراج تراثهم وتسهيله لطلاب العلم, وبالله أستعين طالباً منه التوفيق والسداد.
ت- منهج المؤلف في كتابه:
موضوع كتاب الجامع المقدم في شرح الجوهر المنظم هو علم الرسم, وفيه يشرح مؤلفه نظمين منفصلين: أحدهما في الرسم, والآخر في الضبط. وافتتحه المؤلف بمقدمة ضمنها أهمية علم الرسم والحاجة إليه, بعد أن عرف فيها بنفسه وحمد الله وصلى وسلم على الرسولr , ثم شرع في بيان بواعث تأليفه فقال: "وبعد: فلمّا رأيت الناس اليوم قد اتخذوا القرآن مهجوراً، ولم أَلْفه عند أكثرهم منصوراً, لَمَّا رأيت ذلك كله وأكثر، نظمت رسم الكتاب المطهَّر, ثم ما ضبط به بعد ذلك, وكنت سميته بـالجوهر المنظّم في رسم الكتاب المعظّم, ثم طلب منّي جماعة من الإخوان, أن أضع لهم عليه شرحاً يوضح معانيه, فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة, وسميته بـالجامع المقدَّم في شرح الجوهر المنظَّم".
ولأن المؤلف يتناول علمي الرسم والضبط للمصحف الشريف, وبيان مسائلهما, فإنه قد سلك في هذا البيان مسلكاً علمياً تتضح أماراته شكلا ومضموناً فيما يلي: -
1- اعتمد المؤلف في موضوع الكتاب على مصادره الأصلية, التي هي الأمهات فيه, ثم على مصادر أخرى في الرسم والضبط وعلوم اللغة, وقد ذكر بعضها بقوله:
فإن في تنـزيلِنا والمنصــفِ @ ومُقنعٍ لَمَقْنَعاً للمنصــفِ
وما ذكرتُ فيه إلا ما كُتب @ في هذه أو شبهِها من الكُتب
2- قدم المؤلف كتابه مصنفاً إلى أقوال وفصول، فهو يشرع في ذكر الموضوع بقوله: القول في ... , فالأقوال عنده كالأبواب التي تندرج تحتها الفصول, وفيها يقدم المؤلف محتواها من المسائل والفروع, ورتب الحروف المحذوفة بالترتيب الهجائي (الألفبائي) على طريقة المشارقة عكس ما هو معهود في بلده ومحيطه المغاربي, وأحياناً يذكر في الشرح بعض التنبيهات والفوائد, مرتباً بطريقة جامعة وافية.
3- مزج المؤلف -رحمه الله- في كتابه بين الشرح والنظم مزجاً يصعب معه تمييز أحدهما عن الآخر.
4- استعمال أسلوب الإجمال والتفصيل, فهو يذكر عناصر الموضوع في أول الكلام عليه مجملة, ثم يفصلها بعد ذلك.
5- التحديد الدقيق في عزوه للمراجع فمن ذلك تحديده موضعاً في كتاب النشر بقوله: ثم قال بعد أربعة أسطر ونصف.
6- اصطلح المؤلف على ذكر لفظ (غير) في الإشارة إلى الموضع القرآني المتكرر حيث يمثل له بمثال, أو أكثر ثم يقول "وغير" طلباً لاختصار.
7- استعمل المؤلف مصطلح (الشيخان), ويعني بهما الشيخين الجليلين: أبا عمرو الداني، وأبا داود بن نجاح, وأحياناً يصفهما بالإمامين, كما استعمل مصطلح (الأخَوان) لحمزة والكسائي كذلك.
8- إذا لم يُقيد المؤلفُ اللفظَ المكررَ بقيد مَّا فإنه يقصد بذلك إطلاقه في سائر القرآن فهو يقول في ذلك -رحمه الله-:
واللفظُ إن لم تلْفه مُقيَّدَا @ فهو كما ذكرتُ حيث وُجدَا
ومن أمثلة القيود التي ساقها المؤلف أسماء السور والأحزاب والأثمان وغيرها كالمجاورة والحرف والأوائل والأواخر.
9- التزم المؤلف قراءة الإمام نافع -رحمهما الله- فيما يذكره من الرسم, معللا ذلك بأنها هي التي عهدت في قطره وضبطت بها المصاحف وانتشرت, يقول رحمه الله:
وفقَ قراءةِ الإمامِ نافع @ إذْ عُهِدتْ في سائر المواضِع
10- ذكره للقراءات التي يتفق معها وجه الرسم تعليلا لوروده بالحذف أو الزيادة أو نحوهما, فهو كثيراً ما يقول: إشارة إلى قراءة كذا، مقتصراً على القراءات السبع.
11- اقتصاره على المشهور فقط مما وقع فيه الخلاف في المسطور والمرسوم عن المشايخ المعتمدين, إلا إن ترجح لديه كلا القولين وتساويا في القوة عنده فعندئذ يطلق القولين ويصرح بهما، قال رحمه الله:
مختصراً على الذي منها اشتهر @ من غير ذكر الْخُلف إلا ما ندر
ودون عزو خِيفة التطويــلِ @ بذكر أهله سوى القليــلِ
12- ذكره ما جرى به العمل غالباً عند المغاربة في المسائل التي يذكر فيها خلافاً.
13- إكثاره النقل عن كتاب ابن القاضي: بيان الخلاف والتشهير, خاصة في مسائل الترجيح أو الاستدراك على مورد الظمآن.
14- استشهاد المؤلف بكثير من المنظومات الرجزية له أو لغيره, وبخاصة من نظميه: مبين المشهور, واللؤلؤ المنظوم, وكثيراً ما يُعقِب نقله عن ابن القاضي في بيان الخلاف والتشهير بشاهد من نظمه مبين المشهور؛ تأييداً له في الغالب.
15- إعراب المؤلف ما في بعض الأبيات من ألفاظ تحتاج إلى توضيح وبيان لدلالتها في المعنى.
16- مراعاة المؤلف التبسيط والتقريب في المسائل التي قد يستغني فيها بالتقييد باللغة, فيبينها بطريقة سهلة بوضع علامات لفظية واضحة وجلية, لا يحتاج صاحبها إلى معرفة نحو ولا صرف، كالمبتدئين والصبيان فهو يقول -رحمه الله-:
آثرتُ في ذاكَ من العبارة@ما يفهمُ الصبيانُ من إشارة
17- سوق الفوائد اللغوية المتعلقة بعلم الرسم, وكذلك حصر بعض المسائل.
18- اعتناؤه بعلم العروض واستطراده أحياناً في ذلك.
19- تأثره بصاحب مورد الظمآن, وشروحه كفتح المنان لابن عاشر في طريقة عرضه في النظم وفي الشرح.
ث- القيمة العلمية للكتاب:
تظهر قيمة كتاب الجامع المقدّم في شرح الجوهر المنظّم بمعرفة موضوعه, وما يقدمه مؤلفه فيه من جهد يجمع بين دفتيه من علمي الرسم, والضبط, واستعان بعلوم أخرى على توضيحهما, وهي: القراءات, والتوجيه, واللغة من نحو وصرف وعروض, ويعتبر هذا الكتاب خلاصة زبدة مؤلفات الشيخ أحمد الحاجي -رحمه الله- في هذا الجانب.
وهذه القيمة العلمية للجامع المقدم في شرح الجوهر المنظم تجعله يضيف جديداً مفيداً, مؤثراً فيمن بعده, يُثري المكتبة العربية الإسلامية عامة, ومكتبة علوم القرآن الكريم خاصة بما امتاز به بين الكتب المشهورة في القطر الموريتاني من ميزات عديدة لعل من أهمها:
1- جمعه ما تفرق في كثير من كتب الرسم, وبخاصة ما لم يذكره صاحب مورد الظمآن, وما استدركه عليه من جاء بعده من شرَّاحه، أو من ألف خصيصاً فيما أغفله الخراز كابن القاضي وغيره.
2- تضمينه من مهمات مسائل الضبط ما تمس الحاجة إليه في كتابه.
3- ذكر ما عليه العمل عند المغاربة من مسائل الخلاف التي يذكرها.
4- الترجيح في بعض الكلمات المختلف فيها سواء في الرسم أو الضبط.
5- ذكر بعض إحصائيات عديدة للكلمات القرآنية مما يساعد في حصر الأمثلة, وتسهيل حفظها.
6- بيانه للعلاقة الضرورية بين القراءات والرسم وارتباطهما ببعض، وقد امتاز المؤلف في هذا الجانب إذ لم يترك من هذا النوع شيئاً إلا وحصره.
7- ذكره للقواعد الكلية في الموضوع ثم بيان ما يخرج عنها من جزئيات ومواضعها, كأسباب الحذف ونحوها.
8- نقله عن كتب في الرسم تعتبر مفقودة ككتاب عثمان الدخيسي المغربي في الرسم.
ج- النتائج والتوصيات:
1- بيان المؤلف للعلاقة الضرورية بين علم رسم القرآن وعلم القراءات, واستصحاب المؤلف لهذه العلاقة, بياناً لها وتعليلا بها, فعلما الرسم والقراءات صنوان متلازمان.
2- شمول الكتاب المحقق لكثير من الأمور المهمة التي يحتاج إليها من علم الضبط إلى جانب علم الرسم, وتضمينه فوائد وتنبيهات وإحصاءات تتعلق بالكلمات القرآنية أو اللغوية ونحوها.
3- إن باب (الحذف) من علم الرسم هو أكبر أبوابه, فقد استغرق أكثر من نصف الكتاب الذي اشتركت في تحقيقه أنا وزميلي محمد محمود ولد الداه.
4- حسن انتفاع المؤلف بكل أجزاء وقته من ساعات عمره وأيامه, وما حباه الله فيه من بركة, فمؤلفاته ضعف سِنِيِّ عمره القصير نسبياً, مما يؤكد أن العمر ببركته لا بطوله.
5- متابعة المؤلف خطوات العلماء السابقين عليه في الأخذ عن بعضهم, ونقل اللاحق منهم عن السابق, بأمانة وموضوعية, فقد نقل المؤلف عن أسماء لم تكن معروفة لعلماء سابقين كالدخيسي مما يوحي بسعة اطلاعه, ويدعو إلى متابعة البحث.
6- دعوة الباحثين والدارسين إلى استكمال موضوع كتاب الجامع المقدم دراسة وتحقيقاً لنظم الضبط, فقد قرنه المؤلف بنظم الرسم وشرحهما جميعاً في الجامع المقدم.
وقد أخذ أحد الطلاب بهذه التوصية مشكوراً، الجزء المتبقية من الكتاب في رسالته التكميلية في نفس القسم بكلية القرآن الكريم.
7- ضرورة متابعة الدراسة والتحقيق لما ذكرته من كتب للمؤلف ليعظم الانتفاع بها, وتخرج في رسائل جامعية أو بحوث علمية.
هذا وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.