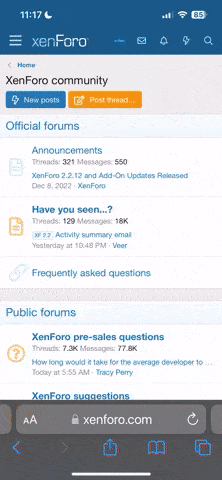الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
سنتكلم في هذه الورقات، إن شاء الله تعالى، عن ذكر الربا في القرآن الكريم.
[h=1]آيات ذكر الربا في القرآن[/h] اعلم أن الربا بنوعيه الحلال والحرام ذكر ثمان مرات، سبع في ذكر ما حرم منه وواحدة في ذكر ما أبيح. ومجموع الآيات التي أتت على ذكر الربا ست آيات، تفردت الآية الأولى ترتيبا بذكر الربا ثلاث مرات في حين ذكر في بقية الخمس آيات مرة واحدة لكل آية.
فالأولى، قوله تعالى: الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلى اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ[1].
والثانية، قوله تعالى: يمحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُربي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [2].
والثالثة، قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ [3].
والرابعة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون [4].
والخامسة، قوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما [5].
والسادسة، قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون [6].
فهذه جملة الآيات التي أتت على ذكر الربا في القرآن.
[h=1]معاني الربا[/h]والرِّبَا، اسم من فعل رَبَا، ومعناه الفضل والزيادة.
تقول العرب: رَبَا يَربُو، ارْبٌ ورِبًا ورَبْوًا ورُبُوًّا وإرباء، فهو رابٍ، والمفعول مَرْبُوّ، للمتعدِّي، بمعنى الزيادة والتكاثر. وربَا العجينُ : علا وانتفخ بعد اختماره : عاليًا على الماء. وربَا الشَّخصُ : أصابه الرَّبْو. وربَا الجرحُ : ورِم. وربَا الرَّابيةَ : صَعَد فوقها. وربَا الولدُ في بني فلان : نشأ وترعرع فيهم ربا الولدُ في بيئة ريفية. وربا الشيءُ ربا رَبْوًا، ورُبُوًّا : نما وزاد وفي التنزيل : وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً فَإذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتَزَّتْ ورَبَتْ [7]، زادت وانتفخت لما يتداخلها من الماء والنَّبات. وربا المالُ : زاد. وربا الفَرسُ : انتفخ من عَدْوٍ أو فَزَعٍ.
والرِّبَا، في الشرع، فضل خالٍ عن عوض شُرِط لأحد المتعاقدين. وفي علم الاقتصاد : المبلغ يؤدِّيه المقترضُ زيادة على ما اقترض تبعًا لشروط خاصة.
قال الطبري في تفسيره: والإرباء: الزيادة على الشيء، يقال منه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه يربي إرباء، والزيادة هي الربا، وربا الشيء: إذا زاد على ما كان عليه فعظم، فهو يربو رَبْوا. وإنما قيل للرابية لزيادتها في العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حولها من قولهم ربا يربو، ومن ذلك قيل: فلان في ربا قومه يراد أنه في رفعة وشرف منهم، فأصل الربا الإنافة والزيادة، ثم يقال: أَرْبَى فلان: أي أناف وصيره زائداً. وإنما قيل للمربي مريب لتضعيفه المال الذي كان له على غريمه حالاً، أو لزيادته عليه فيه، لسبب الأجل الذي يؤخره إليه، فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حلّ دينه عليه [8].
[h=1]رسم كلمة الربا في القرآن[/h]ويسير على من تدبر رسم كلمات القرآن أن يدرك أن ما من زيادة في حرف أو نقصانه في رسم كلم القرآن إلا وفيه زيادة في معنى. والمتفحص في آيات الربا يعلم أن كلمة الربا رسمت بطريقتين، فعلم منه أنها تحمل معنيين تندرج ضمنها بقية المعاني.
فأما إن كانت معرفة فإنها ترسم بزيادة الواو هكذا : الربوا، وإذا جاءت نكرة رسمت بلا زيادة، هكذا: ربا. فالأول هو المعين الحرام، والثاني ورد على إطلاقه لعدم بلوغه درجة التحريم.
قال صاحب الكشاف: الربا كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع.
وقال قوم: وهي في المصاحف مكتوبة بالواو، وأنت مخير في كتابتها بالألف والواو والياء، وقال قوم: وكتبها أهل الحجاز بالواو لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة، ولغة أهل الحيرة الر
بو بالواو، وذلك على لغة من وقف على أفعى بالواو وأجرى الوصل مجرى الوقف. قلت: وهذا كلام باطل لا دليل عليه.
ونلاحظ أيضا، زيادة حرف الألف في فعل : يربوا، إيحاء بمعنى الربا فيها، والله تعالى أعلم.
[h=1]اختلاف القراءات في آيات الربا[/h]واختلف القراء في قراءة الآية
قرأ حمزة والكسائي ٱلرّبَا بالإمالة لمكان كسرة الراء والباقون بالتفخيم بفتح الباء، وهو الذي اشتهر. وقرأ العدوي: الربو بالواو وهي لغة الحيرة. وقرأ أبو السمال كذلك بفتح الباء وضم الراء، وقرأ من بين جميع القُراء: مِن الرِّبُوْ، بكسر الراء المشدّدة وضم الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جِني: شذّ هذا الحرف من أمرين، أحدهما الخروج من الكسر إلى الضم، والآخر وقوع الواو بعد الضم في آخر الاسم. وقال المهدوِيّ: وجهها أنه فَخّم الألف فانْتَحَى بها نحو الواو التي الألف منها؛ ولا ينبغي أن يحمل على غير هذا الوجه، إذْ ليس في الكلام اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمة. وذكر الزعفراني قراءتها بفتح الباء والراء معا وهي قراءات ضعيفة.
أما قوله تعالى: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رَّبّهِ، فاعلم أنه ذكر فعل الموعظة لأن تأنيثها غير حقيقي ولأنها في معنى الوعظ، وقرأ أبي والحسن: فَمَنْ جَاءتْهُ مَّوْعِظَةٌ.
وقرأ الجمهور: آتَيْتُمْ، بالمد بمعنى أعطيتم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحُميد بغير مدّ، بمعنى ما فعلتم من رِباً لِيَرْبُوَ، كما تقول: أتيت صواباً وأتيت خطأ. وأجمعوا على المدّ في قوله تعالى: وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِّباً.
وقرأ جمهور القرّاء السبعة: ليربوا، بالياء وإسناد الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضم التاء (والواو) ساكنة على المخاطبة، بمعنى تكونوا ذوي زيادات، وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشعبي. قال أبو حاتم: هي قراءتنا. وقرأ أبو مالك: لتربوها، بضمير مؤنث.
وقرأ ابن الزبير: يُمَحِّق، بضم الياء وكسر الحاء مشدّدة وقرأ: يُرَبِّي، بفتح الراء وتشديد الباء، ورُويت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كذلك. والأصل على التخفيف.
وقرأ الجمهور: مَا بَقِيَ، بتحريك الياء، وسكنها الحسن، وذكروا أن الحسن قرأها: ما بَقَى، بالألف.
[h=1]أقسام الربا وأنواعه في القرآن[/h]والربا في تفصيل الكتاب ربوان، حلال وحرام،
[h=2]الربا الحلال[/h]فأما الربا الحلال، فقد ذكر له الماوردي ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه الرجل يهدي هدية ليكافأ عليها أفضل منها، قاله ابن عباس ومجاهد.
والثاني: أنه في رجل صحبه في الطريق فخدمه فجعل له المخدوم بعض الربح من ماله جزاء لخدمته لا لوجه الله، قاله الشعبي.
والثالث: أنه في رجل يهب لذي قرابة له مالاً ليصير به غنيّاً ذا مال ولا يفعله طلباً لثواب الله، قاله إبراهيم.
[h=2]الربا الحرام[/h]وأما الربا الحرام فنوعان: ربا نسيئة وربا فضل. ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة، ومنه جعل ما في الذمة رأس مال سلم. وربا فضل:وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا، وكلاهما محرم بالكتاب والسنة، والإجماع على ربا النسيئة، وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة، بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها [9].
[h=1]تأملات في آيات الربا[/h]يقول الله تعالى: الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلى اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ[10].
يقول الرازي: إعلم أن بين الربا وبين الصدقة مناسبة من جهة التضاد، وذلك لأن الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك، والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله عنه، فكانا متضادين، ولهذا قال الله تعالى: يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلْرّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ. فلما حصل بين هذين الحكمين هذا النوع من المناسبة، لا جرم ذكر عقيب حكم الصدقات حكم الربا [11].
وفي هذه الآية مسائل:
المسألة الأولى:
[h=2]حول قوله تعالى: الذين يأكلون الربا.[/h]
قال قوم: أفرأيت من عمل ما نهى الله عنه من الربـا فـي تـجارته ولـم يأكله، أيستـحقّ هذا الوعيد من الله؟
قلت: إن هذا السؤال بعيد مقصده. لأن الأكل في تفصيل الكتاب لا يدل فقط على الطعام، إنما الطعام أبسط ما يكون من الأكل دلالة. ودليله قوله تعالى: وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً [12]. فإن معنى الأكل هنا الحيازة والضم بمعنى لا تضموا أموال اليتامى لأموالكم أكلا وانتفاعا بها ولا تعتقدوا أنها كأموالكم فتتسلطوا عليها وتضيفوها إلى ما عندكم. وكذلك قوله تعالى: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْماً [13]. فكما لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز إتلافه، ولكنه نبّه بالأكل على ما سواه [14]. وخص الآكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم من الربا، وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا [15]. ثم إنه قد ثبت بشهادة الطرد والعكس، أن ما يحرم لا يوقف تحريمه على الأكل دون غيره من التصرفات فثبت بهذه الوجوه أن المراد من أكل الربا في هذه الآية التصرف في الربا [16].
فدل ذلك وغيره، على أن الأكل هنا بمعنى التعود على التعامل به والتصرف فيه لا أكله بمعنى استطعامه أو إطعامه. وعليه فإن التشديد هنا هو لكل معانـي الربـا، وأنْ سواء العمل به وأكلُه وأخذه وإعطاؤه، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه وهم فيه سواء[17].
المسألة الثانية:
[h=2]حول قوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.[/h]
ومعنى التخبط الضرب على غير استواء، ويقال للرجل الذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه: إنه يخبط خبط عشواء، وتَخَبَّطَ فِي مَشَاكِلَ لاَ حَصْرَ لَهَا : وَقَعَ فِيهَا وَهُوَ يُحَاوِلُ التَّخَلُّصَ مِنْهَا. وتَخَبَّطَ فِي عَمَلِهِ: أَنْجَزَهُ فِي فَوْضىً وَعَشْوَائِيَّةٍ. وتَخَبَّطَهُ بِرِجْلِهِ: وَطِئَهُ وَطْأً شَدِيدًا، وتَتَخَبَّطُ البَطَّةُ فِي الوَحْلِ أَوِ الْمَاءِ: تُبَطْبِطُ. وتَخَبَّطَتِ البِلاَدُ: وَقَعَتْ فِيهَا الفِتَنُ. وتخبَّطَ الشَّخصُ: تحرّك واهتز، وتقلقل: تخبَّط من الألم. وتخبَّط في الجهل: بقي في حالة تخلُّف، وتخبَّط في شقاء نفسيّ: تاه ووقع في حيرة من أمره، وتخبّط في سيره: تصرّف بصورة عشوائيّة، وخبط البعير للأرض: ضربه الأرض بأخفافه، وتخبطه الشيطان إذا أفسده، ومسّه بخبل أو جنون، لأنه كالضرب على غير الاستواء في الادهاش، وتسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل خبطة، ويقال: به خبطة من جنون، والمس: الجنون، يقال: مس الرجل فهو ممسوس وبه مس، وأصله من المس باليد، كأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه، ثم سمي الجنون مساً، كما أن الشيطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله، فسمي الجنون خبطة.
وتخبط على وزن تفعل بمعنى فعل كثيرا، نحو تقسمه بمعنى قسمه، وتقطعه بمعنى قطعه.
فإن سأل سائل: بم تعلق قوله تعالى: مِنَ ٱلْمَسّ.
قلنا: فيه وجهان أحدهما: بقوله تعالى: لاَ يَقُومُونَ، والتقدير: لا يقومون من المس الذي لهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. والثاني: أنه متعلق بقوله تعالى: يقوم، والتقدير لا يقومون إلا كما يقوم المتخبط بسبب المس.
فإن سأل سائل: كيف يصح أن يقال أن يتخبط المصروع من مس الشيطان والحال أن الشيطان أضعف من أن يقدر على صرع الناس، كما هو قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مّن سُلْطَـٰنٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى[18]. وقوله تعالى: إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفاً[19]. فإن كان لا سلطان له عليه، وإن كان كيده ضعيفا، فكيف له أن يؤذيه ؟
وجوابه: أن الآية هنا لا تعني المس الذي فيه الإيذاء المباشر، إنما يعنى بها أنه لا سلطان له على الناس في أفعالهم التي يحاسبون عليها. ومثله في القرآن، قوله تعالى: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ [20]. وقوله تعالى: قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِى لاقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـٰنِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَـٰكِرِينَ[21]. وقوله تعالى: تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَمٍ مّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـِّنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[22]. وقوله تعالى: كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَـٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنّى بَرِىء مّنكَ إِنّى أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ فَكَانَ عَـٰقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء ٱلظَّـٰلِمِينَ[23]. وقوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً [24]. أما المس الذي فيه الإذية المباشرة، حتى لا يتحكم المرء في وجهته أين يسير وفي كلامه ونبرة صوته ونظرة عينه، فهذا لا محالة يقع سمعنا عنه ورأيته بأم عيني. ودليله في القرآن قوله تعالى: وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ [25]. وقوله تعالى: وَقُلْ رَّبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيـٰطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبّ أَن يَحْضُرُونِ[26]. وقوله تعالى: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ[27].
فإن سأل سائل: وهل ذلك التخبط في الحياة الدنيا أو يوم القيامة ؟
قلنا: ذهب قوم إلى القول بأن ذلك يوم القيامة فيبعثون كذلك كعلامة يعرفون بها أنهم أكلة ربا في الدنيا. وذهب قوم إلى القول إنما ذلك في الدنيا وذلك لأن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغير الله، فهذا هو المراد من مس الشيطان، ومن كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطاً، فتارة الشيطان يجره إلى النفس والهوى، وتارة الملك يجره إلى الدين والتقوى، فحدثت هناك حركات مضطربة، وأفعال مختلفة، فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان. وآكل الربا لا شك أنه يكون مفرطاً في حب الدنيا متهالكاً فيها، فإذا مات على ذلك الحب صار ذلك الحب حجاباً بينه وبين الله تعالى، فالخبط الذي كان حاصلاً في الدنيا بسبب حب المال أورثه الخبط في الآخرة، وأوقعه في ذل الحجاب[28]، ومقابل تخبط أكلة الربا نجد إبصار أهل التقوى والقرب من الله، وهو قوله تعالى: إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَـئِفٌ مّنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ [29].
المسألة الثالثة:
[h=2]حول قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.[/h]
فبعد أن بين فعلهم واضطرابهم أزاح الوشاح عن قولهم وهو: إنما البيع مثل الربا. فإن القوم كانوا في تحليل الربا على هذه الشبهة، وهي أن من اشترى ثوباً بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال، فكذا إذا باع العشرة بأحد عشرة يجب أن يكون حلال، لأنه لا فرق في العقل بين الأمرين، فهذا في ربا النقد، وأما في ربا النسيئة فكذلك أيضاً، لأنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة في الحال بأحد عشر إلى شهر جاز فكذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إلى شهر، وجب أن يجوز لأنه لا فرق في العقل بين الصورتين، وذلك لأنه إنما جاز هناك، لأنه حصل التراضي من الجانبين، فكذا ههنا لما حصل التراضي من الجانبين وجب أن يجوز أيضاً، فالبياعات إنما شرعت لدفع الحاجات، ولعلل الإنسان أن يكون صفر اليد في الحال شديد الحاجة، ويكون له في المستقبل من الزمان أموال كثيرة، فإذا لم يجز الربا لم يعطه رب المال شيئاً فيبقى الإنسان في الشدة والحاجة، إما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب المال طمعاً في الزيادة، والمديون يرده عند وجدان المال، وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال أسهل عليه من البقاء في الحاجة قبل وجدان المال، فهذا يقتضي حل الربا كما حكمنا بحل سائر البياعات لأجل دفع الحاجة، فهذا هو شبهة القوم.
فإن سأل سائل: لم لم يقل: إنما الربا مثل البيع، وذلك لأن حل البيع متفق عليه، فهم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا، ومن حق القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاق، فكان نظم الآية أن يقال: إنما الربا مثل البيع، فما الحكمة في أن قلب هذه القضية، فقال: إنما البيع مثل الربا.
والجواب: أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس، بل كان غرضهم أن الربا والبيع متماثلان من جميع الوجوه المطلوبة فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين بالحل والثاني بالحرمة وعلى هذا التقدير فأيهما قدم أو أخر جاز [30].
قلنا: اعلم أنه لما ذكر أكل الربا ذكر معه اضطراب أفهام المرابين وتخبطهم تخبط من تخبطه الشيطان من المس، ولابد أن يظهر هذا التخبط والاضطراب في رؤيتهم للأمور وقياساتهم. فأول القياس أنهم قاسوا المعلوم على المجهول لإثبات المجهول وهو قياس مضطرب عقلا إذ الاستواء أن يقاس المجهول على المعلوم. فقاسوا البيع على الربا، وهذا قياس فاسد جوهره، وبين اضطرابهم وتخبطهم فيه. فإنهم لما أكلوا الربا وطعموه وتعاملوا به فسدت قلوبهم وذهب سلطان العقل عندهم، ومن كان هذا أمره ضل وصبا، حتى لكأنهم لا يعرفون بيعا بدون ربا، فجعلوا الربا أصلا معلوما يقاس عليه. وهذا الأمر خاص بالذين يأكلون الربا ولا ينتهون. أما من لم يتعامل به فتجده لا يبرر ذلك لأحد حتى إذا غلبه الشيطان ووقع فيه برر لنفسه ذلك وأظهر قياسه الباطل للناس ظنا أنه على حق.
المسألة الرابعة:
[h=2]حول قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا.[/h]
يحتمل أن يكون هذا الكلام من تمام كلام الكفار، والمعنى أنهم قالوا: البيع مثل الربا، ثم إنكم تقولون: وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوٰاْ، فكيف يعقل هذا ؟ يعني أنهما لما كانا متماثلين فلو حل أحدهما وحرم الآخر لكان ذلك إيقاعاً للتفرقة بين المثلين، وذلك غير لائق بحكمة الحكيم فقوله: أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوٰاْ، ذكره الكفار على سبيل الاستبعاد.
واتفق أكثر المفسرين على أن كلام الكفار انقطع عند قوله تعالى: إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرّبَوٰاْ، وأما قوله سبحانه: أَحَلَّ ٱللَّه ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوٰاْ، فهو كلام الله تعالى، ونصه على هذا الفرق ذكره إبطالاً للقول على لسان الكفار: إنما البيع مثل الربا. والله أعلم.
المسألة الخامسة:
[h=2]حول قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.[/h]قال قوم، معنى ذلك: أن من جاءه موعظة من ربه فامتنع فله ما مضى من ذنبه أي صفح له وغفر ما مضى من ذنبه، كما هو قوله تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ [31]. قال الواحدي: السلف المتقدم، وكل شيء قدمته أمامك فهو سلف، ومنه الأمة السالفة، والسالفة العنق لتقدمه في جهة العلو، والسلفة ما يقدم قبل الطعام، وسلافة الخمر صفوتها، لأنه أول ما يخرج من عصيرها.
وقوله سبحانه فانتهى: ليس فيها بيان عما انتهى، فبقيت على إطلاقها. قال قوم: لابد وأن يصرف ذلك المذكور إلى السابق، وأقرب المذكورات في هذه الكلمة ما حكى الله أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، فكان قوله تعالى: فَٱنتَهَىٰ، عائداً إليه، فكان المعنى: فانتهى عن هذا القول.
قال الرازي: وأما مؤخرة الآية فقوله تعالى: وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ، ومعناه: عاد إلى الكلام المتقدم، وهو استحلال الربا،فأمره إِلَى ٱللَّهِ، ثم هذا الإنسان إما أن يقال: إنه كما انتهى عن استحلال الربا انتهى أيضاً عن أكل الربا، أو ليس كذلك، فإن كان الأول كان هذا الشخص مقراً بدين الله عالماً بتكليف الله، فحينئذ يستحق المدح والتعظيم والإكرام، لكن قوله تعالى: فأمره إِلَى ٱللَّهِ، ليس كذلك لأنه يفيد أنه تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فثبت أن هذه الآية لا تليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع، فلم يبق إلا أن يكون مختصاً بمن أقر بحرمة الربا ثم أكل الربا فههنا أمره لله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو كقوله تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، فيكون ذلك دليلاً ظاهراً على صحة قولنا أن العفو من الله مرجو[32].
قلت: وليس ثمة دليل على وجوب صرفها للمذكور في الآية، بل لعموم المواعظ على لسان الوحي أو على لسان حامل الوحي الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما أبهم الانتهاء أبهم الموعظة فجعلها على إطلاقها، وإنما جاءت موعظة من المواعظ في هذه الآية وواجب المسلم الانتهاء عنها كبقية المواعظ التي أتته من ربه. إذ ليست الموعظة خاصة بالربا أكلا وفعلا وقولا، بل بكل فعل وكل قول في عمومه.
الآية الثانية:
يقول الله تعالى: يمحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُربي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [33].
في هذه الآية مسائل:
المسألة الأولى:
[h=2]حول قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.[/h]تقول العرب: محق الشيء بمعنى نقصه، وأهلكه وأباده، وأحرقه، واستأصله، وأبطله ومحاه، وأذهب بركته. قال ابن عباس في قوله تعالى: يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلْرِّبَا، أي لا يقبل منه صدقةً ولا حجّاً ولا جهاداً ولا صلةً. والمَحْقُ: النقص والذهاب، ومنه مُحَاق القمر وهو انتقاصه. وقوله تعالى: وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ، أي يُنَمِّيها في الدنيا بالبركة ويُكثر ثوابَها بالتضعيف في الآخرة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة أحدِكم لتقع في يد الله فَيَربِّيها له كما يُرَبِّي أحدُكم فَلُوَّه أو فصيلَه حتى يجيء يوم القيامة وإن اللّقمة لعلى قدر أحُد[34].
المسألة الثانية
[h=2]حول قوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم.[/h]اعلم أن تعلق الإثم يكون بالقلب، إذ هو المتحكم في عمل الجوارح، وهو قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه[35]. وقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذًا لمن الآثمين[36]. ثم إن الله تعالى قي الآية وصف من تولى عن موعظة ربه بأنه كفار أثيم على صيغة المبالغة فعلم أن الأمر أبلغ من فعل وقول، وأبعد كونه طمس للحقيقة أوكتمانها أو تحريفها أو تزويرها، والله أعلم.
الآية الثالثة:
يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ [37].
قال القرطبي: ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً قبل نزول آية التحريم، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضاً. وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب ثقِيف، وكانوا عاهدوا النبيّ صلى الله عليه وسلم على أن مالهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم، فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء، وكانت الديون لبني عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف، وكانت على بني المغيرة المخزوميّين. فقال بنو المغيرة: لا نعطي شيئاً فإن الربا قد رُفِع. ورفعوا أمرهم إلى عَتَّاب بن أَسِيد، فكتب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتَّاب، فعلمت بها ثقيف فكفَّتْ. هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما رَوى ابن إسحاق وابن جريج والسُّدِّي وغيرهم. والمعنى اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايةً بترككم ما بقي لكم من الربا وصفحكم عنه.
أما قوله تعالى: إن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ، فشرطٌ محض في ثَقِيف على بابه، لأنه كان في أوّل دخولهم في الإسلام. وإذا قدرنا الآية فيمن قد تقرّر إيمانه فهو شرط مجازيّ على جهة المبالغة، كما تقول لمن تريد إقامة نفسه: إن كنت رجلاً فافعل كذا. وحكى النَّقاش عن مُقَاتل بن سليمان أنه قال: إنّ، إنْ، في هذه الآية بمعنى إذ. قال ابن عطيّة: وهذا مردود لا يعرف في اللغة. وقال ابن فَوْرَك: يحتمل أن يريد: يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ، بمن قبل محمد عليه السلام من الأنبياء: ذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ، بمحمد صلى الله عليه وسلم إذْ لا ينفع الأوّل إلا بهذا. وهذا مردود بما روي في سبب الآية [38].
وفي قوله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، قال القرطبي: هذا وعيد إن لم يَذَروا الربا، والحرب داعية القتل. وروى ابن عباس أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا: خُذْ سلاحك للحرب. وقال ابن عبّاس أيضاً: مَنْ كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه فحقّ على إمام المسلمين أن يستثيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم بَهْرَجاً أينما ثُقِفُوا. وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسوله، أي أعداء. وقال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا مرتَدِّين، والحكم فيه كالحكم في أهل الردّة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتُهم، ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وقرأ أبو بكر عن عاصم: فآذِنُوا، على معنى فأعلموا غيرَكم أنكم على حربهم.
وقد دلّت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر، ولا خلاف في ذلك على ما نبيّنه. ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى أحد إلا أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه غُبَاره، وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لَدرهُم رباً أشدُّ عند الله تعالى من ست وثلاثين زَنْيَة في الخطيئة، وروي عنه عليه السلام أنه قال: الربا تسعةٌ وتسعون بابا أدناها كإتيان الرجل بأُمِّه، يعني الزنا بأُمه. وقال ابن مسعود: آكل الربا وموكِّله وكاتبه وشاهده ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاريّ عن أبي جُحَيْفَة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:اجتنبوا السبع الموبِقات... ـ وفيها ـ وآكل الربا، وفي مصنف أبي داود عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده[39].
الآية الرابعة:
يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون [40].
في هذه الآية مسائل:
[h=2]حول قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة.[/h]قال مجاهد كانوا يبيعون البيع إلى أجل، فإذا حلّ الأجل زادوا في الّثَمن على أن يؤخرّوا، فأنزل الله عز وجل: يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً.
وذكر الرازي أن، أَضْعَافًا، انتصبت على الحال. ثم قال تعالى: وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فعلم أن اتقاء الله في هذا النهي واجب، وأن الفلاح يتوقف عليه، فلو أكل ولم يتق زال الفلاح، وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر.
وقد يسأل سائل، وقد طم فينا الجهل وعم، أرأيت إن لم يبلغ الربا الأضعاف المضاعفة، أيكون في عموم المنهي عنه ؟ وجوابه: قوله تعالى: مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً. فإنه لما أراد مضاعفة الأصل بين ذلك، ولما أراد الزيادة في مطلقها جعلها على إطلاقها. والله تعالى أعلم.
الآية الخامسة:
يقول الله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما [41].
[h=2]حول قوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل.[/h]اعلم أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين: الظلم للخلق، والإعراض عن الدين الحق، ومتأتى ذلك كله الحرص في طلب الدنيا والميل إلى كسب المال بأي طريقة، فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه، وتارة بطريق الرشوة وهو المراد بقوله تعالى: وَأَكْلِهِمْ أَمْوٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ، ونظيره قوله تعالى: سَمَّـٰعُونَ للكَذِبَ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحْتِ [42]. والله تعالى أعلم.
الآية السادسة:
يقول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون [43].
[h=2]حول قوله تعالى: وما آتيتم من ربا.[/h]قال عكرمة في قوله تعالى: وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَاْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ: الرِّبَا رِبَوان، ربا حلال وربا حرام؛ فأما الرّبا الحلال فهو الذي يُهْدَى، يُلتمس ما هو أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية: هو الرّبا الحلال الذي يُهدى ليُثاب ما هو أفضل منه، لا له ولا عليه، ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم. قال ابن عباس: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه، فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه، وفي هذا المعنى نزلت الآية. قال ابن عباس وابن جُبير وطاوس ومجاهد: هذه آية نزلت في هبة الثواب. قال ابن عطية: وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره، فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى. وقاله القاضي أبو بكر بن العربي. وقال ابن عباس أيضاً وإبراهيم النَّخعِي: نزلت في قوم يُعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضّل عليهم، وليزيدوا في أموالهم على وجه النفع لهم. وقال الشّعْبي: معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحداً وخف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يَجزِي به الخدمة لا يربو عند الله. وقيل: كان هذا حراماً على النبيّ صلى الله عليه وسلم على الخصوص، قال الله تعالى: وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، فنهي أن يعطي شيئاً فيأخذ أكثر منه عِوضاً.
وقيل: إنه الربا المحرّم، فمعنى: لاَ يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، على هذا القول لا يحكم به لآخذه بل هو للمأخوذ منه. قال السدي: نزلت هذه الآية في ربا ثَقيف، لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش.
وروى مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيّما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها. ونحوه عن عليّ رضي الله عنه قال: المواهب ثلاث: مَوْهبة يراد بها وجه الله، وموهبة يراد بها وجوه الناس، وموهبة يراد بها الثواب؛ فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يُثب منها. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها. وأثاب على لِقْحة ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب، وإنما أنكر سخطه للثواب وكان زائداً على القيمة [44].
. فأما إذا أراد بهبته وجه الله تعالى وابتغى عليه الثواب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته، قال الله عز وجل: وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ.
وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيًّا حتى لا يكون كَلاًّ فالنية في ذلك متبوعة، فإن كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه الله، وإن كان لما له عليه من حق القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله.
وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا منفعة له في هبته؛ لا ثواب في الدنيا ولا أجر في الآخرة، قال الله عز وجل: يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ[45].
وأما من أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبته، وله أن يرجع فيها ما لم يثب بقيمتها، على مذهب ابن القاسم، أو ما لم يرض منها بأزيد من قيمتها، على ظاهر قول عمر وعليّ، وهو قول مُطَرِّف في الواضحة: أن الهبة ما كانت قائمة العين، وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه الموهوب فيها أكثر منها. وقد قيل: إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغير فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمة كنكاح التفويض، وأما إذ كان بعد فوت الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً، قاله ابن العربي.
هذا والله تعالى أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما
[1] سورة البقرة، الآية 275.
[2] سورة البقرة، الآية 276.
[3] سورة البقرة، الآية 278.
[4] سورة آل عمران، الآية 130.
[5] سورة النساء، الآية 161.
[6] سورة الروم، الآية 39.
[7] سورة الحج، الآية 5.
[8] تفسير الطبري.
[9] تفسير السعدي.
[10] سورة البقرة، الآية 275.
[11] التفسير الكبير، الرازي.
[12] سورة النساء، الآية 2.
[13] سورة النساء، الآية 10.
[14] التفسير الكبير، الرازي.
[15] جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري.
[16] التفسير الكبير، الرازي.
[17] أخرجه مسلم وأحمد.
[18] سورة ابراهيم، الآية 22.
[19] سورة النساء، الآية 76.
[20] سورة النحل، الآيات 99-100.
[21] سورة الأعراف، الآيات 16-17.
[22] سورة النحل، الآية 63.
[23] سورة الحشر، الآيات 16-17.
[24] سورة مريم، الآية 83.
[25] سورة ص، الآية 11.
[26] سورة المؤمنون، الآيات 97-98.
[27] سورة فصلت، الآية 36.
[28] التفسير الكبير، الفخر الرازي.
[29] سورة الأعراف، الآية 201.
[30] التفسير الكبير، الفخر الرازي.
[31] سورة الأنفال، الآية 38.
[32] التفسير الكبير، الفخر الرازي.
[33] سورة البقرة، الآية 276.
[34] أخرجه مسلم.
[35] سورة البقرة، الآية 276.
[36] سورة البقرة، الآية 276.
[37] سورة البقرة، الآية 276.
[38] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي.
[39] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي.
[40] سورة آل عمران، الآية 130.
[41] سورة النساء، الآية 161.
[42] سورة المائدة، الآية 42.
[43] سورة الروم، الآية 39.
[44] أخرجه الترمذي.
[45] سورة البقرة، الآية 264.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
سنتكلم في هذه الورقات، إن شاء الله تعالى، عن ذكر الربا في القرآن الكريم.
[h=1]آيات ذكر الربا في القرآن[/h] اعلم أن الربا بنوعيه الحلال والحرام ذكر ثمان مرات، سبع في ذكر ما حرم منه وواحدة في ذكر ما أبيح. ومجموع الآيات التي أتت على ذكر الربا ست آيات، تفردت الآية الأولى ترتيبا بذكر الربا ثلاث مرات في حين ذكر في بقية الخمس آيات مرة واحدة لكل آية.
فالأولى، قوله تعالى: الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلى اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ[1].
والثانية، قوله تعالى: يمحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُربي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [2].
والثالثة، قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ [3].
والرابعة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون [4].
والخامسة، قوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما [5].
والسادسة، قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون [6].
فهذه جملة الآيات التي أتت على ذكر الربا في القرآن.
[h=1]معاني الربا[/h]والرِّبَا، اسم من فعل رَبَا، ومعناه الفضل والزيادة.
تقول العرب: رَبَا يَربُو، ارْبٌ ورِبًا ورَبْوًا ورُبُوًّا وإرباء، فهو رابٍ، والمفعول مَرْبُوّ، للمتعدِّي، بمعنى الزيادة والتكاثر. وربَا العجينُ : علا وانتفخ بعد اختماره : عاليًا على الماء. وربَا الشَّخصُ : أصابه الرَّبْو. وربَا الجرحُ : ورِم. وربَا الرَّابيةَ : صَعَد فوقها. وربَا الولدُ في بني فلان : نشأ وترعرع فيهم ربا الولدُ في بيئة ريفية. وربا الشيءُ ربا رَبْوًا، ورُبُوًّا : نما وزاد وفي التنزيل : وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً فَإذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتَزَّتْ ورَبَتْ [7]، زادت وانتفخت لما يتداخلها من الماء والنَّبات. وربا المالُ : زاد. وربا الفَرسُ : انتفخ من عَدْوٍ أو فَزَعٍ.
والرِّبَا، في الشرع، فضل خالٍ عن عوض شُرِط لأحد المتعاقدين. وفي علم الاقتصاد : المبلغ يؤدِّيه المقترضُ زيادة على ما اقترض تبعًا لشروط خاصة.
قال الطبري في تفسيره: والإرباء: الزيادة على الشيء، يقال منه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه يربي إرباء، والزيادة هي الربا، وربا الشيء: إذا زاد على ما كان عليه فعظم، فهو يربو رَبْوا. وإنما قيل للرابية لزيادتها في العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حولها من قولهم ربا يربو، ومن ذلك قيل: فلان في ربا قومه يراد أنه في رفعة وشرف منهم، فأصل الربا الإنافة والزيادة، ثم يقال: أَرْبَى فلان: أي أناف وصيره زائداً. وإنما قيل للمربي مريب لتضعيفه المال الذي كان له على غريمه حالاً، أو لزيادته عليه فيه، لسبب الأجل الذي يؤخره إليه، فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حلّ دينه عليه [8].
[h=1]رسم كلمة الربا في القرآن[/h]ويسير على من تدبر رسم كلمات القرآن أن يدرك أن ما من زيادة في حرف أو نقصانه في رسم كلم القرآن إلا وفيه زيادة في معنى. والمتفحص في آيات الربا يعلم أن كلمة الربا رسمت بطريقتين، فعلم منه أنها تحمل معنيين تندرج ضمنها بقية المعاني.
فأما إن كانت معرفة فإنها ترسم بزيادة الواو هكذا : الربوا، وإذا جاءت نكرة رسمت بلا زيادة، هكذا: ربا. فالأول هو المعين الحرام، والثاني ورد على إطلاقه لعدم بلوغه درجة التحريم.
قال صاحب الكشاف: الربا كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع.
وقال قوم: وهي في المصاحف مكتوبة بالواو، وأنت مخير في كتابتها بالألف والواو والياء، وقال قوم: وكتبها أهل الحجاز بالواو لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة، ولغة أهل الحيرة الر
بو بالواو، وذلك على لغة من وقف على أفعى بالواو وأجرى الوصل مجرى الوقف. قلت: وهذا كلام باطل لا دليل عليه.
ونلاحظ أيضا، زيادة حرف الألف في فعل : يربوا، إيحاء بمعنى الربا فيها، والله تعالى أعلم.
[h=1]اختلاف القراءات في آيات الربا[/h]واختلف القراء في قراءة الآية
قرأ حمزة والكسائي ٱلرّبَا بالإمالة لمكان كسرة الراء والباقون بالتفخيم بفتح الباء، وهو الذي اشتهر. وقرأ العدوي: الربو بالواو وهي لغة الحيرة. وقرأ أبو السمال كذلك بفتح الباء وضم الراء، وقرأ من بين جميع القُراء: مِن الرِّبُوْ، بكسر الراء المشدّدة وضم الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جِني: شذّ هذا الحرف من أمرين، أحدهما الخروج من الكسر إلى الضم، والآخر وقوع الواو بعد الضم في آخر الاسم. وقال المهدوِيّ: وجهها أنه فَخّم الألف فانْتَحَى بها نحو الواو التي الألف منها؛ ولا ينبغي أن يحمل على غير هذا الوجه، إذْ ليس في الكلام اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمة. وذكر الزعفراني قراءتها بفتح الباء والراء معا وهي قراءات ضعيفة.
أما قوله تعالى: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رَّبّهِ، فاعلم أنه ذكر فعل الموعظة لأن تأنيثها غير حقيقي ولأنها في معنى الوعظ، وقرأ أبي والحسن: فَمَنْ جَاءتْهُ مَّوْعِظَةٌ.
وقرأ الجمهور: آتَيْتُمْ، بالمد بمعنى أعطيتم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحُميد بغير مدّ، بمعنى ما فعلتم من رِباً لِيَرْبُوَ، كما تقول: أتيت صواباً وأتيت خطأ. وأجمعوا على المدّ في قوله تعالى: وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِّباً.
وقرأ جمهور القرّاء السبعة: ليربوا، بالياء وإسناد الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضم التاء (والواو) ساكنة على المخاطبة، بمعنى تكونوا ذوي زيادات، وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشعبي. قال أبو حاتم: هي قراءتنا. وقرأ أبو مالك: لتربوها، بضمير مؤنث.
وقرأ ابن الزبير: يُمَحِّق، بضم الياء وكسر الحاء مشدّدة وقرأ: يُرَبِّي، بفتح الراء وتشديد الباء، ورُويت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كذلك. والأصل على التخفيف.
وقرأ الجمهور: مَا بَقِيَ، بتحريك الياء، وسكنها الحسن، وذكروا أن الحسن قرأها: ما بَقَى، بالألف.
[h=1]أقسام الربا وأنواعه في القرآن[/h]والربا في تفصيل الكتاب ربوان، حلال وحرام،
[h=2]الربا الحلال[/h]فأما الربا الحلال، فقد ذكر له الماوردي ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه الرجل يهدي هدية ليكافأ عليها أفضل منها، قاله ابن عباس ومجاهد.
والثاني: أنه في رجل صحبه في الطريق فخدمه فجعل له المخدوم بعض الربح من ماله جزاء لخدمته لا لوجه الله، قاله الشعبي.
والثالث: أنه في رجل يهب لذي قرابة له مالاً ليصير به غنيّاً ذا مال ولا يفعله طلباً لثواب الله، قاله إبراهيم.
[h=2]الربا الحرام[/h]وأما الربا الحرام فنوعان: ربا نسيئة وربا فضل. ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة، ومنه جعل ما في الذمة رأس مال سلم. وربا فضل:وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا، وكلاهما محرم بالكتاب والسنة، والإجماع على ربا النسيئة، وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة، بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها [9].
[h=1]تأملات في آيات الربا[/h]يقول الله تعالى: الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلى اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ[10].
يقول الرازي: إعلم أن بين الربا وبين الصدقة مناسبة من جهة التضاد، وذلك لأن الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك، والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله عنه، فكانا متضادين، ولهذا قال الله تعالى: يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلْرّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ. فلما حصل بين هذين الحكمين هذا النوع من المناسبة، لا جرم ذكر عقيب حكم الصدقات حكم الربا [11].
وفي هذه الآية مسائل:
المسألة الأولى:
[h=2]حول قوله تعالى: الذين يأكلون الربا.[/h]
قال قوم: أفرأيت من عمل ما نهى الله عنه من الربـا فـي تـجارته ولـم يأكله، أيستـحقّ هذا الوعيد من الله؟
قلت: إن هذا السؤال بعيد مقصده. لأن الأكل في تفصيل الكتاب لا يدل فقط على الطعام، إنما الطعام أبسط ما يكون من الأكل دلالة. ودليله قوله تعالى: وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً [12]. فإن معنى الأكل هنا الحيازة والضم بمعنى لا تضموا أموال اليتامى لأموالكم أكلا وانتفاعا بها ولا تعتقدوا أنها كأموالكم فتتسلطوا عليها وتضيفوها إلى ما عندكم. وكذلك قوله تعالى: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْماً [13]. فكما لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز إتلافه، ولكنه نبّه بالأكل على ما سواه [14]. وخص الآكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم من الربا، وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا [15]. ثم إنه قد ثبت بشهادة الطرد والعكس، أن ما يحرم لا يوقف تحريمه على الأكل دون غيره من التصرفات فثبت بهذه الوجوه أن المراد من أكل الربا في هذه الآية التصرف في الربا [16].
فدل ذلك وغيره، على أن الأكل هنا بمعنى التعود على التعامل به والتصرف فيه لا أكله بمعنى استطعامه أو إطعامه. وعليه فإن التشديد هنا هو لكل معانـي الربـا، وأنْ سواء العمل به وأكلُه وأخذه وإعطاؤه، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه وهم فيه سواء[17].
المسألة الثانية:
[h=2]حول قوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.[/h]
ومعنى التخبط الضرب على غير استواء، ويقال للرجل الذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه: إنه يخبط خبط عشواء، وتَخَبَّطَ فِي مَشَاكِلَ لاَ حَصْرَ لَهَا : وَقَعَ فِيهَا وَهُوَ يُحَاوِلُ التَّخَلُّصَ مِنْهَا. وتَخَبَّطَ فِي عَمَلِهِ: أَنْجَزَهُ فِي فَوْضىً وَعَشْوَائِيَّةٍ. وتَخَبَّطَهُ بِرِجْلِهِ: وَطِئَهُ وَطْأً شَدِيدًا، وتَتَخَبَّطُ البَطَّةُ فِي الوَحْلِ أَوِ الْمَاءِ: تُبَطْبِطُ. وتَخَبَّطَتِ البِلاَدُ: وَقَعَتْ فِيهَا الفِتَنُ. وتخبَّطَ الشَّخصُ: تحرّك واهتز، وتقلقل: تخبَّط من الألم. وتخبَّط في الجهل: بقي في حالة تخلُّف، وتخبَّط في شقاء نفسيّ: تاه ووقع في حيرة من أمره، وتخبّط في سيره: تصرّف بصورة عشوائيّة، وخبط البعير للأرض: ضربه الأرض بأخفافه، وتخبطه الشيطان إذا أفسده، ومسّه بخبل أو جنون، لأنه كالضرب على غير الاستواء في الادهاش، وتسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل خبطة، ويقال: به خبطة من جنون، والمس: الجنون، يقال: مس الرجل فهو ممسوس وبه مس، وأصله من المس باليد، كأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه، ثم سمي الجنون مساً، كما أن الشيطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله، فسمي الجنون خبطة.
وتخبط على وزن تفعل بمعنى فعل كثيرا، نحو تقسمه بمعنى قسمه، وتقطعه بمعنى قطعه.
فإن سأل سائل: بم تعلق قوله تعالى: مِنَ ٱلْمَسّ.
قلنا: فيه وجهان أحدهما: بقوله تعالى: لاَ يَقُومُونَ، والتقدير: لا يقومون من المس الذي لهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. والثاني: أنه متعلق بقوله تعالى: يقوم، والتقدير لا يقومون إلا كما يقوم المتخبط بسبب المس.
فإن سأل سائل: كيف يصح أن يقال أن يتخبط المصروع من مس الشيطان والحال أن الشيطان أضعف من أن يقدر على صرع الناس، كما هو قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مّن سُلْطَـٰنٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى[18]. وقوله تعالى: إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفاً[19]. فإن كان لا سلطان له عليه، وإن كان كيده ضعيفا، فكيف له أن يؤذيه ؟
وجوابه: أن الآية هنا لا تعني المس الذي فيه الإيذاء المباشر، إنما يعنى بها أنه لا سلطان له على الناس في أفعالهم التي يحاسبون عليها. ومثله في القرآن، قوله تعالى: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ [20]. وقوله تعالى: قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِى لاقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـٰنِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَـٰكِرِينَ[21]. وقوله تعالى: تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَمٍ مّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـِّنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[22]. وقوله تعالى: كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَـٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنّى بَرِىء مّنكَ إِنّى أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ فَكَانَ عَـٰقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء ٱلظَّـٰلِمِينَ[23]. وقوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً [24]. أما المس الذي فيه الإذية المباشرة، حتى لا يتحكم المرء في وجهته أين يسير وفي كلامه ونبرة صوته ونظرة عينه، فهذا لا محالة يقع سمعنا عنه ورأيته بأم عيني. ودليله في القرآن قوله تعالى: وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ [25]. وقوله تعالى: وَقُلْ رَّبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيـٰطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبّ أَن يَحْضُرُونِ[26]. وقوله تعالى: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ[27].
فإن سأل سائل: وهل ذلك التخبط في الحياة الدنيا أو يوم القيامة ؟
قلنا: ذهب قوم إلى القول بأن ذلك يوم القيامة فيبعثون كذلك كعلامة يعرفون بها أنهم أكلة ربا في الدنيا. وذهب قوم إلى القول إنما ذلك في الدنيا وذلك لأن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغير الله، فهذا هو المراد من مس الشيطان، ومن كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطاً، فتارة الشيطان يجره إلى النفس والهوى، وتارة الملك يجره إلى الدين والتقوى، فحدثت هناك حركات مضطربة، وأفعال مختلفة، فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان. وآكل الربا لا شك أنه يكون مفرطاً في حب الدنيا متهالكاً فيها، فإذا مات على ذلك الحب صار ذلك الحب حجاباً بينه وبين الله تعالى، فالخبط الذي كان حاصلاً في الدنيا بسبب حب المال أورثه الخبط في الآخرة، وأوقعه في ذل الحجاب[28]، ومقابل تخبط أكلة الربا نجد إبصار أهل التقوى والقرب من الله، وهو قوله تعالى: إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَـئِفٌ مّنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ [29].
المسألة الثالثة:
[h=2]حول قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.[/h]
فبعد أن بين فعلهم واضطرابهم أزاح الوشاح عن قولهم وهو: إنما البيع مثل الربا. فإن القوم كانوا في تحليل الربا على هذه الشبهة، وهي أن من اشترى ثوباً بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال، فكذا إذا باع العشرة بأحد عشرة يجب أن يكون حلال، لأنه لا فرق في العقل بين الأمرين، فهذا في ربا النقد، وأما في ربا النسيئة فكذلك أيضاً، لأنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة في الحال بأحد عشر إلى شهر جاز فكذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إلى شهر، وجب أن يجوز لأنه لا فرق في العقل بين الصورتين، وذلك لأنه إنما جاز هناك، لأنه حصل التراضي من الجانبين، فكذا ههنا لما حصل التراضي من الجانبين وجب أن يجوز أيضاً، فالبياعات إنما شرعت لدفع الحاجات، ولعلل الإنسان أن يكون صفر اليد في الحال شديد الحاجة، ويكون له في المستقبل من الزمان أموال كثيرة، فإذا لم يجز الربا لم يعطه رب المال شيئاً فيبقى الإنسان في الشدة والحاجة، إما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب المال طمعاً في الزيادة، والمديون يرده عند وجدان المال، وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال أسهل عليه من البقاء في الحاجة قبل وجدان المال، فهذا يقتضي حل الربا كما حكمنا بحل سائر البياعات لأجل دفع الحاجة، فهذا هو شبهة القوم.
فإن سأل سائل: لم لم يقل: إنما الربا مثل البيع، وذلك لأن حل البيع متفق عليه، فهم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا، ومن حق القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاق، فكان نظم الآية أن يقال: إنما الربا مثل البيع، فما الحكمة في أن قلب هذه القضية، فقال: إنما البيع مثل الربا.
والجواب: أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس، بل كان غرضهم أن الربا والبيع متماثلان من جميع الوجوه المطلوبة فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين بالحل والثاني بالحرمة وعلى هذا التقدير فأيهما قدم أو أخر جاز [30].
قلنا: اعلم أنه لما ذكر أكل الربا ذكر معه اضطراب أفهام المرابين وتخبطهم تخبط من تخبطه الشيطان من المس، ولابد أن يظهر هذا التخبط والاضطراب في رؤيتهم للأمور وقياساتهم. فأول القياس أنهم قاسوا المعلوم على المجهول لإثبات المجهول وهو قياس مضطرب عقلا إذ الاستواء أن يقاس المجهول على المعلوم. فقاسوا البيع على الربا، وهذا قياس فاسد جوهره، وبين اضطرابهم وتخبطهم فيه. فإنهم لما أكلوا الربا وطعموه وتعاملوا به فسدت قلوبهم وذهب سلطان العقل عندهم، ومن كان هذا أمره ضل وصبا، حتى لكأنهم لا يعرفون بيعا بدون ربا، فجعلوا الربا أصلا معلوما يقاس عليه. وهذا الأمر خاص بالذين يأكلون الربا ولا ينتهون. أما من لم يتعامل به فتجده لا يبرر ذلك لأحد حتى إذا غلبه الشيطان ووقع فيه برر لنفسه ذلك وأظهر قياسه الباطل للناس ظنا أنه على حق.
المسألة الرابعة:
[h=2]حول قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا.[/h]
يحتمل أن يكون هذا الكلام من تمام كلام الكفار، والمعنى أنهم قالوا: البيع مثل الربا، ثم إنكم تقولون: وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوٰاْ، فكيف يعقل هذا ؟ يعني أنهما لما كانا متماثلين فلو حل أحدهما وحرم الآخر لكان ذلك إيقاعاً للتفرقة بين المثلين، وذلك غير لائق بحكمة الحكيم فقوله: أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوٰاْ، ذكره الكفار على سبيل الاستبعاد.
واتفق أكثر المفسرين على أن كلام الكفار انقطع عند قوله تعالى: إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرّبَوٰاْ، وأما قوله سبحانه: أَحَلَّ ٱللَّه ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوٰاْ، فهو كلام الله تعالى، ونصه على هذا الفرق ذكره إبطالاً للقول على لسان الكفار: إنما البيع مثل الربا. والله أعلم.
المسألة الخامسة:
[h=2]حول قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.[/h]قال قوم، معنى ذلك: أن من جاءه موعظة من ربه فامتنع فله ما مضى من ذنبه أي صفح له وغفر ما مضى من ذنبه، كما هو قوله تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ [31]. قال الواحدي: السلف المتقدم، وكل شيء قدمته أمامك فهو سلف، ومنه الأمة السالفة، والسالفة العنق لتقدمه في جهة العلو، والسلفة ما يقدم قبل الطعام، وسلافة الخمر صفوتها، لأنه أول ما يخرج من عصيرها.
وقوله سبحانه فانتهى: ليس فيها بيان عما انتهى، فبقيت على إطلاقها. قال قوم: لابد وأن يصرف ذلك المذكور إلى السابق، وأقرب المذكورات في هذه الكلمة ما حكى الله أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، فكان قوله تعالى: فَٱنتَهَىٰ، عائداً إليه، فكان المعنى: فانتهى عن هذا القول.
قال الرازي: وأما مؤخرة الآية فقوله تعالى: وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ، ومعناه: عاد إلى الكلام المتقدم، وهو استحلال الربا،فأمره إِلَى ٱللَّهِ، ثم هذا الإنسان إما أن يقال: إنه كما انتهى عن استحلال الربا انتهى أيضاً عن أكل الربا، أو ليس كذلك، فإن كان الأول كان هذا الشخص مقراً بدين الله عالماً بتكليف الله، فحينئذ يستحق المدح والتعظيم والإكرام، لكن قوله تعالى: فأمره إِلَى ٱللَّهِ، ليس كذلك لأنه يفيد أنه تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فثبت أن هذه الآية لا تليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع، فلم يبق إلا أن يكون مختصاً بمن أقر بحرمة الربا ثم أكل الربا فههنا أمره لله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو كقوله تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، فيكون ذلك دليلاً ظاهراً على صحة قولنا أن العفو من الله مرجو[32].
قلت: وليس ثمة دليل على وجوب صرفها للمذكور في الآية، بل لعموم المواعظ على لسان الوحي أو على لسان حامل الوحي الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما أبهم الانتهاء أبهم الموعظة فجعلها على إطلاقها، وإنما جاءت موعظة من المواعظ في هذه الآية وواجب المسلم الانتهاء عنها كبقية المواعظ التي أتته من ربه. إذ ليست الموعظة خاصة بالربا أكلا وفعلا وقولا، بل بكل فعل وكل قول في عمومه.
الآية الثانية:
يقول الله تعالى: يمحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُربي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [33].
في هذه الآية مسائل:
المسألة الأولى:
[h=2]حول قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.[/h]تقول العرب: محق الشيء بمعنى نقصه، وأهلكه وأباده، وأحرقه، واستأصله، وأبطله ومحاه، وأذهب بركته. قال ابن عباس في قوله تعالى: يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلْرِّبَا، أي لا يقبل منه صدقةً ولا حجّاً ولا جهاداً ولا صلةً. والمَحْقُ: النقص والذهاب، ومنه مُحَاق القمر وهو انتقاصه. وقوله تعالى: وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ، أي يُنَمِّيها في الدنيا بالبركة ويُكثر ثوابَها بالتضعيف في الآخرة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة أحدِكم لتقع في يد الله فَيَربِّيها له كما يُرَبِّي أحدُكم فَلُوَّه أو فصيلَه حتى يجيء يوم القيامة وإن اللّقمة لعلى قدر أحُد[34].
المسألة الثانية
[h=2]حول قوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم.[/h]اعلم أن تعلق الإثم يكون بالقلب، إذ هو المتحكم في عمل الجوارح، وهو قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه[35]. وقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذًا لمن الآثمين[36]. ثم إن الله تعالى قي الآية وصف من تولى عن موعظة ربه بأنه كفار أثيم على صيغة المبالغة فعلم أن الأمر أبلغ من فعل وقول، وأبعد كونه طمس للحقيقة أوكتمانها أو تحريفها أو تزويرها، والله أعلم.
الآية الثالثة:
يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ [37].
قال القرطبي: ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً قبل نزول آية التحريم، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضاً. وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب ثقِيف، وكانوا عاهدوا النبيّ صلى الله عليه وسلم على أن مالهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم، فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء، وكانت الديون لبني عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف، وكانت على بني المغيرة المخزوميّين. فقال بنو المغيرة: لا نعطي شيئاً فإن الربا قد رُفِع. ورفعوا أمرهم إلى عَتَّاب بن أَسِيد، فكتب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتَّاب، فعلمت بها ثقيف فكفَّتْ. هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما رَوى ابن إسحاق وابن جريج والسُّدِّي وغيرهم. والمعنى اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايةً بترككم ما بقي لكم من الربا وصفحكم عنه.
أما قوله تعالى: إن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ، فشرطٌ محض في ثَقِيف على بابه، لأنه كان في أوّل دخولهم في الإسلام. وإذا قدرنا الآية فيمن قد تقرّر إيمانه فهو شرط مجازيّ على جهة المبالغة، كما تقول لمن تريد إقامة نفسه: إن كنت رجلاً فافعل كذا. وحكى النَّقاش عن مُقَاتل بن سليمان أنه قال: إنّ، إنْ، في هذه الآية بمعنى إذ. قال ابن عطيّة: وهذا مردود لا يعرف في اللغة. وقال ابن فَوْرَك: يحتمل أن يريد: يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ، بمن قبل محمد عليه السلام من الأنبياء: ذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ، بمحمد صلى الله عليه وسلم إذْ لا ينفع الأوّل إلا بهذا. وهذا مردود بما روي في سبب الآية [38].
وفي قوله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، قال القرطبي: هذا وعيد إن لم يَذَروا الربا، والحرب داعية القتل. وروى ابن عباس أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا: خُذْ سلاحك للحرب. وقال ابن عبّاس أيضاً: مَنْ كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه فحقّ على إمام المسلمين أن يستثيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم بَهْرَجاً أينما ثُقِفُوا. وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسوله، أي أعداء. وقال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا مرتَدِّين، والحكم فيه كالحكم في أهل الردّة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتُهم، ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وقرأ أبو بكر عن عاصم: فآذِنُوا، على معنى فأعلموا غيرَكم أنكم على حربهم.
وقد دلّت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر، ولا خلاف في ذلك على ما نبيّنه. ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى أحد إلا أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه غُبَاره، وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لَدرهُم رباً أشدُّ عند الله تعالى من ست وثلاثين زَنْيَة في الخطيئة، وروي عنه عليه السلام أنه قال: الربا تسعةٌ وتسعون بابا أدناها كإتيان الرجل بأُمِّه، يعني الزنا بأُمه. وقال ابن مسعود: آكل الربا وموكِّله وكاتبه وشاهده ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاريّ عن أبي جُحَيْفَة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:اجتنبوا السبع الموبِقات... ـ وفيها ـ وآكل الربا، وفي مصنف أبي داود عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده[39].
الآية الرابعة:
يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون [40].
في هذه الآية مسائل:
[h=2]حول قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة.[/h]قال مجاهد كانوا يبيعون البيع إلى أجل، فإذا حلّ الأجل زادوا في الّثَمن على أن يؤخرّوا، فأنزل الله عز وجل: يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً.
وذكر الرازي أن، أَضْعَافًا، انتصبت على الحال. ثم قال تعالى: وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فعلم أن اتقاء الله في هذا النهي واجب، وأن الفلاح يتوقف عليه، فلو أكل ولم يتق زال الفلاح، وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر.
وقد يسأل سائل، وقد طم فينا الجهل وعم، أرأيت إن لم يبلغ الربا الأضعاف المضاعفة، أيكون في عموم المنهي عنه ؟ وجوابه: قوله تعالى: مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً. فإنه لما أراد مضاعفة الأصل بين ذلك، ولما أراد الزيادة في مطلقها جعلها على إطلاقها. والله تعالى أعلم.
الآية الخامسة:
يقول الله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما [41].
[h=2]حول قوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل.[/h]اعلم أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين: الظلم للخلق، والإعراض عن الدين الحق، ومتأتى ذلك كله الحرص في طلب الدنيا والميل إلى كسب المال بأي طريقة، فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه، وتارة بطريق الرشوة وهو المراد بقوله تعالى: وَأَكْلِهِمْ أَمْوٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ، ونظيره قوله تعالى: سَمَّـٰعُونَ للكَذِبَ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحْتِ [42]. والله تعالى أعلم.
الآية السادسة:
يقول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون [43].
[h=2]حول قوله تعالى: وما آتيتم من ربا.[/h]قال عكرمة في قوله تعالى: وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَاْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ: الرِّبَا رِبَوان، ربا حلال وربا حرام؛ فأما الرّبا الحلال فهو الذي يُهْدَى، يُلتمس ما هو أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية: هو الرّبا الحلال الذي يُهدى ليُثاب ما هو أفضل منه، لا له ولا عليه، ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم. قال ابن عباس: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه، فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه، وفي هذا المعنى نزلت الآية. قال ابن عباس وابن جُبير وطاوس ومجاهد: هذه آية نزلت في هبة الثواب. قال ابن عطية: وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره، فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى. وقاله القاضي أبو بكر بن العربي. وقال ابن عباس أيضاً وإبراهيم النَّخعِي: نزلت في قوم يُعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضّل عليهم، وليزيدوا في أموالهم على وجه النفع لهم. وقال الشّعْبي: معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحداً وخف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يَجزِي به الخدمة لا يربو عند الله. وقيل: كان هذا حراماً على النبيّ صلى الله عليه وسلم على الخصوص، قال الله تعالى: وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، فنهي أن يعطي شيئاً فيأخذ أكثر منه عِوضاً.
وقيل: إنه الربا المحرّم، فمعنى: لاَ يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، على هذا القول لا يحكم به لآخذه بل هو للمأخوذ منه. قال السدي: نزلت هذه الآية في ربا ثَقيف، لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش.
وروى مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيّما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها. ونحوه عن عليّ رضي الله عنه قال: المواهب ثلاث: مَوْهبة يراد بها وجه الله، وموهبة يراد بها وجوه الناس، وموهبة يراد بها الثواب؛ فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يُثب منها. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها. وأثاب على لِقْحة ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب، وإنما أنكر سخطه للثواب وكان زائداً على القيمة [44].
. فأما إذا أراد بهبته وجه الله تعالى وابتغى عليه الثواب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته، قال الله عز وجل: وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ.
وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيًّا حتى لا يكون كَلاًّ فالنية في ذلك متبوعة، فإن كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه الله، وإن كان لما له عليه من حق القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله.
وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا منفعة له في هبته؛ لا ثواب في الدنيا ولا أجر في الآخرة، قال الله عز وجل: يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ[45].
وأما من أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبته، وله أن يرجع فيها ما لم يثب بقيمتها، على مذهب ابن القاسم، أو ما لم يرض منها بأزيد من قيمتها، على ظاهر قول عمر وعليّ، وهو قول مُطَرِّف في الواضحة: أن الهبة ما كانت قائمة العين، وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه الموهوب فيها أكثر منها. وقد قيل: إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغير فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمة كنكاح التفويض، وأما إذ كان بعد فوت الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً، قاله ابن العربي.
هذا والله تعالى أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما
[1] سورة البقرة، الآية 275.
[2] سورة البقرة، الآية 276.
[3] سورة البقرة، الآية 278.
[4] سورة آل عمران، الآية 130.
[5] سورة النساء، الآية 161.
[6] سورة الروم، الآية 39.
[7] سورة الحج، الآية 5.
[8] تفسير الطبري.
[9] تفسير السعدي.
[10] سورة البقرة، الآية 275.
[11] التفسير الكبير، الرازي.
[12] سورة النساء، الآية 2.
[13] سورة النساء، الآية 10.
[14] التفسير الكبير، الرازي.
[15] جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري.
[16] التفسير الكبير، الرازي.
[17] أخرجه مسلم وأحمد.
[18] سورة ابراهيم، الآية 22.
[19] سورة النساء، الآية 76.
[20] سورة النحل، الآيات 99-100.
[21] سورة الأعراف، الآيات 16-17.
[22] سورة النحل، الآية 63.
[23] سورة الحشر، الآيات 16-17.
[24] سورة مريم، الآية 83.
[25] سورة ص، الآية 11.
[26] سورة المؤمنون، الآيات 97-98.
[27] سورة فصلت، الآية 36.
[28] التفسير الكبير، الفخر الرازي.
[29] سورة الأعراف، الآية 201.
[30] التفسير الكبير، الفخر الرازي.
[31] سورة الأنفال، الآية 38.
[32] التفسير الكبير، الفخر الرازي.
[33] سورة البقرة، الآية 276.
[34] أخرجه مسلم.
[35] سورة البقرة، الآية 276.
[36] سورة البقرة، الآية 276.
[37] سورة البقرة، الآية 276.
[38] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي.
[39] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي.
[40] سورة آل عمران، الآية 130.
[41] سورة النساء، الآية 161.
[42] سورة المائدة، الآية 42.
[43] سورة الروم، الآية 39.
[44] أخرجه الترمذي.
[45] سورة البقرة، الآية 264.