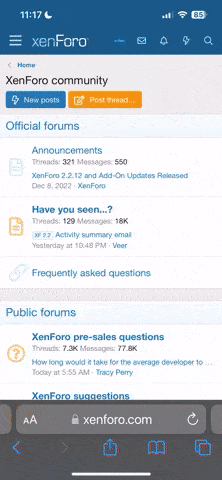علي هاني يوسف
New member
- إنضم
- 9 يناير 2008
- المشاركات
- 81
- مستوى التفاعل
- 2
- النقاط
- 8
ملاحظة: فهم هذا الملف حق الفهم موقوفة على الألوان التي لونت بها الآيات، وهذا غير متوفر في هذا الموقع ، هناك نسخة ملونة على فيس : علي هاني العقرباوي ، باسم "كشف العلاقة المعجزة بين مقدمة سورة يوسف وخاتمها، وشرح طريقة ميشيل كويبرس (التحليل البلاغي) وبيان ما لها وما عليها" وهذا البحث هو الجزء الثاني منه.
وليس الارتباط والتناسق البديع بين مقدمة السورة وخاتمتها إلا صورة من لوحة فنية رائعة ترسمها سورة يوسف ـ عليه السلام ـ كما هو شأن جميع سور القرآن ، فهناك ترابط بين كل آية وآية قد بينه كثير من المفسرين كالبقاعي ، والرازي ،وأبي حيان، وابن عاشور ، وهناك ترابط بين كل مقطع ومقطع في السورة وقد اعتنى ببيانه جماعة من المفسرين كسيد قطب ، وسعيد حوى ، وابن عاشور، وهناك ترابط بين كل أجزاء السورة اعتنى ببيانه البقاعي، وسيد قطب، وهناك ترابط بين سور القرآن من سورة البقرة إلى الناس اعتنى ببيانه أبو جعفر بن الزبير، والبقاعي ،وسعيد حوى، وهناك بناء قرآني عجيب سواء في داخل السورة أو بين سور القرآن يحتاج إلى كثير من البحث ، فلم يُعطَ حقَّه بعدُ.
وقد جاء في زماننا من المستشرق ميشيل كويبرس[1] فحلل عدة سور من القرآن على طريقة تسمى بـ(التحليل البلاغي)، و(التحليل البنائي)، و(التحليل على الطريقة السامية)، و(فن تركيب الخطاب) وسميت كذلك لأنها ـ كما يقول كويبرس ـ إعادة اكتشاف لتقنيات الكتابة وطرائق النظم التي كان يستخدمها الكَتبة في العالم السامي القديم في كتابة نصوصهم.
ويعْنِي بالتحليل البلاغي: فن تركيب الخطاب وترتيبه، والتركيب الكلي للنص، والقواعد الحاكمة لطريقة بنائه، والكيفيات التي يتألف منها متنه، وهذا يختلف عن بيان الارتباط بين الآية التي تسبقها أو بيان محور السورة ومقصودها.
وقد أتى بأمور دقيقة عجيبة في نظم القرآن الكريم لا سيما في تحليله لسورة المائدة وللسور القصار ، وقد استفدت كثيرًا من طريقته في تحليل سورة الأنفال والنور فظهر بمزج طريقته مع ما ذكره علماؤنا في العلاقات والتناسقات في سور القرآن مناسبات وأسرار عجيبة، و تجلت طريقة نظم القرآن الدقيقة المحكمة، لكن ميشيل بعد أن كُشِفَت له أسرار النظم القرآني العجيب المتماسك الذي اعترف هو به بدل أن يكون ذلك داعيًا له للإسلام والاعتراف أنه من عند الله تعالى، ادعى أن مثل هذا النظم لا بد أن يكون نشأ في بيئة يهودية أو نصرانية أو يهودية سامية أو نصرانية سامية ، ولا يمكن أن يكون قد أخذ شفاهًا؛ لأنه نظم شديد التعقيد والتناسب والإبداع ، و مزَجَ ميشيل إبداعه بأفكار استشراقية مخالفة لروح الإسلام بل هادمة للإسلام من أصله، وأوغل بطريقة مُدَبَّرة لهدم الرسالة ، وادعاء افتراء القرآن ،وهدم السنة والروايات، وهدم التراث التفسيري لعلمائنا من أصله، وحرَّف القرآن بتفسيرات لا أصل لها ، وما أشبه حاله بالوليد بن المغيرة الذي قال عنه القرآن بعد أن أدرك إعجاز القرآن الكريم ثم قال عن القرآن بعد أن عجز أن يصفه بوصف يقنع الناس بافترائه : إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ، أي: سحر قديم موروث أخذ عن الأقدمين لا نظير له في زماننا ـ :{ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26 )[المدثر:11ـ 26)، فلا بد أن لا يقرأ كتبه إلا المتخصصون فيستخلصوا كنوزها ويخرجوها للناس ويتركوا ضلالها ، وقد قام ميشيل بعمل مخطط عام لسورة يوسف وسيأتي في آخر البحث بعد شرح طريقته ليفهم حق الفهم.
، وتلخيص طريقته: أن اعتناءها منصب على التركيب الكلي للنص، فتعنى بالنص كاملًا بجميع أجزائه ، وبالقواعد الحاكمة لطريقةِ وقواعدِ بناءِ النص القرآني ، والكيفياتِ التي يتركب بها النص ذاته، لا مجرد التناسب بين الآيات والسور ووجوه الارتباط بينها ، ولا تقتصر على الكلمة أو الجملة، وتنظر إلى أن السورة مركبة من قطع وفقرات تتجمع مع بعضها لتشكل الرسمة الجميلة كاملة ، كما تركب القطع مع بعضها لتكون لوحة جميلة مبدعة، وليست طريقته كطريقة التركيب الخطي ، وهذه الطريقة في أول مراحلها قريبة مما فعل سيد قطب وسعيد حوى في تقسيم السورة إلى فقرات وموضوعات.
وطريقته تنظر لتفسير القرآن بالقرآن، والربط بين سور القرآن كافة كما فعل البقاعي، وأبو جعفر بن الزبير وسعيد حوى، وتنظر للعلاقات بين مقاطع السورة وسور القرآن كافة ، مع المقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل وشروحهما كما فعل البقاعي في كل قصة قرآنية ، ولكنه أوسع مما فعله البقاعي بالاطلاع على الشروح الكثيرة التي حُقِّقَتْ والمخطوطات التي ظهرت للتوراة والإنجيل بعد البقاعي، وهي متوفرة ميسرة في الغرب لا سيما بعد تطور دراسة اللغات السامية التي يتقنها كثير من الباحثين الغربيين ، وهذه الطريقة فيها تشابه مع ما فعله المفسرون لكنها تخالف طريقتهم أنها تبحث في قواعد بناء النظم القرآني ، وتقرر أن قواعد البلاغة السامية تعتمد على مبدأ التناظر، ففي هذه البلاغة يتم بناء المعنى من خلال بنية معقدة من التوازيات الشكلية بين العناصر النصية المتناظرة(كلمات أو جمل) وليس من خلال تطور خطي مستمر .
وقد تم التنظير والتقعيد لهذه القواعد بشكل واضح من قِبَل رولان مينيه[2] في كتاب (رسالة في البلاغة الكتابية)، فاستفاد منها ميشيل في تطبيقها على القرآن الكريم.
وهذه الطريقة تقسم السورة تصاعديًا إلى:
مفصل، ثم فرع، ثم قسم، ثم جزء، ثم مقطع (سورة قصيرة كسورة العلق)، ثم سلسلة كسورة الحاقة، ثم شعبة، ثم كتاب (هي في القرآن الكريم السورة الطويلة كالمائدة)، وتقسم هذه المستويات إلى قسمين:
2 ـ ثم فرع وهو يتكون من مفصل أو مفصلين أو ثلاثة لا أكثر.
3ـ قسم يتكون من فروع، كذلك لا يزيد على ثلاثة.
4ـ جزء ويتكون من أقسام، ولا يزيد على ثلاثة.
6ـ سلسلة تتكون من مقاطع، وهي مستوى أعلى من المقطع ويشمل أكثر من مقطع كسورة الحاقة تعتبر كلها سلسلة.
7ـ شعبة مثل الآيات (1ـ 71) في سورة المائدة شعبة، والآيات (72 ـ 120) شعبة ثانية، ومن مجموعهما تتكون سورة المائدة.
8 ـ الكتاب (هي في القرآن الكريم السورة الطويلة كسورة المائدة تتكون شعب) وهي مستوى أعلى من السلسلة وتحوي عددًا من السلاسل.
فالمفاصل تكوِّن الفروع، والأقسام تكوِّن الأجزاء، والمقاطع تكوِّن السلاسل، والسلاسل تكون الشعب، والشعب تكون الكتاب.
يقسم الآية أقسامًا يرتبها فوق بعضها، فيضع كل جملة (مفصل) وحده وتحته المفصل الآخر إلى ثلاثة، وهذه المفاصل تشكل الفرع، ثم يضع تحته الفرع الثاني كذلك، وهذه الفروع تكوِّن الأقسام، وبعد النظر والتدقيق في الفروع والعلاقات بينها، يعيد الكتابة للأقسام وينظر فيما بين الأقسام، ثم يجمع الأقسام لتشكيل الأجزاء وينظر في العلاقات بينها، ثم يعيد كتابة الأجزاء وينظر في العلاقة بينها لتظهر المناسبات بينها وهكذا.
ولا بد أن نعرف أنه في المستوى الأدنى يمكن أن يحتوي الفرع على مفصلين أو ثلاثة مفاصل لا أكثر، وكذلك في: الأفرع، والأقسام، والأجزاء، ولا تسري هذه القاعدة في المستويات الكبرى ابتداء من المقطع وإن كثرت مراعاتها في القرآن الكريم.
وفي المستوى الأعلى يتألف القسم من فرعين أو ثلاثة أفرع مرتبة حسب أحد الأشكال النظمية الثلاثة التي ستذكر، وهكذا دواليك في المستويات المرتبة تصاعديًا: الجزء ثم المقطع ثم السلسلة ثم الشعبة ثم الكتاب (أو السورة الطويلة).
وقد تحتوي النصوص الطويلة كالسور الطوال عشرة مستويات، والقرآن كله مبني بشكل متشابك مثل البناء الهندسي الكسيري.
وهو يقرر أن الطريقة البلاغية في اللغة السامية جميعها تستند في بلاغتها وبنائها على مفاصل متوازية مرتبطة فيما بينها بصلة ترادف أو تضاد أو تكامل، ويوجد فيها مبدأ الثنائية والتناظر حيث يتخذ التناظر في النص ثلاثة أشكال أو صور نظمية:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [رحيم بالعالمين]
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) [القارعة: 6 ـ 9]
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم [الفاتحة:7،6]
2) الشكل الثاني:(النظم المعكوس) أو (التركيب المرآتي) عندما ترتب العناصر ترتيبًا معكوسًا:
(أ، ب، ج/جَ، بَ، أَ) وهو ما يسمى المقابلة العكسية على مستوى الجملة.
ومثاله سورة القارعة :
1ـ ففي الطرفين [أ]و[أَ] يظهر عنصر مستقل، بدون جملة وهو (القارعة)، (نار حامية)[4]، وكذلك النار الحامية تكون عند نهاية القارعة؛ لذلك قال البقاعي :" { نار حامية} أي: قد انتهى حرها ، هذا ما تتعارفونه بينكم ، وأما التفاصيل فأمر لا يعلمه إلا الله تعالى ، وهذا نهاية القارعة ، فتلاؤم الأول للآخر واضح جداً وظاهر".[5]
2ـ أما [ب]،[بَ] فتظهر فيه الأسئلة المتطابقة جزئيًا: {مَا الْقَارِعَةُ (2)}، { وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3)} ـ { وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10)}.
3 ـ أما الآيات المتجاورة في وسط السورة (4ـ 5[ج]/ [جَ] 6ـ 9) فتكون فرعين اثنين متوازيين تمامًا ، فيمكننا عرض السورة بالشكل الآتي: أب ج/ جَ بَ أَ.
ويلاحظ أن القسم الأول من السورة يصف يوم القيامة وما يحدث فيه من اضطرابات كونية ، ويصف القسم الثاني الجزاء والدينونة .
3) الشكل الثالث: النظم المحوري: عندما يتوسط عنصر محوري طرفي التوازي، يتم فيه إدخال عنصر مركزي بين مُنحَدري التركب المرآتي (أب ج/×/جَ بَ أَ)، ويسمى التركيب الدائري، وقد نجد هذه التراكيب في مستويات النظم المختلفة (الفروع، المقاطع الخ).
وفي القرآن الكريم الشكل النظمي الأكثر ورودًا على المستويات النصية العليا، هو (النظم المحوري)، حيث يشير مركز هذه النُّظُم عن أهمية خاصة، وهو غالبًا يكون مفتاح التأويل لمجموع النص الذي يحتل مركزه، وهو غالبًا يكون على شكل: سؤال، أو حكم، أو شاهد، أو مثل: مثل شيء يدعو القارئ إلى التفكر واتخاذ موقف: كالترغيب والترهيب، ووصف الجنة والنار ونحو ذلك.
وتوجد صور النظم الثلاثة السابقة في مستويات نصية مختلفة: على مستوى الآيات، أو مفصل من آية، ثم على مستوى مجموعة مكونة من مفصلين أوثلاثة وهكذا دواليك حتى النص بأكمله، وذلك من خلال مجموعة من التداخلات.
وفي كل مستوى يمكن ملاحظة التناظرات من خلال المؤشرات التي يعطيها النظم، فالعناصر قد تتناظر في بداية[6] أو نهاية أو وسط الوحدات النصية المتناظرة، أو في نهاية وحدة نصية وبداية الوحدة اللاحقة، للربط بينهما كما هو الحال فيما يطلق عليه " كلمات الحبك"[7] ، أو في بداية ونهاية الوحدة لتحديدها.
تتنوع مؤشرات التناظر فقد تكون مجرد: تكرار، أو ترادف، أو تقابل، أو تماثل صوتي، أو جناس تام، أو جناس ناقص، أو انتماء كلمتين لنفس الحقل الدلالي (الشمس، القمر، الأرض، البحر..)، وقد تكون صيغة تحويه مماثلة مثل فعلين بصيغة الأمر، أو جملتين بنفس البنية التركيبية.
عندما تتناسب معظم عناصر التناظر نتحدث عن تناظر تام إلا أنه في معظم الأحيان لا تتناظر سوى بضعة عناصر (تناظر جزئي).
تقع مؤشرات التناظر الجزئي: إما في بداية الوحدات النصية المتناظرة (وتسمى عناصر بدئية) أو في نهايتها (عناصر نهائية) أو في وسطها (عناصر مركزية) أو في أول الوحدة المعنية وفي نهايتاه فتحد طرفيها (عناصر طرفية وهي توافق التضمين الكلاسيكي) أو في نهاية وحدة وبداية الوحدة اللاحقة للربط بينهما (عناصر وصلية توافق (كلمة الوصل) أو (كلمة الحبك).
والعجيب أن سورة الفاتحة تميزت بأن جميع مستويات النص تتسم بوجود أشكال النظم الثلاثة نفسها:[8] التوازي، والتناظر المعكوس، والبناء المحوري.
ويتميز نظم سورة الفاتحة بالتوازن الكامل إذ يتألف من قسمين متناظرين يتكون كل منهما من فرعين ، ويتألف كل فرع من مفصلين ، ويرتبط القسمان بواسطة قسم مركزي صغير مكون من فرع واحد.
1ـ ففي القسم الأول لا يقتصر الأمر على وجود توازٍ بين المفصلين (1)،(2) (مع تكرار لفظ الجلالة (الله) في كل مفصل) [أ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
[ب] الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
فكل من (بسم الله) (الحمد لله ) فيه لفظ الجلالة، والأول استعانة وتبرك باسم ، والثاني حمد له ، وكذلك هناك توافق بين {الرحمن} المنعم ، {الرب} المربي ، وكذلك مناسبة بين {الرحيم} ، و{العالمين} فالله سبحانه رحيم بالعالمين.
2 ـ ووجود تواز بين المفصلين (3)، (4)،
[أ] الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)
[ب] مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) [مضاف إليه]
هناك تقابل بين (الرحمن) و(مالك) فكلاهما من أوصافه سبحانه، والأول فيه الترغيب والثاني فيه الترهيب، وكلاهما وصف للفظ الجلالة .
وهناك تقابل بين {الرحيم}،{يوم الدين} فهو سبحانه رحيم في كل وقت وقد ادخر سبحانه تسعة وتسعين جزءًا من الرحمة ليوم القيامة.
3ـ أقول ليس التوازي بين المفاصل السابقة فقط بل يوجد تواز آخر فيما بين المفصلين الأولين من الفرعين (3،1) وهما متطابقان جزئيًا:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)
أما الفرعان المتوازيان (6ـ 7أ/7ب ـ 7ج) في القسم الثالث فيوجد بينهما تضادّ:
الفرع الأول: [أ] اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)
[ب] صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [أ]
الفرع الثاني : [أ] غَيْرِ [×طريق معوجة] الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [ب]
[ب] وَلَا [×طريق معوجة] الضَّالِّينَ (7) [ج]
: ففي الفرع الأول نجد أن المؤمن يسأل الله تعالى الثبات على الصراط المستقيم والزيادة من الهداية ، وأما الفرع الثاني فهو يسأله ألا يهديه صراط المغضوب عليهم ولا الضالين .
ونلاحظ صلة التكامل بين مفصلي الفرع الأول: حيث يشرح المفصل الثاني معنى عبارة (الصراط المستقيم) التي أعلن عنها في المفصل الأول ، بـأنه {صراط الذين أنعمت عليهم}.
أما مفصلا الفرع الثاني فيتوافقان بأن كلًا منهما بدئ بحرف نفي {غير،لا} ، وهناك توافق بين المغضوب عليهم والضالين بأن كلًا خارج عن الصراط المستقيم معذب في الآخرة ، وهناك اكتفاء فيفهم من الصراط المستقيم أن المغضوب عليهم والضالين على الطريق المعوجة غير الموصولة.
يلحظ عنصر الوصل بين الفرعين وهو (عليهم) فقد تكررت في الفرعين ، وهناك تقابل بين (أنعمت) وبين (المغضوب ، الضالين)، وهناك دقة ومناسبة وتكامل بين استعمال الماضي {أنعمت} في الأول، واسم المفعول في الثاني {المغضوب}، واسم الفاعل في الثالث{الضالين}.
أما القسم المركزي (5أ ـ ب) فلا يتضمن سوى فرع واحد متوازٍ ومترادف:
[أ] إِيَّاكَ نَعْبُدُ
[ب] وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)
فالمفصلان كل منهما بدئ بـ{إياك} ،ويتبعهما فعلان ينتميان لمجال دلالي واحد {نعبد}، {نستعين}فكلاهما خضوع وتذلل وتوحيد له سبحانه ، وكما هي العادة في البلاغة السامية في البنى المحورية يقوم القسم المركزي بدور محور الانطباق بين القسمين الآخرين اللذين يربطهما:
فالمفصل الأول {نعبد} يشير إلى القسم الأول وهو بالكامل عبارة عن تعبد إلى الله تعالى من خلال بعض الأسماء الحسنى ، وأيضًا هو نتيجة للقسم الأول ؛ لأن القسم الأول فيه الثناء على المستحق للحمد؛ لأنه رب العالمين رحمن رحيم ، فهو المستحق لأن يثنى عليه وحده ، فلما كان كذلك كان المستحق لأن يعبد وحده.
والقسم الثاني: {إياك نستعين} يعلن عن القسم الثالث ، كأنه لما قال إياك نستعين قيل: ما أهم شيء تستعينون بالله تعالى عليه أجيب: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)}.
وخلاصة الفاتحة ومقصودها في مركزها: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)}، جاء في مقاصد السور لعلي هاني:" مقصود الفاتحة جمع خلاصة مقاصد القرآن وتلخيصها، وهي ترجع إلى: تحقيق استحقاق الله تعالى لكمال التوجه له بالعبودية والاستعانة به وحده".
وهذا يعطينا مفتاحًا عظيمًا في تحديد مقاصد السور من خلال الأقسام المحورية ، وقد نبه كويبرس على أهمية الأقسام المركزية.
وبناء على ما تقدم يمكننا القول بأنه يوجد تكامل بين القسمين الطرفيين (القسم الأول، والثالث) لسورة الفاتحة ، وأن القسم المركزي الموجز يشير إلى هذا التكامل ويقوم بدور الربط بين القسمين ، وهو خلاصة السورة ومقصودها.
وبهذا ظهر أن الفاتحة تتسم بوجود أشكال النظم الثلاثة نفسها التوازي، والتناظر المعكوس، والبناء المحوري.
الطريقة العملية للتحليل البلاغي:
عندما تريد أن تحلل نصًا بهذه الطريقة فلا بد أن تحدد موضوعات كل جزء كما يفعل سيد قطب، فهذه الفقرة مثلًا تتحدث عن تعذيب الأقوام فهي جزء مستقل، وهذه الفقرة تتحدث عن الجزاء في الآخرة فهي جزء مستقل، وهذه الفقرة تتحدث عن صدق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهي جزء مستقل، ثم نقسمها إلى مفاصل (كل سطر يعتبر مفصلًا)، ثم إلى فروع، ثم إلى أقسام، ثم أجزاء، ثم مقاطع، ثم إلى سلاسل التي هي كالسور المتوسطة كسورة الحاقة تعتبر كلها سلسلة.
والمفصل عبارة عن جملة فعلية قصيرة أو جملة اسمية وأحيانًا تتكون من كلمة واحدة مثل (الحاقة)، وأحيانًا يفرض المعنى أو النحو أو الإيقاع اعتبار فعلين مفصلًا واحدًا وهذا كثير، وكل مفصل يوضع في سطر، وعندما تحتوي الآية الواحدة على أكثر من مفصل واحد يسبق كل مفصل حرف [أ]، أو [ب] أو [ج] كما سيأتي في الأمثلة الآتية، وتضع رقم الآية على اليمين فمثلًا لو قسمنا الآية السابعة من السورة إلى ثلاثة مفاصل نكتبها هكذا:
(7) [أ] سخرها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا
[ب] فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى
[ج] كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
وهذه المفاصل الثلاثة تشكل الفرع ... ثم بعد ترتيبها، نأتي بمجموعة مثلها تجعل فرعًا ولا يزاد على ثلاثة أفرع، ولا بد أن ينظر في توافق، أوتضاد، أو تجانس أو، نحو ذلك، وتقسم على حسبها المفاصل والأفرع، ويبقى التقسيم يتأرجح في البداية حتى تصل لصورة التناسب التام، نلون المتماثلات أو المتضادات أو المتجانسات.. الخ بلون يميزه كـ (ثمود، عاد، فرعون)،(أما ، فأما ) أو تضع إشارات للتناسب بدل الألوان مثل (÷=+- ) أو نحو ذلك، ولا دلالة لها إلا الإشارة إلى التناسبات بين المفاصل .
تترك مساحة فارغة ثم رقم المفصل، ويتم خلال الكتابة محاذاة العناصر المتناسبة محاذاة رأسية، ويتم إبراز التناسب بإعطاء هذه العناصر لونًا أو نمطًا خاصًا مثل (غامق، مسطر، مائل)، ثم لا بد أن تمييز الفروع، إذا توازى مفصل مع مفصل يرمز له على اليمين بـ(ب، بَ) مثلًا فالأول يوضع عنده (ب) والثاني(بَ).
وكل فرع لا بد ألا يحوي أكثر من ثلاثة مفاصل، لكن عند كتابتها قد نضع عدة أفرع مع بعضها ثم نضع خطًا، ومجموع هذه الأفرع تكون القسم، ومجموع الأقسام تكون جزءًا.
ولا بد وأنت تحلل من مراعاة معاني النصوص مع مراعاة الأمور اللفظية، ولا بد أن ينظر ويبحث في الروابط التي تربط الأفرع ببعضها، ثم يعاد كتابتها للنظر في مستوى القسم ثم الجزء، فكل جزء فيه أقسام مثلًا.
والذي سأعرضه من آيات سورة الحاقة عبارة عن جزء ، وهذا الجزء يتكون من ثلاثة أقسام كل قسم فصل عن الآخر بسطر، وكل جملة مرقمة وموضوعة في سطر مستقل مثل (الحاقة) هي مفصل ، وكل ثلاثة مفاصل فأقل عبارة عن فرع ، ولا يتكون الفرع من أكثر من ثلاثة مفاصل، ففي الآية السابعة ليس {فهل ترى لهم } معدودةً مع الفرع السابق :{سخرها عليهم ،فترى القوم ، كأنهم أعجاز}؛ لأنها ثلاثة مفاصل ولا يزاد على ثلاثة مفاصل ، ثم علينا أن ننتبه أننا إذا أخذنا جزءًا آخر من السورة نفصله بسطر غليظ مثلًا عن هذا الجزء، ثم ننظر في التناسبات بين الوحدات الصغيرة ثم الأكبر ثم الأكبر، ونرى على أي طريقة وردت ، فعندنا انسجامات داخلية وخارجية ثم نكتب المقاطع كل مقطع في جدول ونرى العلاقات بين المقاطع، وفي النهاية تظهر السورة كسلسلة مكونة من مقطعين مثلًا أو ثلاثة ، وكل مقطع يقسم إلى أجزاء توضع بشكل متميز، ثم ينظر من أي شكل من الأشكال الثلاثة السابقة رتبت السورة هل هي من النظم المحوري أو غيره .
كل ما سأذكره هنا عبارة عن جزء يتكون من أقسام:
القسم الأول:
.................................................. ...
القسم الثاني:
+[ج] كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
..................
(8) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
.........................................
*****
وزيادة في التوضيح إليك نموذجًا كاملًا وهو تحليل سورة العلق[9]:
أ ـ (1) اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
ب = [ب] الَّذِي خَلَقَ
ج + (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
أَ ـ (3) اقْرَأْ و َرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
بَ = (4) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
جَ + (5) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
ف(أ) مفصل، و(ب) مفصل، و(ج) مفصل، وهذه المفاصل الثلاثة تكون فرعًا، فهو فرع ثلاثي المفاصل.
وكل من (أَ)، (بَ) مفصل، و(جَ) مفصل، وهذه المفاصل الثلاثة تكون فرعًا.
وهذان الفرعان يشكلان قسمًا، فجميع ما تراه من سورة العلق هنا قسم وما سيذكر بعده قسم آخر، تلاحظ أن المفاصل كونت فرعًا، والفرعين كونا قسمًا.
ويلاحظ أن ترتيب الفرعين: أ، ب، ج //جَ، بَ، أَ، فهو من الشكل الثاني:النظم المعكوس.
يلاحظ أن (خلق، خلق) تكررت في الفرع الأول، و(علم، علم) تكررت في الفرع الثاني، فهذه الكلمات كل منها ارتباط بين أجزاء الفرع من خلال تكرار عنصر وصل (كلمة ربط: خلق، علم).
يلاحظ التقابل بين (ربك) في الفرع الأول، و(ربك) في الفرع الثاني.
وكذلك التقابل بين (الإنسان) في الفرع الأول، و(ربك) في الفرع الثاني.
وكل من الفرعين فيه التقابل بين عظمة الله تعالى ومنته وكرمه، وضعف الإنسان وتحويله من الضعف والخلق المهين إلى الخلق العظيم وتعليمه ما لم يعلم.
والعناصر الطرفية للمفاصل (خلق، علق)، (علَّم، يعلم) بينها جناس.
ويلاحظ بين خلق ـ الإنسان من علق.
علم ـ الإنسان ما لم يعلم.
الجزء المركزي [10]
كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6)
أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)
إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8)
وهو مؤلف من فرع واحد وهذا الفرع فيه مفاصل ثلاثة على صورة (أ، أَ، ب).
يلاحظ أن المفصلين الأولين فيهما ذكر جريمة هذا الإنسان، والمفصل الأول نتيجة للثاني، فرؤية نفسها مستغنيًا سبب للطغيان.
وفي المفصل الثالث تهديده بأنه سيرجع إلى ربه المنعم عليه لا إلى غيره وهناك سيجد عقوبته على هذا.
يبدأ المفصلان الطرفيان بالحرف (إنَّ).
والمفصلان الأوليان بيان خطأ الإنسان بشيء لا ينبغي أن يفعله (طابع الحكمة الأخلاقية)، والمفصل الأخير تهديدهم بالعذاب الأخروي (أمور أخروية).
ولا بد أن يعلم أن غالب سور القرآن سلكت الطريقة المحورية المرآتي (أب ج/×/جَ بَ أَ)، ويسمى التركيب الدائري، وفي سورة العلق القسم المحوري (×) هو هذا الفرع المكون من المفاصل الثلاثة، وتقدم معنا أن الأقسام المحورية تتكون غالبًا من سؤال، أو جملة خلقية، أو أخروية ، أو ترغيب وترهيب، ويقابل فيها بين الإيمان والكفر والخير والشر ، والنجاة والهلاك ، وهكذا جاء المركز هنا.
وزيادة في التوضيح لو نظرنا لسورة البروج فالمركز فيها هو: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11)} [البروج:(10 ـ 11)].
*******
القسم الأول: (الآيات:9ـ 13).
ج ـ [أ] أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ
=[ب] وَتَوَلَّى (13)
يقول علي هاني: "الذي ينهى هو أبو جهل، والعبد هو النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالله سبحانه يُعَجِّبُ من هذا الناهي للعبد لله، فهو عبد لله لا لك يا أبا جهل فكيف تنهى عبده عبادته الصلاة له، ثم يعَجِّب ويقول سبحانه: أرأيت إن كان هذا العبد راسخًا في الهدى متمكنًا منه أشد التمكن، وليس هذا فقط بل هو أعلى من ذلك هو آمر بالتقوى، أرأيت إن كان الناهي مكذبًا ومتوليًا.
هذا القسم مركب من فروع ثلاثة (أ، ب، ج) وكل فرع مركب من مفصلين (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا).
) مفصل، {إِذَا صَلَّى (10)} مفصل وهما يكوِّنان فرعًا، وهكذا الثاني والثالث فهي فروع ثلاثة ، وهذه الثلاثة تكون قسمًا.
كل فرع يبدأ بالفعل المسبوق باستفهام {أَرَأَيْتَ}.
الفروع (أ) (ج)تتكلم عن أبي جهل الذي نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتذكر صفاته فهو ناهٍ للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومكذب ومتولٍ، وفي الفرع الوسطي _(ج) فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد مصلٍّ، وعلى الهدى وآمر بالتقوى.
فهذه الفروع على الصورة (أ × أَ).
وهناك مناسبة واضحة في الفرع الأول(أ) بين (عبدًا، صلى) فالعبودية تقتضي الصلاة.
وهناك مناسبة في الفرع (ب) بين (إن كان على الهدى) أو (أمر بالتقوى) فالأول يذكر اتصافه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهدى الراسخ المتمكن ،والثاني يذكر الدعوة لهذا الهدى، وبينهما احتباك: حذف من الأول لدلالة الثاني، وحذف من الثاني لدلالة الأول، كأنه قيل: إن كان على الهدى والتقوى أو أمر بالهدى والتقوى.
ثم إذا جمعنا الفرع (أ)، (ب) تحصل عندنا صفات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشكل كامل متناسب: العبودية {عبدًا} ـ وهي تقتضي الصلاة {إذا صلى} ـ والتمكن من الهداية{على الهدى} صحة الفكر والمنهج وسلامته [حذف أنه متقٍ] لدلالة ما بعده ـ ثم هو آمر بهذا الهدى والتقوى {أو أمر بالتقوى}.
وفي صفات أبي جهل ذكر: نهيه للنبي ـ عن صلاته ـ تكذيبه ـ توليه.
يلاحظ التماثل بين الفرع (ب) (ج) باستعمال حرف الشرط (إنْ).[11]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
القسم المركزي (المحوري): أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
القسم الثالث (الآيات: (15ـ 19):
1ـ [أ] كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ (15)
ـ [ب] لنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
[ج]ـ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16)
2= [أ] فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17)
= [ب] سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ
3+[أ] كَلَّا لَا تُطِعْهُ
+[ب] وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ(19)[×]
هذا القسم مركب من ثلاثة أفرع (1، 2، 3)، والفرع الأول (1) من ثلاثة مفاصل (أ، ب، ج).
ويتكون كل من الفرع (2)، (3) من مفصلين.
ويستمر في هذا القسم الثاني الذم لأبي جهل لكن على شكل تهديد بالعقاب.
الفرع الطرفي (1) يبدأ بحرف الردع والزجر مؤكدًا ما ورد من الردع والزجر في القسم المركزي: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) }.
الفرع الأول فيه كلمات الحبك أو الوصل تتكرر (بالناصية، ناصية) وكذلك الفرع (2) فيه كلمات الوصل (فليدع، سندع)، والفرع (1) و(3) بينهما كلمة وصلية (كلا، كلا).
وكذلك الفرع الثاني (ناديه) تتقابل مع (الزبانية) فجماعة أبي جهل الذين يدافعون عنه هم ناديه ويحمونه من عذابه، وأما أنصار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجند الله تعالى الذين سيهلكون أهل النادي مع أبي جهل هم (الزبانية) ملائكة العذاب.
الفرع الأخير (3) يمثل توازيًا تضاديًا (لا تطعه) في ترك السجود والعبادة ولا تتوقف عن عبادتك يقابلها (اسجد واقترب). (أي صلِّ).
والفرع الأول فيه كلمتان بينهما توافق بين (كاذبة، خاطئة)، وفيه مع الفرع الثالث اكتفاء فحذف في الفرع الثالث ما يقابله وهي الناصية الصادقة الطائعة كأنه قيل: اسجد (على ناصيتك الصادقة الطائعة) واقترب.
القسم المحوري: أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى
هذا القسم المركزي ليس به إلا مفصل فقط، ومن اللافت للنظر أنه عبارة عن سؤال، والمحور في البلاغة السامية غالبًا ما يكون سؤالًا يحمل على التفكير واتخاذ موقف، وكذلك يظهر في قلب الخطاب الذي وجهه سيدنا يوسف عليه السلام في السجن لصاحبيه: {أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ }[يوسف: 39]، وتحمل المراكز غالبًا في القرآن الكريم الطابع الأخروي ، كما هنا المركز فيه تهديده بأن الله تعالى يراه وسيجازيه على فعله .
قد يقول قائل: لماذا لم تختر {أرأيت} مركزًا فهي استفهام، فالجواب، أنها اتفقت أنها بصيغة الماضي وهذا انفرد بأنه بصيغة المضارع، وأيضًا {أرأيت}تعجيب من حاله، بينما هذا المركز يتكلم على تهديده وحكم الله تعالى فيه .
الآن تأتي خطوة تجميع الأقسام لتشكل جزءاً:
وهذا القسم مكون من فرعين، وفرع مركزي (محوري):
القسم الأول:
2) [أ] ـ ـ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) [الفرع الثاني]
[ب] = أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12)
3) ـ [أ] أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ [الفرع الثالث]
=[ب] وَتَوَلَّى (13)
القسم الثاني: المركزي (المحوري): أ َلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)
1القسم الثالث:
ـ [أ] كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ (15) [الفرع الأول]
ـ [ب] لنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
[ج]ـ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16)
2= [أ] فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) [الفرع الثاني]
= [ب] سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18)
3+[أ] كَلَّا لَا تُطِعْهُ [الفرع الثالث]
+[ب] وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ(19)[×]
ينظر العلاقة بين القسم الأول والثالث:
فالمفصل الأول في الفرع الأول في القسم الأول يضاد المفصل الأول في الفرع الثالث في القسم الثالث: في الفرع الأول { الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا }(10) ـ والفرع الثالث { لَا تُطِعْهُ }(19 ب).
والمفصل الثاني في القسم الأول والثالث في القسم الثالث مترادفة: { إِذَا صَلَّى}ـ {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}(19).
ونجد الفرع الأخير في القسم الثاني ختمت به السورة بمفصليه(أ، ب) { لَا تُطِعْهُ ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}
يأخذ القسم الثاني المركزي كما هو الحال عادة بالنسبة لمراكز البنى المحورية ـ دور القنطرة والمعْبر .
الفرع المركزي (المحوري): أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)
فهو متصل بالقسم الأول عن طريق صيغة الاستفهام البادئة بحرف الاستفهام (أ) ): أ َلَمْ ـ وهذا الحرف يشبه الحرف الموجود في ـ أَرَأَيْتَ.
وأيضًا بواسطة الفعل {يَرَى} ـ المتفق مع {أَرَأَيْتَ}.
ثم هذا المحور المركزي {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)} يُذَكِّر بحكم الله تعالى الذي سيظهر بعد ذلك في صورة عقوبة في القسم الثالث في صورة عقوبة؛ لأن من لوازم رؤية الله تعالى له أن يجازيه على أفعاله.
ثم إذا نظرنا في الأقسام الثلاثة فيها تدرج في المحاكمة: فالقسم الأول فيه لائحة الاتهام ـ والقسم الثاني المركزي: فيه اطلاع الله تعالى عليه وعلمه بأفعاله، والقسم الثالث: التهديد بالعقوبة في الفرع الأول والثاني من القسم الثالث:
ـ [أ] كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ (15) [الفرع الأول]
ـ [ب] لنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
[ج]ـ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16)
2= [أ] فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) [الفرع الثاني]
= [ب] سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18)
وإليك مجمل السورة في جدول بتجميع الأجزاء: وأُذَكِّر أن المفاصل كونت الفروع، والفروع كونت الأقسام ، والأقسام كونت الأجزاء .
تؤكد العديد من توازيات العناصر هنا دور القنطرة وهي الآيات(6، 7، 8) فبعضها يعود على السابق وبعضها على اللاحق : فكلمة (كلا) فيها ردع وزجر للإنسان الكافر للنعم السابقة ،فالله تعالى أنعم على الإنسان فهو الخالق للخلق على الإطلاق ،والخالق للإنسان الذي نقله من العلقة إلى الإنسان المتعلم الكاتب بالقلم الذي حوى هذه العلوم الهائلة بما علمه الله تعالى بالقلم الذي حفظ تراث البشرية على مر العصور المتلاحقة لكن الإنسان الكافر كأبي جهل كفر هذا وجحده وطغى ، فبين المركز سبب طغيانه بأنه يرى نفسه استغنى عن الله وعن الدين ، وهدده بأنه سيرجع إلى الله تعالى لا إلى غيره وسيجازيه .
وهذا المركز له علاقة بما يأتي ، فأول مثال يدخل في هذا الطغيان أبو جهل الذي رأى نفسه استغنى ونهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن عبادة ربه.
وكذلك فإن لفظ "الإنسان"، و"ربك" يؤطران الفرع المركزي ثلاثي المفاصل في الآيات (6 ـ 8) { إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6)،{ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8)}.
كما أنهما يؤطران الفرعين ثلاثيي المفاصل المكونين للجزء الأول (2أ ـ 3، 3ـ 5)،{ اقْرَأْ بِاسْمِ {رَبِّكَ {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) } ،{ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3)}، { عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)}، ويلاحظ أنه بترتيب عكسي في المركز ، فقد كانت الترتيب في الجزء الأول: ربك ـ الإنسان ـ ربك ـ الإنسان ، وفي المركز : الإنسان ـ ربك ، وهذا مناسب للمعنى؛ لأن الله تعالى أنعم على الإنسان هذه النعم، فيُسأل هل شكر ربه فقال {كلا} عكَّس ولم يشكر، وحتى يكون من رد العجز على الصدر فبدأ باسم الرب المنعم ـ وختم باسمه ؛ وليكون قد بدأ ببداية إيجاد الله تعالى الإنسان وختم بعوده إليه: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} وختم { ـ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8)} فلله در شأن التنزيل ما أعظمه.
ويلاحظ ظهور فعل الرؤية في المركز (7) {أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)}، وفي الجزء الثالث (14،13،11،9) ،{ ـ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى}،{ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11)}،{ ـ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ }،{ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14}.
وإذا جمعت على حسب ترتيبها كان له ترتيب عجيب : فـ{رآه} ذكرَتْ غروره وأنه يرى نفسه مستغنيًا عن دين الله تعالى ـ ونتيجة لذلك تكبر ونهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صلاته ـ فجاء التعجيب المتكرر ثلاث مرات {أرأيت} ـ ثم جاء التهديد برؤية الله تعالى له على هذه الحال القبيحة التي تقتضي تعذيبه.
ويلاحظ أن مادة الرؤية تكررت في مركز الجزء ومركز القسم ففي مركز الجزء (6 ـ 8){ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)} وفي مركز القسم { ألم يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)}،فالإنسان الذي يطغى يرى نفسه استغنى والله سبحانه يراه وسيجازيه.
تكرر حرف الردع والزجر (كلا) فذكر في المركز {ـ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) } للردع والزجر للإنسان الذي لا يشكر نعم الله تعالى بالخلق العام وبخلق الإنسان وتعليمه وتحويله من علقة إلى عالم يكتب بالقلم ويعلمه ما لم يعلم.
ثم كررت (كلا) مرتين في الجزء الثالث (15أو19أ) {أ]كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ}،{ [أ] كَلَّا لَا تُطِعْهُ }، و(كلا) الأولى التي أكدت بالثانية جاءت كذلك للإنكار عليه بعلم الله تعالى له ثم هو لا ينتهي ولا يرعوي رغم رؤية الله تعالى له .
ثم هناك مناسبة بين خاتمة المركز، والمركز في القسم ، وخاتمة السورة (خاتمة الجزء الثالث):
{إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8)} تناسب { أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)}، وتناسب { َاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)}فالله تعالى هدد هذا الطاغية بأنه سيرجع إلى ربه الذي خلقه وحوَّله من علقة إلى إنسان ثم يجازيه ، وهدده بأنه يعلم أفعاله ، وأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يطْمَئنَّ بأن الله تعالى معه، وأن يسجد ولا يطيع هذا الطاغية فالله قادر عليه.
وهذا ما يجعلنا أمام تطبيق للقانون الثالث لـ(لوند) (الباحث التوراتي)[12] الذي وضع نظرية لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي والذي ينص على وجود علاقة بين المركز وأطراف النظم نفسه[13]
تربط الجزءين الطرفيين، وهي من سمات البلاغة السامية فنهاية الجزء الأول: { عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)}، تتوافق بالفعل مع مركز الجزء الثالث الطرفي: { أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)}بنفس الصيغة ، وهذا هو "قانون الانتقال من المركز إلى الأطراف" ، والذي ينص على وجود ترابط في الغالب بين مركز نظم بلاغي وأطراف نظم آخر، مما يشير إلى أن النظمين يشكلان جزءًا من كلٍّ على مستوى أعلى (وهو هنا السورة كلها ):إنه "القانون الرابع عند لوند"، والكثير الشيوع في القرآن الكريم.
في السورة رد العجز على الصدر وهو رد آخر السورة على أوله: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)} أي: اجتهد في بلوغ درجة القرب إلى ربك، والتحبب إليه بكل عبادة، لا سيما الصلاة ، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛لأنه سبحانه المنعم الخالق الذي أوجد الخلق وأوجد الإنسان وعلمه ما لم يعلم .
وأيضًا في الآية الأولى كمال التوحيد بأن يقرأ متلبسًا باسم ربه المنعم لا باسم غيره من الأصنام والمعبودات، وفي آخرها كما الخضوع والعبادة له لا سيما بالسجود الذي هو غاية الخضوع، و من أهم أفراد القراءة، قراءة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم عليه على المُبَلَّغين بالرسالة ،و أن يقرأه هو في الصلاة التي من أعظم أركانها السجود ؛ ولذلك كان من أوائل السور التي أنزلت بعد سورة العلق سورةُ المزمل التي تأمر بقيام الليل ؛ ليكون أكبر عون له في الدعوة لدين الله تعالى.
ثم هنا توافق بين الجزء الأول والأخير، ففي الأول:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } وهذا أمر للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالقراءة لما يعلمه جبريل ـ عليه السلام ـ ، وهذه القراءة لا بد أن ينتفع هو بنفسه بها بعبادة الله تعالى والصلاة ثم بالاهتداء بها في فكره واتقاء الله سبحانه ثم بتبليغها للناس؛ ليهتدوا وليحصلوا التقوى بأن يأمرهم بالتقوى وأعظم وسيلة لأمرهم بالتقوى قراءة القرآن عليهم كما قال سبحانه {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ }[ق:45].
فلذلك قابل {اقرأ} في الجزء الأول بقوله سبحانه في الجزء الثالث: {إذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12)}، فرتبها ترتيبًا بديعًا، وحذف التقوى من الأول لدلالة الثاني عليه، وحذف الهدى من الأول لدلالة الأول عليه، فما أعظم القرآن، وما أكثر أسراره.[14]
ثم هناك توافقٌ لفظيٌّ صوتي بين {اقْرَأْ}،{ وَاقْتَرِبْ}.
ثم هناك تناسب عجيب بين الأجزاء الثلاثة :
فالجزء الأول يقرر الفضل الإلهي بأن الله سبحانه أنعم على الإنسان وخلقه، وحوَّله إلى إنسان بعد أن كان علقة وكرمه بالعلم ، وعلمه ما لم يعلم، وفي هذا بشارة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أول آيات أنزلت بأن الله تعالى سيعلمه علومًا كثيرة .
وفي الجزء الثاني المركزي يقرر أنَّ الإنسان الكافر وأولهم أبو جهل لم يشكر هذه النعمة وقابلها بالطغيان والاستغناء ، ففعله متعاكس متعارض مع النعم الربانية العميمة.
ويربط الجزء المركزي (6ـ 8) بين الجزأين الطرفيين من خلال جملتين فيهما أمور أخلاقية وأخروية، ويمهد للتتمة التي تجلت في إبراز صورة ومصداق لهذا الطاغية الذي استغنى وعصى وتمرد .
ثم في الجزء الثالث يقرر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان عابدًا لله شاكرًا مصليًا تلقى هذه النعم بما ينبغي أن تتلقى بالصلاة ثم بالاستقامة على الهدى والتقوى ثم بالدعوة لها، وأن الكافر الطاغية نهاه عن ذلك وكذب وتولى .
ثم جاء مركز القسم الثاني ليقرر رؤية الله تعالى له، ومن لوازمها أن الله تعالى سيجازيه على ذلك.
وفي القسم الثالث من الجزء الثالث يهدد هذا الطاغي أبا جهل الذي لم يشكر النعم، ويأمر الشاكر الذي عرف نعمة الله عليه وهو النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن لا يطيعه، وأن يستمر على عبادته.
وبعد هذه الرحلة الطويلة مع طريقة التحليل البلاغي نعود لسورة يوسف ـ عليه السلام ـ لنفهم كلام كويبرس في تحليله لسورة يوسف ، حيث قال تتألف سورة يوسف من اثنتي عشرة سلسلة موزعة في تواز معكوس [الشكل الثاني] كما يوضحه الجدول التالي:[15]
وبهذا تم البحث ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
علي هاني العقرباوي
عمان ـ الأردن
7 ـ رمضان ـ 1441 هـ
30 ـ 4ـ 2020م.
[1] هو رجل دين كاثوليكي من بلجيكا من أتباع شارل دو فوكو، عضو في أخوية إخوة يسوع الصغار ، عاش اثنتي عشرة سنة في إيران حيث حصل على درجة الدكتوراة في الآداب الفارسية من جامعة طهران ثم عمل في دار النشر الجامعية الإيرانية ، وهو أحد مؤسسي مجلة لقمان للإيرانيات ثم سافر إلى مصر فعاش في مصر منذ العام ( 1989) عضوًا في المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية (ideo) (معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان)،وتخصص في الدراسة الأدبية للنص القرآني لا سيما فيما يتعلق بتركيبه وبعلاقاته النصية مع الأدب في التوراة والإنجيل ، وقد أبدع فيما يسمى بـ(التحليل البلاغي )،( التحليل البنائي)،(التحليل على الطريقة السامية )،(فن تركيب الخطاب)، فهو رائد تطبيق منهج التحليل البلاغي على القرآن ،وهو أحد منهجيات الاتجاه التزامني .
من أهم أعماله:
1ـ "في نظم سورة المائدة نظم آي القرآن في ضوء منهج التحليل البلاغي" وقد ترجم للعربية ترجمه عمرو عبد العاطي صالح، وطبعته دار المشرق لبنان 2016.
2ـ "في نظم القرآن" ترجمه عدنان المقراني وطارق منزو، وصدر عن دار المشرق لبنان 2018.
3ـ "رؤية كشفية قرآنية: قراءة في السور الثلاث والثلاثين الأخيرة من القرآن الكريم " جمع فيه مع بعض التعديلات والإضافات مقالات سبق نشرها حول السور الأخيرة من القرآن الكريم.
4ـ "مقارنة بين التحليل البلاغي والنقد التاريخي لجون وانسبر، وغونتر لولينغ سورة العلق أنموذجًا) ترجمه خليل محمود اليماني ـ طبعه مركز تفسير للدراسات القرآنية).
5 ـ (البلاغة السامية في القرآن ـ ترجمه خليل محمود يماني).
وكتبه تحوي أمرين: أمرًا إيجابيًا، وأمرًا سلبيًا، فأما الأمر الأول فسأشرحه في أصل البحث، وقد سلك طريقة مبدعة طبق فيها ما ذكره (رولان مينيه) مدير سلسلة (البلاغة السامية) في كتابه المسمى (التحليل البلاغي) حيث تكلم في القسم الثاني من الكتاب على هذا تحت عنوان (عرض التحليل البلاغي).
وأبحاثه تبين الترابط والدقة في القرآن الكريم، وتظهر طريقة نظم القرآن وتركيبه وسيره، وتظهر كيفية التناسب العجيب في النظم والعرض القرآني، والمراد بالنظم عنده: التركيب الكلي للنص، والقواعد الحاكمة لطريقةِ وقواعدِ بناءِ النص القرآني، والكيفيات التي يتركب بها النص ذاته، لا مجرد التناسب بين الآيات والسور ووجوه الارتباط بينها، ويرد ُّعلى المستشرقين الذين يتهمون القرآن الكريم بعدم الدقة، وعدم التناسق، والانقطاع دلاليًا في العرض.
وأما الأمر السلبي فهو أنه بث في خلال كلامه كلامًا استشراقيًا خطيرًا من جملته:
1ـ أنه يحاول أن يوحي للقارئ أن القرآن استُمِد من التوراة والإنجيل، وإن كان في آخر كلامه يأتي بكلام يوهم أنه لا يقول ذلك، فتجده يأتي بالنص القرآني ويأتي بما يصدقه من النصوص القديمة ويعلق عليها بما يوحي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذها منها، أو أن النص القرآني نشأ من بيئة يهودية أو نصرانية ـ ومن المعلوم أن هناك فرقًا بين كون القرآن مصدقًا للتوراة والإنجيل ، وهو الذي يكرره القرآن دائمًا كقوله في سورة يوسف :{ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ (111)} [يوسف:111] وبين أن يكون النبي الأمي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي لا يعرف القراءة ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا تعلم من العلماء ولا من أحد من علماء اليهود والنصارى أخذه من التوراة والإنجيل،مع المعلوم أن علماءنا كانوا عندما يذكرون قصة من القرآن يوردون ما يصدقها من التوراة أو الإنجيل كما يفعل البقاعي، وابن عاشور، ومحمد رشيد رضا ، لكن يعرضون ذلك على أن القرآن مصدق لها كما نص القرآن على ذلك عشرات المرات بل هو مهيمن على الكتب السابقة ، يصحح ما فيها من أخطاء ، وأرجو من القارئ الكريم أن يرجع للتوراة أو لتفسير البقاعي الذي نقل قصة يوسف ـ عليه السلام ـ من التوراة ويقارنها بالقرآن الكريم لينظر مصداق هذا ، وليرى منطقية القصص القرآن وعدم منطقية كثير مما زاده محرفو التوراة.
2ـ يحاول ميشيل كذلك أن يوحي للقارئ أن القرآن في نظمه كالتوراة والإنجيل والكتابات السامية، وفرق بين أن يقال: القرآن الكريم جاء على الطريقة السامية ـ التي هي لغات عربية ـ بل جاء باللسان العربي المبين الذي هو أفصح الساميات، ولكنه فاق اللغات الساميات كلها فهو بالغ حد الإعجاز كما يقال القرآن عربي وليس ككلام العرب، وبين أن يقال إن نظمه كنظم غيره من الساميات.
3ـ يحاول تحريف تفسير آيات كثيرة من القرآن، لتتناسب مع أفكار و مصالح اليهود والنصارى ، ويدعو المسلمين لإعادة النظر في تفسير القرآن، بل إنه يستخدم طريقته هذه للتشكيك في تفسير علماء المسلمين ، فيقول في تحليله لسورة العلق كلمة (اقرأ )" معنى هذه الكلمة القراءة على تفسير الروايات التقليدية أمر من القراءة ، ولا شيء يعضد هذه الرواية والأصح تفسير علماء الغرب لهذه الكلمة أنها كلمة من العبارة العبرية في الكتاب المقدس بمعنى نادِ وصلِّ (قرأ بشم ياهو) ويكون حاصل المعنى صل لربك ، ولا تدل السورة أن محمدًا بعث في مهمة لتبليغ الرسالة (مقارنة بين التحليل البلاغي والنقد التاريخي لجون وانسبرو)(ص24)، فانظر إلى هذا التحريف العجيب، وتحويله لوظيفة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أصلها ،وتقديمه تفسير الذين لا يعرفون العربية على تفسير العلماء الراسخين الذين حووا جميع العلوم الخادمة للتفسير وهضموها وأتقنوها وسيروها في طريقها المحكم في التفسير ، وأنا رأيت من هؤلاء المستشرقين الكثير ممن جاء ليدرس في بلدنا، وهو لا يتقن الكلام فضلًا عن التفسير، ومعه دكتوراة في اللغة العربية، ويضع تفسيرات كما يشاء ولا رقيب عليه ولا حسيب، ويٌتَلقى كلامُه في الغرب كأنه قرآن ، فما أعجب الزمان الذي نحن فيه!
ومن جملة تحريفاته أنه قال:" التراث يقول: هذا العبد المنهي ـ في سورة العلق محمد نهاه أبو جهل وليس في النص ما يقتضي تفسيره بذلك"(المرجع السابق (31)، وهذا عجيب منه؛ فالسياق والروايات واضحة في الكلام على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولكنه يطعن في صلب الدين من حيث يُظَنُّ أنه يظهر محاسن القرآن.
ومن جملة تحريفه للأحكام استدلاله من خلال طريقته في التحليل على إباحة شرب الخمر. (البلاغة السامية (38).
ومن جملة تحريفاته ادعاؤه أن القرآن ينص على أنَّ أي فئة من البشر إذا عملوا الصالحات فهم ناجون سواء كانوا يهودًا أو نصارى أو غيرهم. (المرجع السابق 41).
4ـ يدعي أن أسباب النزول والأحاديث النبوية الشريفة وتفسيرات المفسرين هذه أضيفت لاحقًا من قبل التراث وليس لها صلة حقيقية في ذاتها، وأنها لا تراعى في التفسير، فهو ينظر للنص فقط على طريقة التحليل البلاغي، ولا يعترف بالروايات المفسرة له، ويقرر أنها نتاج متأخر ـ دون ذكر دليل علمي على كلامه ، بل يذهب أكثر من ذلك بأن ينفي أي علاقة بين كثير من السور والأحداث التي حدثت مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بل يعبر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم بالشخصية التاريخية كأنه شخصية متوهمة مصطنعة، فتجده بعد تحليل سورة العلق يقول : "ما هي العلاقة بين سورة العلق مع الشخصية التاريخية لمحمد ؟ الإجابة وفقًا لتحليله لا شيء ، فالتراث أسقط هذه الروابط بين السورة ومحمد من خلال أسباب النزول ، والتي لا أثر لها في النص لا فيما يتعلق بدعوة محمد ، ولا فيما يتعلق بالمضايقات التي عانى منها إبان قيامه بأداة الصلاة " (مقارنة بين التحليل البلاغي والنقد التاريخي (48)ـ وليس هذا فقط بل يصرح بأن طريقة التحليل البلاغي بنبغي أن تحل محل المصادر التفسيرية : سواء كانت روايات أو أقوال العلماء في التفسير ، أو تدقيقات وتحريرات المفسرين طوال القرون السابقة لفهم النص القرآني، وعلاوة على ذلك فقد قرر أن طريقة التحليل البلاغي ستدلنا على الإطار للمحيط الذي ظهر فيه القرآن سواء كان ذلك المحيط يهوديًا أو نصرنيًا أو يهوديًا ساميًا أو نصرانيًا ساميًا (المصدر السابق (يقول علي هاني: فانظر إلى هذا البهتان الذي يفعله هذا المستشرق حيث يعرض نظم القرآن بأحسن عرض ثم يدس من خلال عرضه أفكاره الاستشراقية التي تهدم القرآن، والرسالة، وعلاقة القرآن بالنبي ـ صلى الله وعليه وسلم ـ وتهدم المرويات الحديثية كلها من أصلها ، ثم تفسر النصوص كما تريد وتنسبها إلى بيئة يهودية أحيانًا ،وأحيانًا إلى بيئة نصرانية ، وذلك بأن يعرض نصوصًا توراتية لها نوع مشابهة في الموضوع ولو من بعيد بسورة ما ككونهما واعظتين مثلًا ثم يدعي من خلالها أن القرآن نشأ وأخذ من بيئة توراتية أو إنجيلية ،سبحانك هذا بهتان عظيم ، ثم هناك فرق بين إهمال الأحاديث وأسباب النزول وبين تنقيحها وأخْذِ ما صح منها وناسب السياق ، وترْكِ ما ضعف منها أو تأويله إن لم يناسب السياق، فالثانية طريقة المفسر المحقق كما يفعل هذا أبو السعود، والآلوسي، وابن عاشور، وغيرهم من كبار المفسرين الذين عندهم الأسلوب العلمي الحقيقي بخلاف هؤلاء المستشرقين الذين لا يلتفتون لما حقق في علم الحديث و المصطلح والإسناد الذي تتميز به هذه الأمة ، وهو علم تفخر به أمتنا ولا نظير له في أمة من الأمم ، وهو في الغاية من الأسلوب العلمي الرصين الذي لم ولن تصل لمثله دول الغرب ولا المستشرقون الذي يتظاهرون بالأسلوب العلمي ويخلطون الحق بالباطل ويلبسون على الناس.
ومن الملاحظ من أعمال كويبرس أنه يختار السور التي يمكن أن يصل من خلالها لهدم الدين كسورة العلق التي هي أول سورة نزلت، وسورة المائدة التي هي من أواخر ما نزل وتهدم عقائد اليهود والنصارى الباطلة، فتجده يتصيد هذه السور ويحللها ويفسرها على طريقته فيحللها ويبدع في تحليله ويبث أفكاره الاستشراقية خلال هذا التحليل.
5ـ يتهم المسلمين بأنهم يعادون اليهود والنصارى من طرف واحد وقد نص على هذا في تحليله لسورة المائدة، وهذا الأمر لا يحتاج إلى رد فما حصل في العراق، والبوسنة، والشيشان، وسوريا وغيرها يلجم من يتكلم بهذا.
6ـ يشكك في صحة تقسيم الآيات وترقيم آياتها، ومن المعلوم أن تقسيم الآيات تلقي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأن اختلاف العلماء محدود في كل سورة لا يعدو آيات قليلة اختلف أين نهايتها، ولكن ميشيل يخرج عن هذا بأمور اجتهادية من عنده ويصرح أن هذا التقسيم طرأ متأخرًا، فله الحق أن يعيد تقسيم الآيات من جديد كما يدعي.
7ـ هو غير ضليع في تفسير القرآن فيفسر القرآن بتفاسير ضعيفة إما من ابتكاره واختراعه، أو من خلال رجوعه لأضعف الأقوال، كما في تفسير لـ(كلا) في سورة العلق.
8 ـ يحاول أن يرجع الكلمات القرآنية العربية الأصول إلى أصول سريانية أو آرامي كقوله:"(الزبانية) مصطلح من أصل أجنبي (آرامي، بهلوي، سرياني) " ـ مع أن أصلها (ز، ب، ن) عربي أصيل، قال ابن فارس:"(زبن) الزاء والباء والنون أصلٌ واحدٌ يدلُّ على الدّفع. يقال ناقة زَبُون، إذا زَبَنَتْ حالبَها. والحرب تزبِنُ النّاسَ، إذا صَدَمتهم. وحربٌ زَبُون. ورجلٌ ذو زَبُّونةٍ، إذا كان مانعاً لجانبِه دَفُوعاً عن نفسه" (معجم مقاييس اللغة (3/33)، وهناك فرق بين أن نقول : اللغات السامية كـ(السريانية ، الآكادية ، والآشورية ـ وهي لغات عربية قديمة ـ والعربية الفصيحة) تشترك في الأصول اشتراكًا كثيرًا ، وبين أن يوحي أن القرآن يستعمل اصطلاحات أجنبية لم يوافقه على ادعائه أحد من علماء اللغة ولا التفسير ، مع أن كثيرًا من علماء اللغة الآن يميلون إلى أن أم اللسانيات هي اللغة العربية الفصيحة التي نزل بها القرآن كما أكد هذا لي دكتور في جامعة أمريكية متخصص في اللغات القديمة ، وهذا ليس بغريب فهي لم يتطرق لها تحريف لحفظها في الجزيرة العربية ، ولأنها أوسع اللغات السامية ، ولأنها حافظت على الإعراب الذي فقد من كثير من الساميات ؛ لذلك نجد أن المستشرقين فكوا أسرار هذه اللغات السامية من خلال معاجم اللغة العربية كلسان العرب ، ثم يأتي هؤلاء المستشرقون فيتعامون عما اكتشفوه هم من علاقة الساميات ، وعن وجود جذور واستعمالات لهذا الجذر في اللغة العربية فيقولون ما يقولونه.
وأنا أقول دراسة اللغات السامية يكشف أسرارًا كثيرة في القرآن، ويدلنا مثلًا على سر استعمال (بعل) في حق سيدنا إبراهيم، و(سيدها) مع امرأة العزيز: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف: 25]، ويدلنا على سر استعمال (اليم) دون البحر مع سيدنا موسى، وعلى سر استعمال الياء والنون في (سينين)و (إلياسين) فالقرآن يراعي مع كل قوم لغتهم واستعمالاتهم وهي تشترك مع اللغة العربية في هذه الاستعمالات، وقد استفاد الدكتور فاضل السامرائي من هذا في كشف أسرار استعمال القرآن الكريم.
9ـ تجده بعد أن يبين النظم والتناسق العجيب في القرآن ويعترف بأن بناء القرآن دقيق عميق مترابط بطريقة عجيبة ـ بدل أن يقرَّ بأنه لا يمكن أن يكون قد أتى به بشر لا سيما النبي الأمي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يعترف بأنه من عند الله تعالى ، ويدعي أنه لا يمكن أن يكون أخذ مشافهة بل هو مكتوب على الأسلوب العلمي ، يقصد بذلك أنه مفترى بعناية حيث قال في كتابه "مقارنة بين التحليل البلاغي والنقد التاريخي: "لا شك أن التوازيات تنشأ داخل نطاق الشفاهة ، وهذا أمر محل اتفاق لكنَّ نظامً معقدًا كهذا الذي قمنا به في بيان التركيب في سورة العلق ربما ينتمي إلى الكتابة العلمية أكثر من انتمائه إلى الارتجالية الشفهية ، وتطرح عالمة الأنثروبولوجيا الإنجليزية (ماري دوجلاس) في معرض تساؤلها عن السبب وراء هذه الأشكال من الكتابة المعقدة ـ فكرةَ أنَّ كتبة العصور الوسطى أرادوا بهذا إظهار مقدرتهم الأدبية ، وكانوا يتنافسون بمهارة في فن نظم النص، إنها طريقة لتمييز اللغة ذات الأسلوب الرفيع والمخصصة للمواضيع النبيلة (كالنصوص الدينية والأسطورية والوطنية..) عن تلك اللغة المستعملة في الشؤون الحياتية اليومية). (ص46)، فانظر إلى هذا الكلام الذي هو صريح في أن القرآن الكريم من صنع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عُرِض بطريقة ملتوية.
10 ـ يحاول أن يوحي بأن البلاغة التي قررها الإمام عبد القاهر وعلماء البلاغة من قبله ومن بعده هي بلاغة يونانية دخيلة على القرآن الكريم ، وأن البلاغة السامية تقتضي أن يحلل النص القرآني بطريقة التركيب البلاغي التي يتبعها هو ، ونحن نقول: أما ادعاؤه أن البلاغة التي استقرت قواعدها على يد إمام الفن عبد القاهر الجرجاني يونانية فقد تصدى كثير من العلماء لتفنيد هذا الادعاء، ويكفينا أن نقرأ كتب عبد القاهر؛ لنعرف أنه استقرأها واستخرجها من صميم لغة العرب، ومن شعرهم لا سيما من ديوان الحماسة ، ثم نقول : كل من الطريقتين لا بد منهما في تفسير القرآن ، فطريقة البلاغة التي قررها الإمام عبد القاهر وطبقها الزمخشري ومن بعده المفسرون تفسر أمورًا بلاغية كثيرة لا حصر لها في القرآن الكريم :من تقديم وتأخير ، وتأكيد وعدمه ، وبيان طرق القصر ، وغير ذلك الكثير مما لا حصر له ،مما نجده في الكشاف، وتفسير أبي السعود ، والبقاعي ، وابن عاشور، وغيرهم ، وطريقة كويبرس ويُضَمُّ لها ما فعله سعيد حوى تفسر لنا تركيب القرآن وبناءه، وهي طريقة بديعة لا يستغنى عنها ، وإذا كان القرآن الكريم جاء على الطريقة السامية كما يعبر كويبرس فقد تكلم الجرجاني في صميم الطريقة السامية .
11ـ يُقَسِّم التفاسير إلى قسمين: تفسير قديم تقليدي جامد، وتفسير أيديولوجي حديث يؤدي إلى العنف الذي نشهده اليوم، ويدعي أن التفاسير التي فسرها علماؤنا على طوال القرون لم تعُد كافية لتلبية مشاغل الإنسان المعاصر. (البلاغة السامية ـ ص7) طبع ترجمته في مركز تفسير للدراسات).
12ـ يتهم المفسرين بأنهم يفسرون القرآن آية آية بدون نظر إلى سياقها منذ بدايات التفسير وحتى يومنا هذا. (البلاغة السامية(ص25).
13ـ ينفي النسخ في القرآن، ويصف الآيات القرآنية التي بيْنَها نسخ (ناسخ ومنسوخ) بأنها آيات متناقضة تناقضًا ظاهرًا، وأن القول بالنسخ يعتمد على أدلة لا أصل لها. (البلاغة السامية (27).
14ـ هناك تعبيرات له تصدر عنه لا يرضاها مسلم، كقوله في بعض المواضع كما في سورة العلق" الآية متكونة من بيتين" وهذا كلام خطير فيه جعل القرآن كالشعر المصنوع، وفيه اتهام القرآن بالافتراء، وهكذا فأنت كلما قرأت صفحة من كتابه تجد بعض السموم قد بثت في كلامه، سواء في التعبير أو المضمون، وهذا ليس بغريب على المستشرقين.
والحاصل أن ميشيل يظهر إبداع القرآن من جانب، ويحاول أن يشكك بالثوابت ويزيل عظمة القرآن من النفوس من جانب آخر ؛ لكن هذا لا يمنع المتخصصين فقط لا عوام الناس أن يستفيدوا من إبداعاته الرائعة في كشف أسرار النظم القرآن التي نجد منها هو موجود عند علمائنا ـ رحمهم الله ـ ومنهما ما هو جديد لم يسبقه إليه أحد لا سيما أنه يسير على قوانين واضحة دقيقة، ويحاول بيان قوانين النظم القرآني وطريقة بناء السورة، وأما غير المتخصصين فينبغي أن يبقوا في منأى من كتبه المسمومة ؛لأنهم قد يتأثرون بشطحاته وضلالاته ؛وهذا ما قرره علماؤنا في كتب العقائد المخلوطة بضلالات الفلاسفة ؛ فعلى المتخصصين أن يقوموا بواجبهم في هضم هذه الطريقة ثم نقدها وأخذ الصالح منها وترك الطالح ليخْرُجَ للناس من بين فرث ودم لبنٌ خالصٌ سائغٌ للشاربين.
[2] رولان مينيه (1939 ـ 1992) راهب يسوعي فرنسي، أستاذ اللاهوت الكتابي بالجامعة الغريغورية الحبرية في روما، متخصص في الساميات وفي إنجيل لوقا، وقد طبق منهجية البلاغة السامية على إنجيل لوقا وهو له مؤلفان رئيسيان: (التحليل البلاغي طريقة جديدة لفهم الكتاب المقدس، النصوص التأسيسية والعرض المنهجي) الذي تمت إعادة صياغته وتطويره في عمل ضخم وهو:( مقدمة في البلاغة الكتابية).
[3] ينظر تلخيص هذه المصطلحات في كتاب البلاغة السامية في القرآن / ترجمة خليل محمود يماني (ص15) / طباعة مركز تفسير للدراسات القرآنية.
[4] (القارعة) مبتدأ خبره الجملة التي تأتي في الآية الثانية ، لكنه في الآية وحده ، و(نار حامية) خبر مبتدأ محذوف وهو وحده مستقل لم يذكر مبتدأه ، فمجيء عنصر مستقل هو الجامع بينهما.
[5] نظم الدرر / البقاعي (8/ 766).
[6] حينما تقع العناصر في بدايات الوحدات تسمى بالعناصر البدئية، وعندما تقع في المركز تسمى بالمركزية، وعندما تقع في النهاية تسمى النهائية.
[7] كلمات الحبك: هي العناصر الوصلية، كلمات الوصل.
[8] ما سيأتي مزجت فيه كلامي مع كلام كويبرس وعدلت بعض أقواله.
[9] تنبيه: هذا تحليل كويبرس أضفت عليه ما لم يذكره وكملته، وصححت تعبيراته إن كانت غير لائقة، وصححت الأفكار كذلك والتفاسير، فهذه نسخة معدلة لتحليله.
[10] يرجى الانتباه أنه جزء محوري وليس قسمًا محوريًا.
[11] لم يفصل ميشيل هنا كثيرًا في هذا القسم؛ لذلك معظم ما في الكلام على هذا القسم من كلامي.
[12] استطاع الباحث التوراتي نيلس ويلهلم لوند في كتابه "البناء المحوري العكسي في العهد الجديد" أن يستخلص قوانين لتنظيم البناء المحوري من خلال دراساته المطولة للنصوص، وقد حصرها في سبعة قوانين عرفت فيما بعد بـ(قوانين لوند).
[13] ونص القانون: " في الكثير من الحالات تظهر الأفكار في وسط نظام أول وفي أطراف نظام آخر يقابله، ويكون الثاني مبنيًا بالطبع ليتماشى مع الأول "، وهو ما أطلق عليه قانون انتقال الوسط نحو الأطراف". يراجع طريقة التحليل البلاغي والتفسير ص78.
[14] وبهذا يبطل كلام كويبرس الذي أراد أن يقصر فعل القراءة على العبادة، وأن ينفي الأمر للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالتبليغ بعد القراءة على جبريل؛ ليتوصل أن دين الإسلام ما جاء لينُشَر على البشرية، إنما يكتفى فيه بالعبادة الشخصية، فما أخطره من أسلوب يضع فيه السم في الدسم بأسلوب خفي.
[15] تصرفت في عبارات الجدول تصرفًا يسيرًا.
شرح طريقة
بِسْمِ اللَّـهالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وليس الارتباط والتناسق البديع بين مقدمة السورة وخاتمتها إلا صورة من لوحة فنية رائعة ترسمها سورة يوسف ـ عليه السلام ـ كما هو شأن جميع سور القرآن ، فهناك ترابط بين كل آية وآية قد بينه كثير من المفسرين كالبقاعي ، والرازي ،وأبي حيان، وابن عاشور ، وهناك ترابط بين كل مقطع ومقطع في السورة وقد اعتنى ببيانه جماعة من المفسرين كسيد قطب ، وسعيد حوى ، وابن عاشور، وهناك ترابط بين كل أجزاء السورة اعتنى ببيانه البقاعي، وسيد قطب، وهناك ترابط بين سور القرآن من سورة البقرة إلى الناس اعتنى ببيانه أبو جعفر بن الزبير، والبقاعي ،وسعيد حوى، وهناك بناء قرآني عجيب سواء في داخل السورة أو بين سور القرآن يحتاج إلى كثير من البحث ، فلم يُعطَ حقَّه بعدُ.
وقد جاء في زماننا من المستشرق ميشيل كويبرس[1] فحلل عدة سور من القرآن على طريقة تسمى بـ(التحليل البلاغي)، و(التحليل البنائي)، و(التحليل على الطريقة السامية)، و(فن تركيب الخطاب) وسميت كذلك لأنها ـ كما يقول كويبرس ـ إعادة اكتشاف لتقنيات الكتابة وطرائق النظم التي كان يستخدمها الكَتبة في العالم السامي القديم في كتابة نصوصهم.
ويعْنِي بالتحليل البلاغي: فن تركيب الخطاب وترتيبه، والتركيب الكلي للنص، والقواعد الحاكمة لطريقة بنائه، والكيفيات التي يتألف منها متنه، وهذا يختلف عن بيان الارتباط بين الآية التي تسبقها أو بيان محور السورة ومقصودها.
وقد أتى بأمور دقيقة عجيبة في نظم القرآن الكريم لا سيما في تحليله لسورة المائدة وللسور القصار ، وقد استفدت كثيرًا من طريقته في تحليل سورة الأنفال والنور فظهر بمزج طريقته مع ما ذكره علماؤنا في العلاقات والتناسقات في سور القرآن مناسبات وأسرار عجيبة، و تجلت طريقة نظم القرآن الدقيقة المحكمة، لكن ميشيل بعد أن كُشِفَت له أسرار النظم القرآني العجيب المتماسك الذي اعترف هو به بدل أن يكون ذلك داعيًا له للإسلام والاعتراف أنه من عند الله تعالى، ادعى أن مثل هذا النظم لا بد أن يكون نشأ في بيئة يهودية أو نصرانية أو يهودية سامية أو نصرانية سامية ، ولا يمكن أن يكون قد أخذ شفاهًا؛ لأنه نظم شديد التعقيد والتناسب والإبداع ، و مزَجَ ميشيل إبداعه بأفكار استشراقية مخالفة لروح الإسلام بل هادمة للإسلام من أصله، وأوغل بطريقة مُدَبَّرة لهدم الرسالة ، وادعاء افتراء القرآن ،وهدم السنة والروايات، وهدم التراث التفسيري لعلمائنا من أصله، وحرَّف القرآن بتفسيرات لا أصل لها ، وما أشبه حاله بالوليد بن المغيرة الذي قال عنه القرآن بعد أن أدرك إعجاز القرآن الكريم ثم قال عن القرآن بعد أن عجز أن يصفه بوصف يقنع الناس بافترائه : إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ، أي: سحر قديم موروث أخذ عن الأقدمين لا نظير له في زماننا ـ :{ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26 )[المدثر:11ـ 26)، فلا بد أن لا يقرأ كتبه إلا المتخصصون فيستخلصوا كنوزها ويخرجوها للناس ويتركوا ضلالها ، وقد قام ميشيل بعمل مخطط عام لسورة يوسف وسيأتي في آخر البحث بعد شرح طريقته ليفهم حق الفهم.
، وتلخيص طريقته: أن اعتناءها منصب على التركيب الكلي للنص، فتعنى بالنص كاملًا بجميع أجزائه ، وبالقواعد الحاكمة لطريقةِ وقواعدِ بناءِ النص القرآني ، والكيفياتِ التي يتركب بها النص ذاته، لا مجرد التناسب بين الآيات والسور ووجوه الارتباط بينها ، ولا تقتصر على الكلمة أو الجملة، وتنظر إلى أن السورة مركبة من قطع وفقرات تتجمع مع بعضها لتشكل الرسمة الجميلة كاملة ، كما تركب القطع مع بعضها لتكون لوحة جميلة مبدعة، وليست طريقته كطريقة التركيب الخطي ، وهذه الطريقة في أول مراحلها قريبة مما فعل سيد قطب وسعيد حوى في تقسيم السورة إلى فقرات وموضوعات.
وطريقته تنظر لتفسير القرآن بالقرآن، والربط بين سور القرآن كافة كما فعل البقاعي، وأبو جعفر بن الزبير وسعيد حوى، وتنظر للعلاقات بين مقاطع السورة وسور القرآن كافة ، مع المقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل وشروحهما كما فعل البقاعي في كل قصة قرآنية ، ولكنه أوسع مما فعله البقاعي بالاطلاع على الشروح الكثيرة التي حُقِّقَتْ والمخطوطات التي ظهرت للتوراة والإنجيل بعد البقاعي، وهي متوفرة ميسرة في الغرب لا سيما بعد تطور دراسة اللغات السامية التي يتقنها كثير من الباحثين الغربيين ، وهذه الطريقة فيها تشابه مع ما فعله المفسرون لكنها تخالف طريقتهم أنها تبحث في قواعد بناء النظم القرآني ، وتقرر أن قواعد البلاغة السامية تعتمد على مبدأ التناظر، ففي هذه البلاغة يتم بناء المعنى من خلال بنية معقدة من التوازيات الشكلية بين العناصر النصية المتناظرة(كلمات أو جمل) وليس من خلال تطور خطي مستمر .
وقد تم التنظير والتقعيد لهذه القواعد بشكل واضح من قِبَل رولان مينيه[2] في كتاب (رسالة في البلاغة الكتابية)، فاستفاد منها ميشيل في تطبيقها على القرآن الكريم.
وهذه الطريقة تقسم السورة تصاعديًا إلى:
مفصل، ثم فرع، ثم قسم، ثم جزء، ثم مقطع (سورة قصيرة كسورة العلق)، ثم سلسلة كسورة الحاقة، ثم شعبة، ثم كتاب (هي في القرآن الكريم السورة الطويلة كالمائدة)، وتقسم هذه المستويات إلى قسمين:
- المستويات الأولية الصغيرة:
2 ـ ثم فرع وهو يتكون من مفصل أو مفصلين أو ثلاثة لا أكثر.
3ـ قسم يتكون من فروع، كذلك لا يزيد على ثلاثة.
4ـ جزء ويتكون من أقسام، ولا يزيد على ثلاثة.
- المستويات العليا من النظم والتي تمثل أجزاء لها استقلال:
6ـ سلسلة تتكون من مقاطع، وهي مستوى أعلى من المقطع ويشمل أكثر من مقطع كسورة الحاقة تعتبر كلها سلسلة.
7ـ شعبة مثل الآيات (1ـ 71) في سورة المائدة شعبة، والآيات (72 ـ 120) شعبة ثانية، ومن مجموعهما تتكون سورة المائدة.
8 ـ الكتاب (هي في القرآن الكريم السورة الطويلة كسورة المائدة تتكون شعب) وهي مستوى أعلى من السلسلة وتحوي عددًا من السلاسل.
فالمفاصل تكوِّن الفروع، والأقسام تكوِّن الأجزاء، والمقاطع تكوِّن السلاسل، والسلاسل تكون الشعب، والشعب تكون الكتاب.
يقسم الآية أقسامًا يرتبها فوق بعضها، فيضع كل جملة (مفصل) وحده وتحته المفصل الآخر إلى ثلاثة، وهذه المفاصل تشكل الفرع، ثم يضع تحته الفرع الثاني كذلك، وهذه الفروع تكوِّن الأقسام، وبعد النظر والتدقيق في الفروع والعلاقات بينها، يعيد الكتابة للأقسام وينظر فيما بين الأقسام، ثم يجمع الأقسام لتشكيل الأجزاء وينظر في العلاقات بينها، ثم يعيد كتابة الأجزاء وينظر في العلاقة بينها لتظهر المناسبات بينها وهكذا.
ولا بد أن نعرف أنه في المستوى الأدنى يمكن أن يحتوي الفرع على مفصلين أو ثلاثة مفاصل لا أكثر، وكذلك في: الأفرع، والأقسام، والأجزاء، ولا تسري هذه القاعدة في المستويات الكبرى ابتداء من المقطع وإن كثرت مراعاتها في القرآن الكريم.
وفي المستوى الأعلى يتألف القسم من فرعين أو ثلاثة أفرع مرتبة حسب أحد الأشكال النظمية الثلاثة التي ستذكر، وهكذا دواليك في المستويات المرتبة تصاعديًا: الجزء ثم المقطع ثم السلسلة ثم الشعبة ثم الكتاب (أو السورة الطويلة).
وقد تحتوي النصوص الطويلة كالسور الطوال عشرة مستويات، والقرآن كله مبني بشكل متشابك مثل البناء الهندسي الكسيري.
وهو يقرر أن الطريقة البلاغية في اللغة السامية جميعها تستند في بلاغتها وبنائها على مفاصل متوازية مرتبطة فيما بينها بصلة ترادف أو تضاد أو تكامل، ويوجد فيها مبدأ الثنائية والتناظر حيث يتخذ التناظر في النص ثلاثة أشكال أو صور نظمية:
- الشكل الأول: (النظم المتوازي)، شكل التوازي: عندما ترتب العناصر المترابطة بالترتيب نفسه (أب ج// أَبَ جَ) وفيه ثلاثة أنواع :
- التوازي الترادفي :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [رحيم بالعالمين]
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- المعكوس:
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) [القارعة: 6 ـ 9]
- التكاملي: وهو النظم المتوازي التكاملي، عندما يكمل الطرف الثاني من التناظر معنى الطرف الأول:
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم [الفاتحة:7،6]
2) الشكل الثاني:(النظم المعكوس) أو (التركيب المرآتي) عندما ترتب العناصر ترتيبًا معكوسًا:
(أ، ب، ج/جَ، بَ، أَ) وهو ما يسمى المقابلة العكسية على مستوى الجملة.
ومثاله سورة القارعة :
| [أ] القارعة(1) [ب] مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) [ج] يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) |
| [جَ] فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) [احتباك] [أمه جنة عالية] وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) [وهو في عيشة ساخطة] [بَ] وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) [أَ] نَارٌ حَامِيَةٌ (11) |
2ـ أما [ب]،[بَ] فتظهر فيه الأسئلة المتطابقة جزئيًا: {مَا الْقَارِعَةُ (2)}، { وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3)} ـ { وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10)}.
3 ـ أما الآيات المتجاورة في وسط السورة (4ـ 5[ج]/ [جَ] 6ـ 9) فتكون فرعين اثنين متوازيين تمامًا ، فيمكننا عرض السورة بالشكل الآتي: أب ج/ جَ بَ أَ.
ويلاحظ أن القسم الأول من السورة يصف يوم القيامة وما يحدث فيه من اضطرابات كونية ، ويصف القسم الثاني الجزاء والدينونة .
3) الشكل الثالث: النظم المحوري: عندما يتوسط عنصر محوري طرفي التوازي، يتم فيه إدخال عنصر مركزي بين مُنحَدري التركب المرآتي (أب ج/×/جَ بَ أَ)، ويسمى التركيب الدائري، وقد نجد هذه التراكيب في مستويات النظم المختلفة (الفروع، المقاطع الخ).
وفي القرآن الكريم الشكل النظمي الأكثر ورودًا على المستويات النصية العليا، هو (النظم المحوري)، حيث يشير مركز هذه النُّظُم عن أهمية خاصة، وهو غالبًا يكون مفتاح التأويل لمجموع النص الذي يحتل مركزه، وهو غالبًا يكون على شكل: سؤال، أو حكم، أو شاهد، أو مثل: مثل شيء يدعو القارئ إلى التفكر واتخاذ موقف: كالترغيب والترهيب، ووصف الجنة والنار ونحو ذلك.
وتوجد صور النظم الثلاثة السابقة في مستويات نصية مختلفة: على مستوى الآيات، أو مفصل من آية، ثم على مستوى مجموعة مكونة من مفصلين أوثلاثة وهكذا دواليك حتى النص بأكمله، وذلك من خلال مجموعة من التداخلات.
وفي كل مستوى يمكن ملاحظة التناظرات من خلال المؤشرات التي يعطيها النظم، فالعناصر قد تتناظر في بداية[6] أو نهاية أو وسط الوحدات النصية المتناظرة، أو في نهاية وحدة نصية وبداية الوحدة اللاحقة، للربط بينهما كما هو الحال فيما يطلق عليه " كلمات الحبك"[7] ، أو في بداية ونهاية الوحدة لتحديدها.
تتنوع مؤشرات التناظر فقد تكون مجرد: تكرار، أو ترادف، أو تقابل، أو تماثل صوتي، أو جناس تام، أو جناس ناقص، أو انتماء كلمتين لنفس الحقل الدلالي (الشمس، القمر، الأرض، البحر..)، وقد تكون صيغة تحويه مماثلة مثل فعلين بصيغة الأمر، أو جملتين بنفس البنية التركيبية.
عندما تتناسب معظم عناصر التناظر نتحدث عن تناظر تام إلا أنه في معظم الأحيان لا تتناظر سوى بضعة عناصر (تناظر جزئي).
تقع مؤشرات التناظر الجزئي: إما في بداية الوحدات النصية المتناظرة (وتسمى عناصر بدئية) أو في نهايتها (عناصر نهائية) أو في وسطها (عناصر مركزية) أو في أول الوحدة المعنية وفي نهايتاه فتحد طرفيها (عناصر طرفية وهي توافق التضمين الكلاسيكي) أو في نهاية وحدة وبداية الوحدة اللاحقة للربط بينهما (عناصر وصلية توافق (كلمة الوصل) أو (كلمة الحبك).
والعجيب أن سورة الفاتحة تميزت بأن جميع مستويات النص تتسم بوجود أشكال النظم الثلاثة نفسها:[8] التوازي، والتناظر المعكوس، والبناء المحوري.
ويتميز نظم سورة الفاتحة بالتوازن الكامل إذ يتألف من قسمين متناظرين يتكون كل منهما من فرعين ، ويتألف كل فرع من مفصلين ، ويرتبط القسمان بواسطة قسم مركزي صغير مكون من فرع واحد.
| الفرع الأول | [أ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) [ب] الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) [مضاف إليه] [أ] الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) [ب] مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) [مضاف إليه] | [القسم الأول] يناظر القسم الأخير يتكون من فرعين، ويتألف كل فرع من مفصلين |
| الفرع الثاني |
| [أ] إِيَّاكَ نَعْبُدُ [ب] وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) | القسم الثاني المركزي ويتألف من فرع واحد بمفصلين |
| الفرع الأول | [أ] اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) [ب] صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [ب] غَيْرِ [×طريق معوجة] الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [ج] وَلَا [×طريق معوجة] الضَّالِّينَ (7) | القسم الثالث: يناظر القسم الأول، ويتكون من فرعين، ويتألف كل فرع من مفصلين |
| الفرع الثاني |
[ب] الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
فكل من (بسم الله) (الحمد لله ) فيه لفظ الجلالة، والأول استعانة وتبرك باسم ، والثاني حمد له ، وكذلك هناك توافق بين {الرحمن} المنعم ، {الرب} المربي ، وكذلك مناسبة بين {الرحيم} ، و{العالمين} فالله سبحانه رحيم بالعالمين.
2 ـ ووجود تواز بين المفصلين (3)، (4)،
[أ] الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)
[ب] مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) [مضاف إليه]
هناك تقابل بين (الرحمن) و(مالك) فكلاهما من أوصافه سبحانه، والأول فيه الترغيب والثاني فيه الترهيب، وكلاهما وصف للفظ الجلالة .
وهناك تقابل بين {الرحيم}،{يوم الدين} فهو سبحانه رحيم في كل وقت وقد ادخر سبحانه تسعة وتسعين جزءًا من الرحمة ليوم القيامة.
3ـ أقول ليس التوازي بين المفاصل السابقة فقط بل يوجد تواز آخر فيما بين المفصلين الأولين من الفرعين (3،1) وهما متطابقان جزئيًا:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)
- ـ ويوجد توازٍ بين المفصلين الثانيين (2)،(4) وبداخلهما لفظان مترادفان هما (رب)،(مالك)، وفي الأول الترغيب وفي الثاني الترهيب ، والأول يركز على الدنيا والثاني على الآخرة ، وكلاهما نعت لله وهما مضافان فـ(رب) مضاف ، و(مالك) مضاف، وكل من منهما ختم بمضاف إليه ،(العالمين)،(يوم الدين).
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)
أما الفرعان المتوازيان (6ـ 7أ/7ب ـ 7ج) في القسم الثالث فيوجد بينهما تضادّ:
الفرع الأول: [أ] اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)
[ب] صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [أ]
الفرع الثاني : [أ] غَيْرِ [×طريق معوجة] الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [ب]
[ب] وَلَا [×طريق معوجة] الضَّالِّينَ (7) [ج]
: ففي الفرع الأول نجد أن المؤمن يسأل الله تعالى الثبات على الصراط المستقيم والزيادة من الهداية ، وأما الفرع الثاني فهو يسأله ألا يهديه صراط المغضوب عليهم ولا الضالين .
ونلاحظ صلة التكامل بين مفصلي الفرع الأول: حيث يشرح المفصل الثاني معنى عبارة (الصراط المستقيم) التي أعلن عنها في المفصل الأول ، بـأنه {صراط الذين أنعمت عليهم}.
أما مفصلا الفرع الثاني فيتوافقان بأن كلًا منهما بدئ بحرف نفي {غير،لا} ، وهناك توافق بين المغضوب عليهم والضالين بأن كلًا خارج عن الصراط المستقيم معذب في الآخرة ، وهناك اكتفاء فيفهم من الصراط المستقيم أن المغضوب عليهم والضالين على الطريق المعوجة غير الموصولة.
يلحظ عنصر الوصل بين الفرعين وهو (عليهم) فقد تكررت في الفرعين ، وهناك تقابل بين (أنعمت) وبين (المغضوب ، الضالين)، وهناك دقة ومناسبة وتكامل بين استعمال الماضي {أنعمت} في الأول، واسم المفعول في الثاني {المغضوب}، واسم الفاعل في الثالث{الضالين}.
أما القسم المركزي (5أ ـ ب) فلا يتضمن سوى فرع واحد متوازٍ ومترادف:
[أ] إِيَّاكَ نَعْبُدُ
[ب] وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)
فالمفصلان كل منهما بدئ بـ{إياك} ،ويتبعهما فعلان ينتميان لمجال دلالي واحد {نعبد}، {نستعين}فكلاهما خضوع وتذلل وتوحيد له سبحانه ، وكما هي العادة في البلاغة السامية في البنى المحورية يقوم القسم المركزي بدور محور الانطباق بين القسمين الآخرين اللذين يربطهما:
فالمفصل الأول {نعبد} يشير إلى القسم الأول وهو بالكامل عبارة عن تعبد إلى الله تعالى من خلال بعض الأسماء الحسنى ، وأيضًا هو نتيجة للقسم الأول ؛ لأن القسم الأول فيه الثناء على المستحق للحمد؛ لأنه رب العالمين رحمن رحيم ، فهو المستحق لأن يثنى عليه وحده ، فلما كان كذلك كان المستحق لأن يعبد وحده.
والقسم الثاني: {إياك نستعين} يعلن عن القسم الثالث ، كأنه لما قال إياك نستعين قيل: ما أهم شيء تستعينون بالله تعالى عليه أجيب: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)}.
وخلاصة الفاتحة ومقصودها في مركزها: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)}، جاء في مقاصد السور لعلي هاني:" مقصود الفاتحة جمع خلاصة مقاصد القرآن وتلخيصها، وهي ترجع إلى: تحقيق استحقاق الله تعالى لكمال التوجه له بالعبودية والاستعانة به وحده".
وهذا يعطينا مفتاحًا عظيمًا في تحديد مقاصد السور من خلال الأقسام المحورية ، وقد نبه كويبرس على أهمية الأقسام المركزية.
وبناء على ما تقدم يمكننا القول بأنه يوجد تكامل بين القسمين الطرفيين (القسم الأول، والثالث) لسورة الفاتحة ، وأن القسم المركزي الموجز يشير إلى هذا التكامل ويقوم بدور الربط بين القسمين ، وهو خلاصة السورة ومقصودها.
وبهذا ظهر أن الفاتحة تتسم بوجود أشكال النظم الثلاثة نفسها التوازي، والتناظر المعكوس، والبناء المحوري.
الطريقة العملية للتحليل البلاغي:
عندما تريد أن تحلل نصًا بهذه الطريقة فلا بد أن تحدد موضوعات كل جزء كما يفعل سيد قطب، فهذه الفقرة مثلًا تتحدث عن تعذيب الأقوام فهي جزء مستقل، وهذه الفقرة تتحدث عن الجزاء في الآخرة فهي جزء مستقل، وهذه الفقرة تتحدث عن صدق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهي جزء مستقل، ثم نقسمها إلى مفاصل (كل سطر يعتبر مفصلًا)، ثم إلى فروع، ثم إلى أقسام، ثم أجزاء، ثم مقاطع، ثم إلى سلاسل التي هي كالسور المتوسطة كسورة الحاقة تعتبر كلها سلسلة.
والمفصل عبارة عن جملة فعلية قصيرة أو جملة اسمية وأحيانًا تتكون من كلمة واحدة مثل (الحاقة)، وأحيانًا يفرض المعنى أو النحو أو الإيقاع اعتبار فعلين مفصلًا واحدًا وهذا كثير، وكل مفصل يوضع في سطر، وعندما تحتوي الآية الواحدة على أكثر من مفصل واحد يسبق كل مفصل حرف [أ]، أو [ب] أو [ج] كما سيأتي في الأمثلة الآتية، وتضع رقم الآية على اليمين فمثلًا لو قسمنا الآية السابعة من السورة إلى ثلاثة مفاصل نكتبها هكذا:
(7) [أ] سخرها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا
[ب] فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى
[ج] كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
وهذه المفاصل الثلاثة تشكل الفرع ... ثم بعد ترتيبها، نأتي بمجموعة مثلها تجعل فرعًا ولا يزاد على ثلاثة أفرع، ولا بد أن ينظر في توافق، أوتضاد، أو تجانس أو، نحو ذلك، وتقسم على حسبها المفاصل والأفرع، ويبقى التقسيم يتأرجح في البداية حتى تصل لصورة التناسب التام، نلون المتماثلات أو المتضادات أو المتجانسات.. الخ بلون يميزه كـ (ثمود، عاد، فرعون)،(أما ، فأما ) أو تضع إشارات للتناسب بدل الألوان مثل (÷=+- ) أو نحو ذلك، ولا دلالة لها إلا الإشارة إلى التناسبات بين المفاصل .
تترك مساحة فارغة ثم رقم المفصل، ويتم خلال الكتابة محاذاة العناصر المتناسبة محاذاة رأسية، ويتم إبراز التناسب بإعطاء هذه العناصر لونًا أو نمطًا خاصًا مثل (غامق، مسطر، مائل)، ثم لا بد أن تمييز الفروع، إذا توازى مفصل مع مفصل يرمز له على اليمين بـ(ب، بَ) مثلًا فالأول يوضع عنده (ب) والثاني(بَ).
وكل فرع لا بد ألا يحوي أكثر من ثلاثة مفاصل، لكن عند كتابتها قد نضع عدة أفرع مع بعضها ثم نضع خطًا، ومجموع هذه الأفرع تكون القسم، ومجموع الأقسام تكون جزءًا.
ولا بد وأنت تحلل من مراعاة معاني النصوص مع مراعاة الأمور اللفظية، ولا بد أن ينظر ويبحث في الروابط التي تربط الأفرع ببعضها، ثم يعاد كتابتها للنظر في مستوى القسم ثم الجزء، فكل جزء فيه أقسام مثلًا.
والذي سأعرضه من آيات سورة الحاقة عبارة عن جزء ، وهذا الجزء يتكون من ثلاثة أقسام كل قسم فصل عن الآخر بسطر، وكل جملة مرقمة وموضوعة في سطر مستقل مثل (الحاقة) هي مفصل ، وكل ثلاثة مفاصل فأقل عبارة عن فرع ، ولا يتكون الفرع من أكثر من ثلاثة مفاصل، ففي الآية السابعة ليس {فهل ترى لهم } معدودةً مع الفرع السابق :{سخرها عليهم ،فترى القوم ، كأنهم أعجاز}؛ لأنها ثلاثة مفاصل ولا يزاد على ثلاثة مفاصل ، ثم علينا أن ننتبه أننا إذا أخذنا جزءًا آخر من السورة نفصله بسطر غليظ مثلًا عن هذا الجزء، ثم ننظر في التناسبات بين الوحدات الصغيرة ثم الأكبر ثم الأكبر، ونرى على أي طريقة وردت ، فعندنا انسجامات داخلية وخارجية ثم نكتب المقاطع كل مقطع في جدول ونرى العلاقات بين المقاطع، وفي النهاية تظهر السورة كسلسلة مكونة من مقطعين مثلًا أو ثلاثة ، وكل مقطع يقسم إلى أجزاء توضع بشكل متميز، ثم ينظر من أي شكل من الأشكال الثلاثة السابقة رتبت السورة هل هي من النظم المحوري أو غيره .
كل ما سأذكره هنا عبارة عن جزء يتكون من أقسام:
القسم الأول:
- [أ]ــــ الحاقة كل سطر مفصل: فـ(الحاقة) مفصل، و(ما الحاقة مفصل) ومجموعهما يكون فرعًا
- [ب]+ مَا الْحَاقَّةُ
- ــــ [أ]وَمَا أَدْرَاكَ مجموع [أ]، [ب] يكونان الفرع الثاني، و(الحاقة، ما الحاقة) هي الفرع الأول.
.................................................. ...
القسم الثاني:
- [أ]ــ كذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
- [ب] + فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
- [ج] +وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
- ــــ [أ] سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا
+[ج] كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
..................
(8) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
.........................................
*****
وزيادة في التوضيح إليك نموذجًا كاملًا وهو تحليل سورة العلق[9]:
أ ـ (1) اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
ب = [ب] الَّذِي خَلَقَ
ج + (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
أَ ـ (3) اقْرَأْ و َرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
بَ = (4) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
جَ + (5) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
ف(أ) مفصل، و(ب) مفصل، و(ج) مفصل، وهذه المفاصل الثلاثة تكون فرعًا، فهو فرع ثلاثي المفاصل.
وكل من (أَ)، (بَ) مفصل، و(جَ) مفصل، وهذه المفاصل الثلاثة تكون فرعًا.
وهذان الفرعان يشكلان قسمًا، فجميع ما تراه من سورة العلق هنا قسم وما سيذكر بعده قسم آخر، تلاحظ أن المفاصل كونت فرعًا، والفرعين كونا قسمًا.
ويلاحظ أن ترتيب الفرعين: أ، ب، ج //جَ، بَ، أَ، فهو من الشكل الثاني:النظم المعكوس.
يلاحظ أن (خلق، خلق) تكررت في الفرع الأول، و(علم، علم) تكررت في الفرع الثاني، فهذه الكلمات كل منها ارتباط بين أجزاء الفرع من خلال تكرار عنصر وصل (كلمة ربط: خلق، علم).
يلاحظ التقابل بين (ربك) في الفرع الأول، و(ربك) في الفرع الثاني.
وكذلك التقابل بين (الإنسان) في الفرع الأول، و(ربك) في الفرع الثاني.
وكل من الفرعين فيه التقابل بين عظمة الله تعالى ومنته وكرمه، وضعف الإنسان وتحويله من الضعف والخلق المهين إلى الخلق العظيم وتعليمه ما لم يعلم.
والعناصر الطرفية للمفاصل (خلق، علق)، (علَّم، يعلم) بينها جناس.
ويلاحظ بين خلق ـ الإنسان من علق.
علم ـ الإنسان ما لم يعلم.
الجزء المركزي [10]
كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6)
أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)
إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8)
وهو مؤلف من فرع واحد وهذا الفرع فيه مفاصل ثلاثة على صورة (أ، أَ، ب).
يلاحظ أن المفصلين الأولين فيهما ذكر جريمة هذا الإنسان، والمفصل الأول نتيجة للثاني، فرؤية نفسها مستغنيًا سبب للطغيان.
وفي المفصل الثالث تهديده بأنه سيرجع إلى ربه المنعم عليه لا إلى غيره وهناك سيجد عقوبته على هذا.
يبدأ المفصلان الطرفيان بالحرف (إنَّ).
والمفصلان الأوليان بيان خطأ الإنسان بشيء لا ينبغي أن يفعله (طابع الحكمة الأخلاقية)، والمفصل الأخير تهديدهم بالعذاب الأخروي (أمور أخروية).
ولا بد أن يعلم أن غالب سور القرآن سلكت الطريقة المحورية المرآتي (أب ج/×/جَ بَ أَ)، ويسمى التركيب الدائري، وفي سورة العلق القسم المحوري (×) هو هذا الفرع المكون من المفاصل الثلاثة، وتقدم معنا أن الأقسام المحورية تتكون غالبًا من سؤال، أو جملة خلقية، أو أخروية ، أو ترغيب وترهيب، ويقابل فيها بين الإيمان والكفر والخير والشر ، والنجاة والهلاك ، وهكذا جاء المركز هنا.
وزيادة في التوضيح لو نظرنا لسورة البروج فالمركز فيها هو: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11)} [البروج:(10 ـ 11)].
*******
القسم الأول: (الآيات:9ـ 13).
- ـ ـ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا
- ـ ـ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11)
ج ـ [أ] أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ
=[ب] وَتَوَلَّى (13)
يقول علي هاني: "الذي ينهى هو أبو جهل، والعبد هو النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالله سبحانه يُعَجِّبُ من هذا الناهي للعبد لله، فهو عبد لله لا لك يا أبا جهل فكيف تنهى عبده عبادته الصلاة له، ثم يعَجِّب ويقول سبحانه: أرأيت إن كان هذا العبد راسخًا في الهدى متمكنًا منه أشد التمكن، وليس هذا فقط بل هو أعلى من ذلك هو آمر بالتقوى، أرأيت إن كان الناهي مكذبًا ومتوليًا.
هذا القسم مركب من فروع ثلاثة (أ، ب، ج) وكل فرع مركب من مفصلين (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا).
) مفصل، {إِذَا صَلَّى (10)} مفصل وهما يكوِّنان فرعًا، وهكذا الثاني والثالث فهي فروع ثلاثة ، وهذه الثلاثة تكون قسمًا.
كل فرع يبدأ بالفعل المسبوق باستفهام {أَرَأَيْتَ}.
الفروع (أ) (ج)تتكلم عن أبي جهل الذي نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتذكر صفاته فهو ناهٍ للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومكذب ومتولٍ، وفي الفرع الوسطي _(ج) فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد مصلٍّ، وعلى الهدى وآمر بالتقوى.
فهذه الفروع على الصورة (أ × أَ).
وهناك مناسبة واضحة في الفرع الأول(أ) بين (عبدًا، صلى) فالعبودية تقتضي الصلاة.
وهناك مناسبة في الفرع (ب) بين (إن كان على الهدى) أو (أمر بالتقوى) فالأول يذكر اتصافه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهدى الراسخ المتمكن ،والثاني يذكر الدعوة لهذا الهدى، وبينهما احتباك: حذف من الأول لدلالة الثاني، وحذف من الثاني لدلالة الأول، كأنه قيل: إن كان على الهدى والتقوى أو أمر بالهدى والتقوى.
ثم إذا جمعنا الفرع (أ)، (ب) تحصل عندنا صفات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشكل كامل متناسب: العبودية {عبدًا} ـ وهي تقتضي الصلاة {إذا صلى} ـ والتمكن من الهداية{على الهدى} صحة الفكر والمنهج وسلامته [حذف أنه متقٍ] لدلالة ما بعده ـ ثم هو آمر بهذا الهدى والتقوى {أو أمر بالتقوى}.
وفي صفات أبي جهل ذكر: نهيه للنبي ـ عن صلاته ـ تكذيبه ـ توليه.
يلاحظ التماثل بين الفرع (ب) (ج) باستعمال حرف الشرط (إنْ).[11]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
القسم المركزي (المحوري): أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
القسم الثالث (الآيات: (15ـ 19):
1ـ [أ] كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ (15)
ـ [ب] لنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
[ج]ـ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16)
2= [أ] فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17)
= [ب] سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ
3+[أ] كَلَّا لَا تُطِعْهُ
+[ب] وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ(19)[×]
هذا القسم مركب من ثلاثة أفرع (1، 2، 3)، والفرع الأول (1) من ثلاثة مفاصل (أ، ب، ج).
ويتكون كل من الفرع (2)، (3) من مفصلين.
ويستمر في هذا القسم الثاني الذم لأبي جهل لكن على شكل تهديد بالعقاب.
الفرع الطرفي (1) يبدأ بحرف الردع والزجر مؤكدًا ما ورد من الردع والزجر في القسم المركزي: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) }.
الفرع الأول فيه كلمات الحبك أو الوصل تتكرر (بالناصية، ناصية) وكذلك الفرع (2) فيه كلمات الوصل (فليدع، سندع)، والفرع (1) و(3) بينهما كلمة وصلية (كلا، كلا).
وكذلك الفرع الثاني (ناديه) تتقابل مع (الزبانية) فجماعة أبي جهل الذين يدافعون عنه هم ناديه ويحمونه من عذابه، وأما أنصار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجند الله تعالى الذين سيهلكون أهل النادي مع أبي جهل هم (الزبانية) ملائكة العذاب.
الفرع الأخير (3) يمثل توازيًا تضاديًا (لا تطعه) في ترك السجود والعبادة ولا تتوقف عن عبادتك يقابلها (اسجد واقترب). (أي صلِّ).
والفرع الأول فيه كلمتان بينهما توافق بين (كاذبة، خاطئة)، وفيه مع الفرع الثالث اكتفاء فحذف في الفرع الثالث ما يقابله وهي الناصية الصادقة الطائعة كأنه قيل: اسجد (على ناصيتك الصادقة الطائعة) واقترب.
القسم المحوري: أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى
هذا القسم المركزي ليس به إلا مفصل فقط، ومن اللافت للنظر أنه عبارة عن سؤال، والمحور في البلاغة السامية غالبًا ما يكون سؤالًا يحمل على التفكير واتخاذ موقف، وكذلك يظهر في قلب الخطاب الذي وجهه سيدنا يوسف عليه السلام في السجن لصاحبيه: {أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ }[يوسف: 39]، وتحمل المراكز غالبًا في القرآن الكريم الطابع الأخروي ، كما هنا المركز فيه تهديده بأن الله تعالى يراه وسيجازيه على فعله .
قد يقول قائل: لماذا لم تختر {أرأيت} مركزًا فهي استفهام، فالجواب، أنها اتفقت أنها بصيغة الماضي وهذا انفرد بأنه بصيغة المضارع، وأيضًا {أرأيت}تعجيب من حاله، بينما هذا المركز يتكلم على تهديده وحكم الله تعالى فيه .
الآن تأتي خطوة تجميع الأقسام لتشكل جزءاً:
وهذا القسم مكون من فرعين، وفرع مركزي (محوري):
القسم الأول:
- [أ] ـ ـ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا [الفرع الأول]
2) [أ] ـ ـ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) [الفرع الثاني]
[ب] = أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12)
3) ـ [أ] أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ [الفرع الثالث]
=[ب] وَتَوَلَّى (13)
القسم الثاني: المركزي (المحوري): أ َلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)
1القسم الثالث:
ـ [أ] كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ (15) [الفرع الأول]
ـ [ب] لنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
[ج]ـ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16)
2= [أ] فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) [الفرع الثاني]
= [ب] سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18)
3+[أ] كَلَّا لَا تُطِعْهُ [الفرع الثالث]
+[ب] وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ(19)[×]
ينظر العلاقة بين القسم الأول والثالث:
فالمفصل الأول في الفرع الأول في القسم الأول يضاد المفصل الأول في الفرع الثالث في القسم الثالث: في الفرع الأول { الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا }(10) ـ والفرع الثالث { لَا تُطِعْهُ }(19 ب).
والمفصل الثاني في القسم الأول والثالث في القسم الثالث مترادفة: { إِذَا صَلَّى}ـ {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}(19).
ونجد الفرع الأخير في القسم الثاني ختمت به السورة بمفصليه(أ، ب) { لَا تُطِعْهُ ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}
يأخذ القسم الثاني المركزي كما هو الحال عادة بالنسبة لمراكز البنى المحورية ـ دور القنطرة والمعْبر .
الفرع المركزي (المحوري): أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)
فهو متصل بالقسم الأول عن طريق صيغة الاستفهام البادئة بحرف الاستفهام (أ) ): أ َلَمْ ـ وهذا الحرف يشبه الحرف الموجود في ـ أَرَأَيْتَ.
وأيضًا بواسطة الفعل {يَرَى} ـ المتفق مع {أَرَأَيْتَ}.
ثم هذا المحور المركزي {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)} يُذَكِّر بحكم الله تعالى الذي سيظهر بعد ذلك في صورة عقوبة في القسم الثالث في صورة عقوبة؛ لأن من لوازم رؤية الله تعالى له أن يجازيه على أفعاله.
ثم إذا نظرنا في الأقسام الثلاثة فيها تدرج في المحاكمة: فالقسم الأول فيه لائحة الاتهام ـ والقسم الثاني المركزي: فيه اطلاع الله تعالى عليه وعلمه بأفعاله، والقسم الثالث: التهديد بالعقوبة في الفرع الأول والثاني من القسم الثالث:
ـ [أ] كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ (15) [الفرع الأول]
ـ [ب] لنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
[ج]ـ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16)
2= [أ] فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) [الفرع الثاني]
= [ب] سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18)
وإليك مجمل السورة في جدول بتجميع الأجزاء: وأُذَكِّر أن المفاصل كونت الفروع، والفروع كونت الأقسام ، والأقسام كونت الأجزاء .
| ـ[أ] اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ (الجزء الأول الطرفي) = [ب] الَّذِي خَلَقَ (1) +خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) ـ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) = الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) +عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) |
| ـ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) الجزء المركزي (القنطرة) ـ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) ـ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) |
| ـ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا الجزء الثالث (الطرفي) =إِذَا صَلَّى (10) ـ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) = أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) ـ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ =وَتَوَلَّى (13) ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ [أ]كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ـ [ب] لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) ـ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) = فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) =سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) +[أ] كَلَّا لَا تُطِعْهُ +[ب] وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19) |
وهذا المركز له علاقة بما يأتي ، فأول مثال يدخل في هذا الطغيان أبو جهل الذي رأى نفسه استغنى ونهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن عبادة ربه.
وكذلك فإن لفظ "الإنسان"، و"ربك" يؤطران الفرع المركزي ثلاثي المفاصل في الآيات (6 ـ 8) { إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6)،{ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8)}.
كما أنهما يؤطران الفرعين ثلاثيي المفاصل المكونين للجزء الأول (2أ ـ 3، 3ـ 5)،{ اقْرَأْ بِاسْمِ {رَبِّكَ {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) } ،{ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3)}، { عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)}، ويلاحظ أنه بترتيب عكسي في المركز ، فقد كانت الترتيب في الجزء الأول: ربك ـ الإنسان ـ ربك ـ الإنسان ، وفي المركز : الإنسان ـ ربك ، وهذا مناسب للمعنى؛ لأن الله تعالى أنعم على الإنسان هذه النعم، فيُسأل هل شكر ربه فقال {كلا} عكَّس ولم يشكر، وحتى يكون من رد العجز على الصدر فبدأ باسم الرب المنعم ـ وختم باسمه ؛ وليكون قد بدأ ببداية إيجاد الله تعالى الإنسان وختم بعوده إليه: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} وختم { ـ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8)} فلله در شأن التنزيل ما أعظمه.
وإذا جمعت على حسب ترتيبها كان له ترتيب عجيب : فـ{رآه} ذكرَتْ غروره وأنه يرى نفسه مستغنيًا عن دين الله تعالى ـ ونتيجة لذلك تكبر ونهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صلاته ـ فجاء التعجيب المتكرر ثلاث مرات {أرأيت} ـ ثم جاء التهديد برؤية الله تعالى له على هذه الحال القبيحة التي تقتضي تعذيبه.
ويلاحظ أن مادة الرؤية تكررت في مركز الجزء ومركز القسم ففي مركز الجزء (6 ـ 8){ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)} وفي مركز القسم { ألم يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)}،فالإنسان الذي يطغى يرى نفسه استغنى والله سبحانه يراه وسيجازيه.
تكرر حرف الردع والزجر (كلا) فذكر في المركز {ـ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) } للردع والزجر للإنسان الذي لا يشكر نعم الله تعالى بالخلق العام وبخلق الإنسان وتعليمه وتحويله من علقة إلى عالم يكتب بالقلم ويعلمه ما لم يعلم.
ثم كررت (كلا) مرتين في الجزء الثالث (15أو19أ) {أ]كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ}،{ [أ] كَلَّا لَا تُطِعْهُ }، و(كلا) الأولى التي أكدت بالثانية جاءت كذلك للإنكار عليه بعلم الله تعالى له ثم هو لا ينتهي ولا يرعوي رغم رؤية الله تعالى له .
ثم هناك مناسبة بين خاتمة المركز، والمركز في القسم ، وخاتمة السورة (خاتمة الجزء الثالث):
{إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8)} تناسب { أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)}، وتناسب { َاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)}فالله تعالى هدد هذا الطاغية بأنه سيرجع إلى ربه الذي خلقه وحوَّله من علقة إلى إنسان ثم يجازيه ، وهدده بأنه يعلم أفعاله ، وأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يطْمَئنَّ بأن الله تعالى معه، وأن يسجد ولا يطيع هذا الطاغية فالله قادر عليه.
وهذا ما يجعلنا أمام تطبيق للقانون الثالث لـ(لوند) (الباحث التوراتي)[12] الذي وضع نظرية لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي والذي ينص على وجود علاقة بين المركز وأطراف النظم نفسه[13]
تربط الجزءين الطرفيين، وهي من سمات البلاغة السامية فنهاية الجزء الأول: { عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)}، تتوافق بالفعل مع مركز الجزء الثالث الطرفي: { أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)}بنفس الصيغة ، وهذا هو "قانون الانتقال من المركز إلى الأطراف" ، والذي ينص على وجود ترابط في الغالب بين مركز نظم بلاغي وأطراف نظم آخر، مما يشير إلى أن النظمين يشكلان جزءًا من كلٍّ على مستوى أعلى (وهو هنا السورة كلها ):إنه "القانون الرابع عند لوند"، والكثير الشيوع في القرآن الكريم.
في السورة رد العجز على الصدر وهو رد آخر السورة على أوله: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)} أي: اجتهد في بلوغ درجة القرب إلى ربك، والتحبب إليه بكل عبادة، لا سيما الصلاة ، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛لأنه سبحانه المنعم الخالق الذي أوجد الخلق وأوجد الإنسان وعلمه ما لم يعلم .
وأيضًا في الآية الأولى كمال التوحيد بأن يقرأ متلبسًا باسم ربه المنعم لا باسم غيره من الأصنام والمعبودات، وفي آخرها كما الخضوع والعبادة له لا سيما بالسجود الذي هو غاية الخضوع، و من أهم أفراد القراءة، قراءة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم عليه على المُبَلَّغين بالرسالة ،و أن يقرأه هو في الصلاة التي من أعظم أركانها السجود ؛ ولذلك كان من أوائل السور التي أنزلت بعد سورة العلق سورةُ المزمل التي تأمر بقيام الليل ؛ ليكون أكبر عون له في الدعوة لدين الله تعالى.
ثم هنا توافق بين الجزء الأول والأخير، ففي الأول:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } وهذا أمر للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالقراءة لما يعلمه جبريل ـ عليه السلام ـ ، وهذه القراءة لا بد أن ينتفع هو بنفسه بها بعبادة الله تعالى والصلاة ثم بالاهتداء بها في فكره واتقاء الله سبحانه ثم بتبليغها للناس؛ ليهتدوا وليحصلوا التقوى بأن يأمرهم بالتقوى وأعظم وسيلة لأمرهم بالتقوى قراءة القرآن عليهم كما قال سبحانه {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ }[ق:45].
فلذلك قابل {اقرأ} في الجزء الأول بقوله سبحانه في الجزء الثالث: {إذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12)}، فرتبها ترتيبًا بديعًا، وحذف التقوى من الأول لدلالة الثاني عليه، وحذف الهدى من الأول لدلالة الأول عليه، فما أعظم القرآن، وما أكثر أسراره.[14]
ثم هناك توافقٌ لفظيٌّ صوتي بين {اقْرَأْ}،{ وَاقْتَرِبْ}.
ثم هناك تناسب عجيب بين الأجزاء الثلاثة :
فالجزء الأول يقرر الفضل الإلهي بأن الله سبحانه أنعم على الإنسان وخلقه، وحوَّله إلى إنسان بعد أن كان علقة وكرمه بالعلم ، وعلمه ما لم يعلم، وفي هذا بشارة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أول آيات أنزلت بأن الله تعالى سيعلمه علومًا كثيرة .
وفي الجزء الثاني المركزي يقرر أنَّ الإنسان الكافر وأولهم أبو جهل لم يشكر هذه النعمة وقابلها بالطغيان والاستغناء ، ففعله متعاكس متعارض مع النعم الربانية العميمة.
ويربط الجزء المركزي (6ـ 8) بين الجزأين الطرفيين من خلال جملتين فيهما أمور أخلاقية وأخروية، ويمهد للتتمة التي تجلت في إبراز صورة ومصداق لهذا الطاغية الذي استغنى وعصى وتمرد .
ثم في الجزء الثالث يقرر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان عابدًا لله شاكرًا مصليًا تلقى هذه النعم بما ينبغي أن تتلقى بالصلاة ثم بالاستقامة على الهدى والتقوى ثم بالدعوة لها، وأن الكافر الطاغية نهاه عن ذلك وكذب وتولى .
ثم جاء مركز القسم الثاني ليقرر رؤية الله تعالى له، ومن لوازمها أن الله تعالى سيجازيه على ذلك.
وفي القسم الثالث من الجزء الثالث يهدد هذا الطاغي أبا جهل الذي لم يشكر النعم، ويأمر الشاكر الذي عرف نعمة الله عليه وهو النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن لا يطيعه، وأن يستمر على عبادته.
وبعد هذه الرحلة الطويلة مع طريقة التحليل البلاغي نعود لسورة يوسف ـ عليه السلام ـ لنفهم كلام كويبرس في تحليله لسورة يوسف ، حيث قال تتألف سورة يوسف من اثنتي عشرة سلسلة موزعة في تواز معكوس [الشكل الثاني] كما يوضحه الجدول التالي:[15]
| أـ استهلال الآيات (1ـ 3) |
| ب ـ رؤيا يوسف عليه السلام (4ـ 7) |
| ج ـ كيد إخوة يوسف ليوسف(حيلة ضد يوسف (8ـ 18) |
| د ـ ترقية يوسف النسبية في بيت العزيز(19ـ 22) |
| هـ ـ محاولة المرأة إغواء يوسف (23 ـ 34) |
| ويوسف في السجن يفسر رؤى السجينين، ونبي التوحيد (35 ـ 42) |
| وَ ـ يوسف في السجن يفسر رؤيا الملك (43 ـ 49) |
| هـَ ـ خاتمة إغواء المرأة :رد الاعتبار ليوسف (50ـ 53) |
| دَ ـ ترقية يوسف النهائية (54ـ 57) |
| جَ ـ كيد يوسف بإخوته: (58 ـ 98) |
| بَ ـ إتمام رؤيا يوسف (99 ـ 101) |
| أَـ خاتمة (102 ـ 111) |
علي هاني العقرباوي
عمان ـ الأردن
7 ـ رمضان ـ 1441 هـ
30 ـ 4ـ 2020م.
[1] هو رجل دين كاثوليكي من بلجيكا من أتباع شارل دو فوكو، عضو في أخوية إخوة يسوع الصغار ، عاش اثنتي عشرة سنة في إيران حيث حصل على درجة الدكتوراة في الآداب الفارسية من جامعة طهران ثم عمل في دار النشر الجامعية الإيرانية ، وهو أحد مؤسسي مجلة لقمان للإيرانيات ثم سافر إلى مصر فعاش في مصر منذ العام ( 1989) عضوًا في المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية (ideo) (معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان)،وتخصص في الدراسة الأدبية للنص القرآني لا سيما فيما يتعلق بتركيبه وبعلاقاته النصية مع الأدب في التوراة والإنجيل ، وقد أبدع فيما يسمى بـ(التحليل البلاغي )،( التحليل البنائي)،(التحليل على الطريقة السامية )،(فن تركيب الخطاب)، فهو رائد تطبيق منهج التحليل البلاغي على القرآن ،وهو أحد منهجيات الاتجاه التزامني .
من أهم أعماله:
1ـ "في نظم سورة المائدة نظم آي القرآن في ضوء منهج التحليل البلاغي" وقد ترجم للعربية ترجمه عمرو عبد العاطي صالح، وطبعته دار المشرق لبنان 2016.
2ـ "في نظم القرآن" ترجمه عدنان المقراني وطارق منزو، وصدر عن دار المشرق لبنان 2018.
3ـ "رؤية كشفية قرآنية: قراءة في السور الثلاث والثلاثين الأخيرة من القرآن الكريم " جمع فيه مع بعض التعديلات والإضافات مقالات سبق نشرها حول السور الأخيرة من القرآن الكريم.
4ـ "مقارنة بين التحليل البلاغي والنقد التاريخي لجون وانسبر، وغونتر لولينغ سورة العلق أنموذجًا) ترجمه خليل محمود اليماني ـ طبعه مركز تفسير للدراسات القرآنية).
5 ـ (البلاغة السامية في القرآن ـ ترجمه خليل محمود يماني).
وكتبه تحوي أمرين: أمرًا إيجابيًا، وأمرًا سلبيًا، فأما الأمر الأول فسأشرحه في أصل البحث، وقد سلك طريقة مبدعة طبق فيها ما ذكره (رولان مينيه) مدير سلسلة (البلاغة السامية) في كتابه المسمى (التحليل البلاغي) حيث تكلم في القسم الثاني من الكتاب على هذا تحت عنوان (عرض التحليل البلاغي).
وأبحاثه تبين الترابط والدقة في القرآن الكريم، وتظهر طريقة نظم القرآن وتركيبه وسيره، وتظهر كيفية التناسب العجيب في النظم والعرض القرآني، والمراد بالنظم عنده: التركيب الكلي للنص، والقواعد الحاكمة لطريقةِ وقواعدِ بناءِ النص القرآني، والكيفيات التي يتركب بها النص ذاته، لا مجرد التناسب بين الآيات والسور ووجوه الارتباط بينها، ويرد ُّعلى المستشرقين الذين يتهمون القرآن الكريم بعدم الدقة، وعدم التناسق، والانقطاع دلاليًا في العرض.
وأما الأمر السلبي فهو أنه بث في خلال كلامه كلامًا استشراقيًا خطيرًا من جملته:
1ـ أنه يحاول أن يوحي للقارئ أن القرآن استُمِد من التوراة والإنجيل، وإن كان في آخر كلامه يأتي بكلام يوهم أنه لا يقول ذلك، فتجده يأتي بالنص القرآني ويأتي بما يصدقه من النصوص القديمة ويعلق عليها بما يوحي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذها منها، أو أن النص القرآني نشأ من بيئة يهودية أو نصرانية ـ ومن المعلوم أن هناك فرقًا بين كون القرآن مصدقًا للتوراة والإنجيل ، وهو الذي يكرره القرآن دائمًا كقوله في سورة يوسف :{ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ (111)} [يوسف:111] وبين أن يكون النبي الأمي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي لا يعرف القراءة ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا تعلم من العلماء ولا من أحد من علماء اليهود والنصارى أخذه من التوراة والإنجيل،مع المعلوم أن علماءنا كانوا عندما يذكرون قصة من القرآن يوردون ما يصدقها من التوراة أو الإنجيل كما يفعل البقاعي، وابن عاشور، ومحمد رشيد رضا ، لكن يعرضون ذلك على أن القرآن مصدق لها كما نص القرآن على ذلك عشرات المرات بل هو مهيمن على الكتب السابقة ، يصحح ما فيها من أخطاء ، وأرجو من القارئ الكريم أن يرجع للتوراة أو لتفسير البقاعي الذي نقل قصة يوسف ـ عليه السلام ـ من التوراة ويقارنها بالقرآن الكريم لينظر مصداق هذا ، وليرى منطقية القصص القرآن وعدم منطقية كثير مما زاده محرفو التوراة.
2ـ يحاول ميشيل كذلك أن يوحي للقارئ أن القرآن في نظمه كالتوراة والإنجيل والكتابات السامية، وفرق بين أن يقال: القرآن الكريم جاء على الطريقة السامية ـ التي هي لغات عربية ـ بل جاء باللسان العربي المبين الذي هو أفصح الساميات، ولكنه فاق اللغات الساميات كلها فهو بالغ حد الإعجاز كما يقال القرآن عربي وليس ككلام العرب، وبين أن يقال إن نظمه كنظم غيره من الساميات.
3ـ يحاول تحريف تفسير آيات كثيرة من القرآن، لتتناسب مع أفكار و مصالح اليهود والنصارى ، ويدعو المسلمين لإعادة النظر في تفسير القرآن، بل إنه يستخدم طريقته هذه للتشكيك في تفسير علماء المسلمين ، فيقول في تحليله لسورة العلق كلمة (اقرأ )" معنى هذه الكلمة القراءة على تفسير الروايات التقليدية أمر من القراءة ، ولا شيء يعضد هذه الرواية والأصح تفسير علماء الغرب لهذه الكلمة أنها كلمة من العبارة العبرية في الكتاب المقدس بمعنى نادِ وصلِّ (قرأ بشم ياهو) ويكون حاصل المعنى صل لربك ، ولا تدل السورة أن محمدًا بعث في مهمة لتبليغ الرسالة (مقارنة بين التحليل البلاغي والنقد التاريخي لجون وانسبرو)(ص24)، فانظر إلى هذا التحريف العجيب، وتحويله لوظيفة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أصلها ،وتقديمه تفسير الذين لا يعرفون العربية على تفسير العلماء الراسخين الذين حووا جميع العلوم الخادمة للتفسير وهضموها وأتقنوها وسيروها في طريقها المحكم في التفسير ، وأنا رأيت من هؤلاء المستشرقين الكثير ممن جاء ليدرس في بلدنا، وهو لا يتقن الكلام فضلًا عن التفسير، ومعه دكتوراة في اللغة العربية، ويضع تفسيرات كما يشاء ولا رقيب عليه ولا حسيب، ويٌتَلقى كلامُه في الغرب كأنه قرآن ، فما أعجب الزمان الذي نحن فيه!
ومن جملة تحريفاته أنه قال:" التراث يقول: هذا العبد المنهي ـ في سورة العلق محمد نهاه أبو جهل وليس في النص ما يقتضي تفسيره بذلك"(المرجع السابق (31)، وهذا عجيب منه؛ فالسياق والروايات واضحة في الكلام على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولكنه يطعن في صلب الدين من حيث يُظَنُّ أنه يظهر محاسن القرآن.
ومن جملة تحريفه للأحكام استدلاله من خلال طريقته في التحليل على إباحة شرب الخمر. (البلاغة السامية (38).
ومن جملة تحريفاته ادعاؤه أن القرآن ينص على أنَّ أي فئة من البشر إذا عملوا الصالحات فهم ناجون سواء كانوا يهودًا أو نصارى أو غيرهم. (المرجع السابق 41).
4ـ يدعي أن أسباب النزول والأحاديث النبوية الشريفة وتفسيرات المفسرين هذه أضيفت لاحقًا من قبل التراث وليس لها صلة حقيقية في ذاتها، وأنها لا تراعى في التفسير، فهو ينظر للنص فقط على طريقة التحليل البلاغي، ولا يعترف بالروايات المفسرة له، ويقرر أنها نتاج متأخر ـ دون ذكر دليل علمي على كلامه ، بل يذهب أكثر من ذلك بأن ينفي أي علاقة بين كثير من السور والأحداث التي حدثت مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بل يعبر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم بالشخصية التاريخية كأنه شخصية متوهمة مصطنعة، فتجده بعد تحليل سورة العلق يقول : "ما هي العلاقة بين سورة العلق مع الشخصية التاريخية لمحمد ؟ الإجابة وفقًا لتحليله لا شيء ، فالتراث أسقط هذه الروابط بين السورة ومحمد من خلال أسباب النزول ، والتي لا أثر لها في النص لا فيما يتعلق بدعوة محمد ، ولا فيما يتعلق بالمضايقات التي عانى منها إبان قيامه بأداة الصلاة " (مقارنة بين التحليل البلاغي والنقد التاريخي (48)ـ وليس هذا فقط بل يصرح بأن طريقة التحليل البلاغي بنبغي أن تحل محل المصادر التفسيرية : سواء كانت روايات أو أقوال العلماء في التفسير ، أو تدقيقات وتحريرات المفسرين طوال القرون السابقة لفهم النص القرآني، وعلاوة على ذلك فقد قرر أن طريقة التحليل البلاغي ستدلنا على الإطار للمحيط الذي ظهر فيه القرآن سواء كان ذلك المحيط يهوديًا أو نصرنيًا أو يهوديًا ساميًا أو نصرانيًا ساميًا (المصدر السابق (يقول علي هاني: فانظر إلى هذا البهتان الذي يفعله هذا المستشرق حيث يعرض نظم القرآن بأحسن عرض ثم يدس من خلال عرضه أفكاره الاستشراقية التي تهدم القرآن، والرسالة، وعلاقة القرآن بالنبي ـ صلى الله وعليه وسلم ـ وتهدم المرويات الحديثية كلها من أصلها ، ثم تفسر النصوص كما تريد وتنسبها إلى بيئة يهودية أحيانًا ،وأحيانًا إلى بيئة نصرانية ، وذلك بأن يعرض نصوصًا توراتية لها نوع مشابهة في الموضوع ولو من بعيد بسورة ما ككونهما واعظتين مثلًا ثم يدعي من خلالها أن القرآن نشأ وأخذ من بيئة توراتية أو إنجيلية ،سبحانك هذا بهتان عظيم ، ثم هناك فرق بين إهمال الأحاديث وأسباب النزول وبين تنقيحها وأخْذِ ما صح منها وناسب السياق ، وترْكِ ما ضعف منها أو تأويله إن لم يناسب السياق، فالثانية طريقة المفسر المحقق كما يفعل هذا أبو السعود، والآلوسي، وابن عاشور، وغيرهم من كبار المفسرين الذين عندهم الأسلوب العلمي الحقيقي بخلاف هؤلاء المستشرقين الذين لا يلتفتون لما حقق في علم الحديث و المصطلح والإسناد الذي تتميز به هذه الأمة ، وهو علم تفخر به أمتنا ولا نظير له في أمة من الأمم ، وهو في الغاية من الأسلوب العلمي الرصين الذي لم ولن تصل لمثله دول الغرب ولا المستشرقون الذي يتظاهرون بالأسلوب العلمي ويخلطون الحق بالباطل ويلبسون على الناس.
ومن الملاحظ من أعمال كويبرس أنه يختار السور التي يمكن أن يصل من خلالها لهدم الدين كسورة العلق التي هي أول سورة نزلت، وسورة المائدة التي هي من أواخر ما نزل وتهدم عقائد اليهود والنصارى الباطلة، فتجده يتصيد هذه السور ويحللها ويفسرها على طريقته فيحللها ويبدع في تحليله ويبث أفكاره الاستشراقية خلال هذا التحليل.
5ـ يتهم المسلمين بأنهم يعادون اليهود والنصارى من طرف واحد وقد نص على هذا في تحليله لسورة المائدة، وهذا الأمر لا يحتاج إلى رد فما حصل في العراق، والبوسنة، والشيشان، وسوريا وغيرها يلجم من يتكلم بهذا.
6ـ يشكك في صحة تقسيم الآيات وترقيم آياتها، ومن المعلوم أن تقسيم الآيات تلقي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأن اختلاف العلماء محدود في كل سورة لا يعدو آيات قليلة اختلف أين نهايتها، ولكن ميشيل يخرج عن هذا بأمور اجتهادية من عنده ويصرح أن هذا التقسيم طرأ متأخرًا، فله الحق أن يعيد تقسيم الآيات من جديد كما يدعي.
7ـ هو غير ضليع في تفسير القرآن فيفسر القرآن بتفاسير ضعيفة إما من ابتكاره واختراعه، أو من خلال رجوعه لأضعف الأقوال، كما في تفسير لـ(كلا) في سورة العلق.
8 ـ يحاول أن يرجع الكلمات القرآنية العربية الأصول إلى أصول سريانية أو آرامي كقوله:"(الزبانية) مصطلح من أصل أجنبي (آرامي، بهلوي، سرياني) " ـ مع أن أصلها (ز، ب، ن) عربي أصيل، قال ابن فارس:"(زبن) الزاء والباء والنون أصلٌ واحدٌ يدلُّ على الدّفع. يقال ناقة زَبُون، إذا زَبَنَتْ حالبَها. والحرب تزبِنُ النّاسَ، إذا صَدَمتهم. وحربٌ زَبُون. ورجلٌ ذو زَبُّونةٍ، إذا كان مانعاً لجانبِه دَفُوعاً عن نفسه" (معجم مقاييس اللغة (3/33)، وهناك فرق بين أن نقول : اللغات السامية كـ(السريانية ، الآكادية ، والآشورية ـ وهي لغات عربية قديمة ـ والعربية الفصيحة) تشترك في الأصول اشتراكًا كثيرًا ، وبين أن يوحي أن القرآن يستعمل اصطلاحات أجنبية لم يوافقه على ادعائه أحد من علماء اللغة ولا التفسير ، مع أن كثيرًا من علماء اللغة الآن يميلون إلى أن أم اللسانيات هي اللغة العربية الفصيحة التي نزل بها القرآن كما أكد هذا لي دكتور في جامعة أمريكية متخصص في اللغات القديمة ، وهذا ليس بغريب فهي لم يتطرق لها تحريف لحفظها في الجزيرة العربية ، ولأنها أوسع اللغات السامية ، ولأنها حافظت على الإعراب الذي فقد من كثير من الساميات ؛ لذلك نجد أن المستشرقين فكوا أسرار هذه اللغات السامية من خلال معاجم اللغة العربية كلسان العرب ، ثم يأتي هؤلاء المستشرقون فيتعامون عما اكتشفوه هم من علاقة الساميات ، وعن وجود جذور واستعمالات لهذا الجذر في اللغة العربية فيقولون ما يقولونه.
وأنا أقول دراسة اللغات السامية يكشف أسرارًا كثيرة في القرآن، ويدلنا مثلًا على سر استعمال (بعل) في حق سيدنا إبراهيم، و(سيدها) مع امرأة العزيز: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف: 25]، ويدلنا على سر استعمال (اليم) دون البحر مع سيدنا موسى، وعلى سر استعمال الياء والنون في (سينين)و (إلياسين) فالقرآن يراعي مع كل قوم لغتهم واستعمالاتهم وهي تشترك مع اللغة العربية في هذه الاستعمالات، وقد استفاد الدكتور فاضل السامرائي من هذا في كشف أسرار استعمال القرآن الكريم.
9ـ تجده بعد أن يبين النظم والتناسق العجيب في القرآن ويعترف بأن بناء القرآن دقيق عميق مترابط بطريقة عجيبة ـ بدل أن يقرَّ بأنه لا يمكن أن يكون قد أتى به بشر لا سيما النبي الأمي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يعترف بأنه من عند الله تعالى ، ويدعي أنه لا يمكن أن يكون أخذ مشافهة بل هو مكتوب على الأسلوب العلمي ، يقصد بذلك أنه مفترى بعناية حيث قال في كتابه "مقارنة بين التحليل البلاغي والنقد التاريخي: "لا شك أن التوازيات تنشأ داخل نطاق الشفاهة ، وهذا أمر محل اتفاق لكنَّ نظامً معقدًا كهذا الذي قمنا به في بيان التركيب في سورة العلق ربما ينتمي إلى الكتابة العلمية أكثر من انتمائه إلى الارتجالية الشفهية ، وتطرح عالمة الأنثروبولوجيا الإنجليزية (ماري دوجلاس) في معرض تساؤلها عن السبب وراء هذه الأشكال من الكتابة المعقدة ـ فكرةَ أنَّ كتبة العصور الوسطى أرادوا بهذا إظهار مقدرتهم الأدبية ، وكانوا يتنافسون بمهارة في فن نظم النص، إنها طريقة لتمييز اللغة ذات الأسلوب الرفيع والمخصصة للمواضيع النبيلة (كالنصوص الدينية والأسطورية والوطنية..) عن تلك اللغة المستعملة في الشؤون الحياتية اليومية). (ص46)، فانظر إلى هذا الكلام الذي هو صريح في أن القرآن الكريم من صنع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عُرِض بطريقة ملتوية.
10 ـ يحاول أن يوحي بأن البلاغة التي قررها الإمام عبد القاهر وعلماء البلاغة من قبله ومن بعده هي بلاغة يونانية دخيلة على القرآن الكريم ، وأن البلاغة السامية تقتضي أن يحلل النص القرآني بطريقة التركيب البلاغي التي يتبعها هو ، ونحن نقول: أما ادعاؤه أن البلاغة التي استقرت قواعدها على يد إمام الفن عبد القاهر الجرجاني يونانية فقد تصدى كثير من العلماء لتفنيد هذا الادعاء، ويكفينا أن نقرأ كتب عبد القاهر؛ لنعرف أنه استقرأها واستخرجها من صميم لغة العرب، ومن شعرهم لا سيما من ديوان الحماسة ، ثم نقول : كل من الطريقتين لا بد منهما في تفسير القرآن ، فطريقة البلاغة التي قررها الإمام عبد القاهر وطبقها الزمخشري ومن بعده المفسرون تفسر أمورًا بلاغية كثيرة لا حصر لها في القرآن الكريم :من تقديم وتأخير ، وتأكيد وعدمه ، وبيان طرق القصر ، وغير ذلك الكثير مما لا حصر له ،مما نجده في الكشاف، وتفسير أبي السعود ، والبقاعي ، وابن عاشور، وغيرهم ، وطريقة كويبرس ويُضَمُّ لها ما فعله سعيد حوى تفسر لنا تركيب القرآن وبناءه، وهي طريقة بديعة لا يستغنى عنها ، وإذا كان القرآن الكريم جاء على الطريقة السامية كما يعبر كويبرس فقد تكلم الجرجاني في صميم الطريقة السامية .
11ـ يُقَسِّم التفاسير إلى قسمين: تفسير قديم تقليدي جامد، وتفسير أيديولوجي حديث يؤدي إلى العنف الذي نشهده اليوم، ويدعي أن التفاسير التي فسرها علماؤنا على طوال القرون لم تعُد كافية لتلبية مشاغل الإنسان المعاصر. (البلاغة السامية ـ ص7) طبع ترجمته في مركز تفسير للدراسات).
12ـ يتهم المفسرين بأنهم يفسرون القرآن آية آية بدون نظر إلى سياقها منذ بدايات التفسير وحتى يومنا هذا. (البلاغة السامية(ص25).
13ـ ينفي النسخ في القرآن، ويصف الآيات القرآنية التي بيْنَها نسخ (ناسخ ومنسوخ) بأنها آيات متناقضة تناقضًا ظاهرًا، وأن القول بالنسخ يعتمد على أدلة لا أصل لها. (البلاغة السامية (27).
14ـ هناك تعبيرات له تصدر عنه لا يرضاها مسلم، كقوله في بعض المواضع كما في سورة العلق" الآية متكونة من بيتين" وهذا كلام خطير فيه جعل القرآن كالشعر المصنوع، وفيه اتهام القرآن بالافتراء، وهكذا فأنت كلما قرأت صفحة من كتابه تجد بعض السموم قد بثت في كلامه، سواء في التعبير أو المضمون، وهذا ليس بغريب على المستشرقين.
والحاصل أن ميشيل يظهر إبداع القرآن من جانب، ويحاول أن يشكك بالثوابت ويزيل عظمة القرآن من النفوس من جانب آخر ؛ لكن هذا لا يمنع المتخصصين فقط لا عوام الناس أن يستفيدوا من إبداعاته الرائعة في كشف أسرار النظم القرآن التي نجد منها هو موجود عند علمائنا ـ رحمهم الله ـ ومنهما ما هو جديد لم يسبقه إليه أحد لا سيما أنه يسير على قوانين واضحة دقيقة، ويحاول بيان قوانين النظم القرآني وطريقة بناء السورة، وأما غير المتخصصين فينبغي أن يبقوا في منأى من كتبه المسمومة ؛لأنهم قد يتأثرون بشطحاته وضلالاته ؛وهذا ما قرره علماؤنا في كتب العقائد المخلوطة بضلالات الفلاسفة ؛ فعلى المتخصصين أن يقوموا بواجبهم في هضم هذه الطريقة ثم نقدها وأخذ الصالح منها وترك الطالح ليخْرُجَ للناس من بين فرث ودم لبنٌ خالصٌ سائغٌ للشاربين.
[2] رولان مينيه (1939 ـ 1992) راهب يسوعي فرنسي، أستاذ اللاهوت الكتابي بالجامعة الغريغورية الحبرية في روما، متخصص في الساميات وفي إنجيل لوقا، وقد طبق منهجية البلاغة السامية على إنجيل لوقا وهو له مؤلفان رئيسيان: (التحليل البلاغي طريقة جديدة لفهم الكتاب المقدس، النصوص التأسيسية والعرض المنهجي) الذي تمت إعادة صياغته وتطويره في عمل ضخم وهو:( مقدمة في البلاغة الكتابية).
[3] ينظر تلخيص هذه المصطلحات في كتاب البلاغة السامية في القرآن / ترجمة خليل محمود يماني (ص15) / طباعة مركز تفسير للدراسات القرآنية.
[4] (القارعة) مبتدأ خبره الجملة التي تأتي في الآية الثانية ، لكنه في الآية وحده ، و(نار حامية) خبر مبتدأ محذوف وهو وحده مستقل لم يذكر مبتدأه ، فمجيء عنصر مستقل هو الجامع بينهما.
[5] نظم الدرر / البقاعي (8/ 766).
[6] حينما تقع العناصر في بدايات الوحدات تسمى بالعناصر البدئية، وعندما تقع في المركز تسمى بالمركزية، وعندما تقع في النهاية تسمى النهائية.
[7] كلمات الحبك: هي العناصر الوصلية، كلمات الوصل.
[8] ما سيأتي مزجت فيه كلامي مع كلام كويبرس وعدلت بعض أقواله.
[9] تنبيه: هذا تحليل كويبرس أضفت عليه ما لم يذكره وكملته، وصححت تعبيراته إن كانت غير لائقة، وصححت الأفكار كذلك والتفاسير، فهذه نسخة معدلة لتحليله.
[10] يرجى الانتباه أنه جزء محوري وليس قسمًا محوريًا.
[11] لم يفصل ميشيل هنا كثيرًا في هذا القسم؛ لذلك معظم ما في الكلام على هذا القسم من كلامي.
[12] استطاع الباحث التوراتي نيلس ويلهلم لوند في كتابه "البناء المحوري العكسي في العهد الجديد" أن يستخلص قوانين لتنظيم البناء المحوري من خلال دراساته المطولة للنصوص، وقد حصرها في سبعة قوانين عرفت فيما بعد بـ(قوانين لوند).
[13] ونص القانون: " في الكثير من الحالات تظهر الأفكار في وسط نظام أول وفي أطراف نظام آخر يقابله، ويكون الثاني مبنيًا بالطبع ليتماشى مع الأول "، وهو ما أطلق عليه قانون انتقال الوسط نحو الأطراف". يراجع طريقة التحليل البلاغي والتفسير ص78.
[14] وبهذا يبطل كلام كويبرس الذي أراد أن يقصر فعل القراءة على العبادة، وأن ينفي الأمر للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالتبليغ بعد القراءة على جبريل؛ ليتوصل أن دين الإسلام ما جاء لينُشَر على البشرية، إنما يكتفى فيه بالعبادة الشخصية، فما أخطره من أسلوب يضع فيه السم في الدسم بأسلوب خفي.
[15] تصرفت في عبارات الجدول تصرفًا يسيرًا.
شرح طريقة