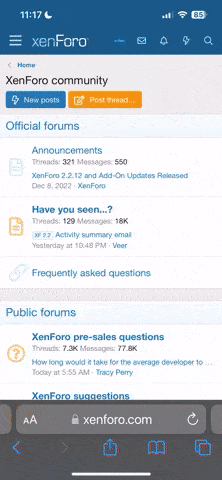موازنة بين توجيه زيادة الألف بعد الواو المتطرفة عند ابن البناء المراكشي وتوجيهات غيره
موازنة بين توجيه زيادة الألف بعد الواو المتطرفة عند ابن البناء المراكشي وتوجيهات غيره
هذه المشاركة استجابة للأستاذ سعيد محمود أحمد
وهي جزء من رسالة تدرس توجيهات ابن البناء المراكشي لظواهر الرسم العثماني ... العنوان لا يتناسب مع محتواها كل التناسب .. لكن هذا الذي رأيته أقرب للجمع بين الموضوع المعروض والمستل من بحث آخر موضوع هذه الصفحة....
من الصفحة 270 إلى الصفحة 284
الألف الزائدة في آخر الكلمة :
زيادة الألف في آخر الأفعال مثل:
(ﮬ
) (ﮨ
) (ﮔ
) (ﰒ
)...
قال موجّها هذه الزيادة: " وذلك أن الفعل أثقل من الإسم لأن الفعل يستلزم معناه فاعلا بالضرورة فهو جملة في الفهم منقسمة قسمين، والاسم مفرد لا يستلزم غيره. فالفعل أزيد من الاسم في الوجود، والواو أثقل حروف المد واللين، والضمة أثقل الحركات، والمتحرك أثقل من الساكن. وكل ذلك حاصل في الوجود يجده كل إنسان من نفسه ضرورة."
[1] فزيدت الألف تنبيها على هذا الثقل.
· إنّ أوّل ما يسجّل على هذا التوجيه ادّعاؤه أنّ هذه الزيادة خاصة بالأفعال دون الأسماء وهذا غير صحيح فقد مرّت معنا أسماء زيدت فيها الألف في آخرها كما زيدت في الأفعال هنا ومن أمثلة ذلك ما يلي: ﭽﮡ ﭼ (ﮏ ) (ﮔ) (ﯓ) (ﯞ) (ﰆ) (ﭫ) (ﭦ) (ﭕ) (ﭟ) (ﯨ)....
[2]
· الملاحظة الثانية التي نسجّلها هنا هي كون هذا التوجيه من قبيل الحكم على القديم بما استحدث بعده، وهو منهج -كما سبق ذكره- "مقلوب" في التعامل مع الظاهرة. فهل كانت هذه المفاهيم الاصطلاحية معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم ؟ وهل كانت هذه التفصيلات النحوية والبحوث الصرفية
[3] حاضرة في ذهنهم وهم يكتبون المصحف ويرسمون كلمات القرآن الكريم؟ طبعاً لا؛ فهي اصطلاحات حادثة بأسمائها ومفاهيمها، وما كان العرب قبل النحاة ينتبهون لبناء كلامهم وأقسامه إلاّ بالقدر الذي يؤدّوه به على الوجه الصحيح، وقد كان ذلك فيهم طبيعة وسليقة لا يحتاج إلى هذا التكلّف الاصطلاحي وهذه المعالجة النحوية والصرفية...
· الفعل يقتضي فاعلا في العقل، وفي كلام الفصحاء، ولكن إذا استعمل الفعل لمجرد التمثيل أو لدراسته إملائيا مثلاً أو صرفيا فإنّه لا يقتضي ذلك لأنّنا ندرسه بعيدا عن هذا الاقتضاء وهذه الحيثية. وكذلك هو الاسم في كلام الفصحاء لا يتصور في تركيبهم إلاّ مصحوبا بفعل أو باسم مثله. إذن هذا الثقل الذي نسبه المصنف للفعل بسبب اقتضاء غيره ليس لازما للفعل في كلّ أحواله من جهة، ولا يخلو منه الاسم في كلّ أحواله من جهة أخرى.
· وقد تقدّم معنا في الفصل الثالث أنّ أثقل الصوائت القصيرة منها والطويلة هي الكسرة والياء وليس الضمة والواو...
· قول المصنف في حقّ هذه الألف المزيدة: " وقد تسقط في مواطن حيث لا يكون ذلك على الجهة المحسوسة من الفعل بل على أمر باطن في الإدراك"
[4] مفهومه أنّ زيادة الألف في الأفعال ليست متعلقة بثقل الأفعال فقط، بل يشترط في الألف أن تكون على الجهة المحسوسة من الفعل، والقصد بهذه العلّة الثانية أن يكون معنى الفعل مصنفا في خانة الملكية لا الملكوتية. وعلى القول بجواز التعليل بعلتين
[5]، يبقى على المصنف أن يبيّن لنا هل عملهما على وجه البدلية؟ أي أنّ التأثير يحصل بالوصف الأوّل كما يحصل بالوصف الثاني، أم أنّ التأثير إنما يكون بمجموع الوصفين ؟ وإذا كان الحكم يتخلف بتخلف علة المحسوسية أو المعنى الملكي؟ فهل يتخلف ويسقط بتخلف العلة الأولى علة الفعلية أو الثقل ؟ ... كلّها تساؤلات تركها المصنف دون إجابات واضحة ومقنعة؛ ما يتسبب في التباس التعليل وارتباك التوجيه بما يلجه من اضطراب وتزاحم وخلط بين عناصره؛ ما يؤدي بدوره إلى تشويش الفهم وتعسيره.
من الأحرف التي تخلّفت عنها ظاهرة زيادة الألف ووجّهها المصنف بالمعنى الباطني والملكوتي على العموم وبمعاني أخرى خصّ كلّ حرف ببعضها ما يلي:
(ﮨ
)[6] قال: "هذا سعي بالباطل ملكوتي لا يصحّ له ثبوت في الوجود من حيث هم معاجزون فسعيهم باطل في الوجود"
[7]
(ﯦ
)[8] قال موجّها المواضع التي أوردها: "هذا المجيء ليس على وجهه من حالة الوجود الملكي الصحيحة."
[9]
(ﭪ
)[10] قال: "هو فيء بالقلب والاعتقاد."
[11]
(ﯧ ﯨ ﯩ
)[12] قال: "اختاروهما مسكنا لكن لا على الجهة المحسوسة لأنّه سوى بين الدار والإيمان، وإنما اختاروهما مسكنا لمرضاة الله تعالى. ويدلّ على زجرهم في محسوسات الدنيا."
[13]
(ﮒ
)[14] قال: "لأنّه رجوع معنوي."
[15]
(ﮱ
)[16] قال: "لا يتصوّر فيه التركيب في الفهم لأنا لا ندركه إنما تركيبه وهمي شعري. فإن كيف هذا الفعل لا يعلم إذ هو ترك المؤاخذة. فحذف ألفه لذلك."
[17]
(ﭣ
)[18] قال: "هذا عتوّ على الله لذلك وصفهم بالكبر فهو باطن باطل في الوجود."
[19]
(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
)[20] قال: " وكذلك سقطت من:
(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
) ولم تسقط من
(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
) لأن "غضبوا" جملة بعدها أخرى والضمير "مؤكد للفاعل" في الجملة الأولى. و"كالوهم" جملة واحدة، الضمير جزء منها. وفرقانه ظاهر."
[21]
· سنحاول مناقشة هذه التوجيهات جميعها من حيث المعاني والمضمون ومن حيث الشكل والمنهج. ولعلّ أوّل هذه الملاحظات ما يتعلق بكلمة
(ﮨ
) فقد حذفت الألف في موضع سبأ الذي أورده المصنف لأنّه "سعي بالباطل وملكوتي"، ولكنّه أثبت في موضع الحج رغم كونهما جاءا باللفظ نفسه والمعنى ذاته
(ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
)[22] (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
) [23] وهذا من شأنه أن ينقض هذا التعليل ويبطل هذا التوجيه.
· إذا كانت الألف إنّما حذفت في المواضع التي ذكرها من كلمة
(ﯦ
) بسبب كون هذا المجيء "ليس على وجهه من حالة الوجود الملكي الصحيحة" فقد جاءت الكلمة نفسها في مواضع أخرى وبالحكم ذاته زيادة الألف في آخرها ولكن بتخلّف التوجيه الذي ذكره فقد نُسِب المجيء للأنبياء ولا يكون من قبلهم إلاّ على وجهٍ صحيح حيث قال عزّ من قائل:
(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
)[24] كما نسب للمؤمنين على وجه المدح والثناء حيث قال عزّ وجلّ:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
)
· وإذا كان حذف الألف من كلمة
(ﮱ
) سببه كما قال المصنف هو جهلنا بحقيقة هذا العفو لأنّه "تركيب وهمي شعري"؛ طبعا لأنّه منسوب إلى الله عزّ وجلّ، وقد ورد كذلك في مواضع أخرى منسوبا إليه سبحانه وتعالى، لكن هذه المرة بإثبات الألف مع العلم أنّ عفوه واحد لا يتغير أو يتعدد أو يتنوع كما هو سمعه وبصره وكما هي رحمته ومغفرته. قال عزّ وجلّ:
(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
) [25] وقال أيضا:
(ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
)[26]
· كلمة
(ﭣ
) وجّه حذف الألف فيها بسبب كون العتو وقع على الله تعالى "فهو باطن باطل في الوجود" ولكنّه ورد في مواضع أخرى بالمعنى ذاته الذي ذكره وبإثبات الألف لا بحذفها قال عزّ وجلّ:
(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
)[27] وقال أيضا:
(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
)[28] وفي موضع آخر قال سبحانه وتعالى:
(ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
) [29] فهذه الكلمات جميعها وردت بزيادة الألف وبحذفها رغم اشتراك مواضعها في العلّة والتوجيه الذي ذكره المصنف، وهذا ما يطعن فيه وينقضه.
· كلمات مثل:
(ﭪ
) (ﯧ ﯨ ﯩ
) (ﮒ
) لم ترد إلاّ في موضع واحد، وهذا ما يجعل إثبات توجيه المصنف ممتنعا لقصور علّته ولعدم إمكانية إثبات هذا التوجيه علمياً... –كما تقدّم معنا في غير ما مرة –
· الواو في
(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
) ليست متطرفة حتى يدرجها في هذا المطلب. وممّا جاء في جميلة الجعبري : "فمن ثم قال أبو عبيد: أجمعت المصاحف على طرح الألف من
(ﯡ
) و
(ﯢ ﯣ
). وقال في الزاد: كل منهما كلمة واحدة."
[30] وقال الأستاذ المارغني: "واعلم أنّ الناظم
[31] لم يستثن من واو الجمع واو
(ﯡ
) و
(ﯢ ﯣ
) لأنها ليست متطرفة لكون الضميرين بعدها متصلين منصوبين بالفعلين لا منفصلين على الصحيح فلا حذف في الكلمتين أصلاً"
[32]
· ورود الخلاف في بعض هذه المواضع التي وجّهها ينقض أصل التوجيه بالمعنى –كما تقدّم معنا- فمن ذلك اختلاف المصاحف في
(ﮱ
) ، قال الإمام السخاوي رحمه الله: "وفي استثناء
(ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
)في النساء نظر؛ فإني كشفت ذلك في المصاحف العتيقة العراقية فوجدته بالألف كأخواته، وكذلك رأيته في المصحف الشامي بألف بعد الواو."
[33]
· تركه لأحرف من هذا النوع دون توجيه أو تعليل يوهّن هذا التوجيه ويضعّفه لأنّه لا يشملها فهو توجيه قاصر في غالب أحواله على الكلمات التي ذكرها ولا يتعداها لغيرها. ومن هذه الأحرف ما يلي:
(ﮰ
)[34] (ﮙ
) [35] (ﭦ
)[36] (ﯪ
)[37] . كما أنّ هذه الحروف تنقض توجيه المصنف من جة أخرى هي كون المصاحف اختلفت في رسمها بين الزيادة والحذف...
الوقوف على توجيهات علماء الرسم للألف الزائدة في آخر الأفعال:
التوجيه الإشاري:
ممّا قيل في توجيه عموم زيادة الألف في الأفعال أنّها تفيد زيادة في المعنى فكلمة
(ﯺ
) [38] تفيد زيادة الألف فيها طول الشكوى، و
(ﰒ
)[39] عظم الرجاء وهكذا...
[40] أما في حالة حذفها فالتوجيه يختلف فهو في
(ﮨ
) يفيد معنى "السعي السريع جدّاً وكلّه نشاط وهو حسب الآية الكريمة سعي في إنكار آيات الله وهو ما جلب على الكافرين عذابا من رجزٍ أليم في الدنيا... بالإضافة إلى عذاب جهنّم في الآخرة..."
[41] كما يوحي ترك الألف في
(ﮒ
) إلى "سرعة اكتسابهم غضب الله"
[42] وفي
(ﭪ
) "الإسراع في العودة عن الإيلاء، وإلاّ يكون هناك الطلاق كما ورد في الآية اللاحقة."
[43] وفي
(ﯦ
) "توحي بالوصول إلى الموقع المحدد بدون تراخي لأيّ زمن أي ليس هناك انتظار لأيّ زمن لحين الوصول الفعلي فقد تمّ الوصول عند الموقع"
[44] وذلك بخلاف كلمة (أتوا) فتعني الوصول إلى مشارف الموقع ولا بدّ لزمن ما للوصول إلى الموقع المحدد. أي أنه لا وجوب لاختصار أيّ حرف في هذه الحالة."[SUP](أ)[/SUP] وكلمة
(ﮱ
) حذفت ألفها لما أفادت عفوا خاصا
[45]
التوجيه التاريخي:
هذا التوجيه قائم على أنّ هذه الظاهرة إنّما هي من مخلفات النظم الكتابية القديمة التي اشتقّت منها الكتابة العربية، وقد تقدّم نقل الداني لنص في غاية الأهمية عن أبي إسحاق الزجّاج والذي ذكر فيه أنّ زيادة الألف ظاهرة كانت "قبل الكتاب العربي"
[46]. وفي هذا الإطار يقول الأستاذ غانم قدوري الحمد: "إنّ تتبع لأمثلة هذه الظاهرة يدفع إلى القول بقدم الظاهرة وأنّها ربما كانت تشمل كلّ واو وقعت متطرفة، سواء أكانت في فعل أو اسم، وسواء أكانت تمثل الواو الصامتة أم الضمة الطويلة، وأنّ ما جاء من بعض الأمثلة التي حذفت منها تلك الألف الزائدة إنما هي مثل بعض الكلمات التي تحرّر الكتّابُ من صورة هجائها القديمة وجروا في كتابتها على اللفظ."
[47]
التوجيه الإملائي:
علّل كثير من علماء الرسم زيادة الألف بعد الواو المتطرفة بأنّها لبيان نهاية الكلمة وفصلها عما بعدها وجواز الوقوف عليها، والألف في ذلك تشبه ما عرفته الكتابة العربية الجنوبية ممثلة في خطّ المسند من فصلها بين الكلمات بخطّ عمودي هو في شكله وموضعه قريب جدا من هذه الألف.
[48]
التوجيه الصوتي واللغوي:
قال الصولي
[49]: "وقال الخليل الضمة تنقطع إلى الهمزة فاستوثقوا بالألف " ثمّ تعقّب الصولي هذا التوجيه بشيء من التهكم قائلا: "لا يقع مثل هذا إلاّ في طبع الخليل."
[50] ويبدو أنّ النّص الذي نقله الصولي عن الخليل ناقص أو مصحف لهذا استغربه، وبتتبع مظانّه وجمع روايته يتبيّن أنّ الخليل يرى أنّ زيادة الألف بعد الواو لبيان "هوائية ومدّية" هذه الواو، واختاروا الألف -علامة الهمزة في الأصل- لقرب مخرجها وتجانسها – في حسّهم _ مع الألف المدية، أو لاشتراكها مع الألف في الرمز الكتابي. ومن النصوص التي تشير إلى هذا التوجيه ما نقله ابن درستويه في الكتاب عن الخليل من "ان الألف كتبت مع واو الجميع من أجل أنّ منقطع المدّ [عند] مخرج الهمز، [و] أنّ واو الجمع لا أصل لها في الواو، وإنما هي مدّة والمدّات لا معتمد لها في الفم ولكن يتسع لها الفم فتهوي في جوّه من أقصى المخارج أو أدناه ثم تنقطع من حيث ابتدأت الهمزة ولم يكن في المدّات [الثلاث] شيء أشبه بالهمزة صوتا من الألف ففصل بين هذه الواو والتي هي مدّة وبين التي ليست بهاوية بهذه الزيادة، وخصت الألف بالفرق لما ذكرنا."
[51]
توجيهات أخرى:
جلّ من علّل ووجّه هذه الزيادة سواء من علماء الرسم أو العربية، ذهبوا إلى أنّهم قصدوا بها التفريق بين بعض الأصوات، أو بين بعض الرموز الكتابية المتماثلة، ولكنّهم اختلفوا في تعيين هذه المتماثلات والمتشابهات التي قُصِد التفريق بينها بزيادة الألف،
[52] ولعلّ أهمّ وأشهر ما ذكروه ما يلي:
التفريق بين واو الجمع وواو النسق
[53] أو بين واو الجمع وغيرها
[54]ومثّلوا له بنحو: "
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
) [55](ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
) [56] فبانعدام الألف علم أنه ليس بواو جمع، وفي نحو:
(ﰂ ﰃ
)[57] بوجود الألف، تعيّن أنّه واو جمع..."
[58]
التفريق بين الواو الأصلية والواو الزائدة عموما
[59] أو بين واو الجمع والواو الأصلية
[60]
التفريق بين الواو الساكنة والواو المتحركة، وهو منسوب للفراء
[61]
التفريق بين الاسم والفعل، وهو منسوب للكسائي
[62]
التفريق بين ما بعده ضمير منفصل، فتجعل فيه الألف نحو:
(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
)[63] وبين ما بعده ضمير متصل فلا تجعل فيه الألف نحو:
(ﭑ ...ﭓ ﭔ ... ﭗ ﭘ ... ﭞ ﭟ .... ﭤ ﭥ ﭦ...
)[64] ومن هذا القبيل حرفي المطففين
(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
)[65]
ويذهب آخرون إلى أنّ هذه الألف إنّما هي عوضا عن النون
[66] في نحو:
(...ﭞ ... ﭠ ...ﭤ...
) أو عوضا عن بعض الضمائر المتصلة كنحو:
(ﭜ ﭝ... ﭹ ﭺ ... ﭻ ﭼ...
) (ﭑ ﭒ... ﯡ ﯢ
) ( ﯥ... ﮰ
) ...إلخ. قال أبو العباس المبرد
[67]: "والذي عندي فيه أنّ الألف جعلت بدلاً من المكنى وهو الهاء لأنهم إذا قالوا (ضربوه) سقطت الألف فإذا قالوا (ضربوا) ثبتت ليعلم أنّ الحرف قد انفرد."
[68]
قيل الأصل زيادتها بعد واو الجمع وزيدت في كلّ واو متطرفة حملا لها على واو الجمع تشبيها لها بها من حيث التطرف والسكون
[69] وإلى هذا أشار ابن قتيبة
[70] بقوله: "...غير أنّي رأيت متقدّمي الكتاب لم يزالوا على ما أنبأتك من إلحاق ألف الفصل بهذه الواوات كلّها، ليكون الحكم في كل موضع واحداً."
[71]
وأكثر هذه التوجيهات راعت الجانب النحوي والكتابة الإملائية المستحدثة، أو أنّها إنّما علّلت جانبا أو وجها من أوجه زيادة الألف دون مجموع حالاتها. والتوجيه الصحيح لهذه الزيادة ينبغي أن يشمل جميع مواضعها وحالاتها، ومن جميع التوجيهات المتقدّمة تبدو التوجيهات التي اتصفت بالشمولية هي: التوجيه التاريخي، أو التوجيه بالفصل وبيان جواز الوقف، أو التوجيه بإجراء جميع الواوات المتطرفة مجرىً واحداً...
زيادة الألف في: (ﯕ
)[72] (ﯗ
)[73]
قال موجّها زيادة الألف في
(ﯕ
) و
(ﯗ
) :"تنبيها على تفصيل المعنى فإنّه يبوء بإثمين من فعل واحد. وتنوء المفاتح لأنّها بثقلها أثقلتهم فمالت وأمالتهم. وفيه تذكير بالمناسبة يتوجه به من مفاتح كنوز مال الدنيا المحسوس إلى مفاتح العلم التي تنوء بالعصبة أولي القوة في بقيتهم إلى ما عند الله في الدار الآخرة من النعيم المقيم."
[74]
لنبدأ بمناقشة توجيهه لحرف
(ﯕ
) فإنّ أوّل ما يلاحظ عليه من حيث المضمون أنّ كلّ ظلم يقع على الغير يتبوّأ صاحبه بثلاثة آثام لا باثنين فقط، الأوّل في حقّ نفسه بخطيئته ومعصيته والثاني في حقّ المظلوم بما أوقعه عليه من أذىً في نفسه أو ماله أو عرضه والثالث في حقّ الله عزّ وجلّ بمخالفته لأوامره ونهيه وخروجه عن شرعه. فهل يستوجب ذلك أن نزيد الألف في رسم كلّ فعل حمل في طياته معنى الظلم كنحو: ظلم، قتل، ضرب، آذى، أخرج...
إنّ زيادة هذه الألف جاءت في آخر مادة هذه الكلمة التي تعدّدت في القرآن الكريم كنحو"
(ﮃ
)[75] (ﯲ
)[76] (ﯛ
)[77] ... وليس فيها شيء من المعنى الذي ذكره في توجيهه... بل إنّ حرف
(ﯧ
)[78] رسم بدون هذه الألف وهو في القياس أولى بها من الحرف الذي مثّل به المصنف؛ لأنّ القياس كان يقتضي تعويض الواو الآخرة بألف لمنع اجتماع الأمثال...وقد تنبّه صاحب الهجاء
[79] لهذه الملاحظة فنصّ على أنّ هذه الكلمة رسمت في هذا الموضع بلا ألف؛ إشارة إلى أنّها كان ينبغي أن ترسم بها. والله أعلم.
وإذا قابلنا رموز هذه الكلمة الكتابية بصوامتها وصوائتها الطويلة
[80] نلاحظ تطابقا تامّا، (التَاءُ المفتوحة + الباءُ المضمومة + الواو المدّية + الهمزة المنصوبة) في مقابل (صورة للتاء والباء والواو والألف) ، فلا مجال والأمر كذلك للحديث عن الزيادة في هذه الكلمة. ولعلّ هذا هو سبب مناقشة علماء الرسم لهذا الحرف في باب الهمز
[81] وعدم إدراجه في باب الزيادة.
أمّا
(ﯗ
) فإنّ العملية ذاتها التي قمنا بها مع
(ﯕ
) إذا أعدناها وكررناها هنا ستفضي إلى عدم وجود زيادة في رموز كتابتها في مقابل أصواتها.
ثمّ إنّ هذا حرف "موحّد
[82]" وتعليل رسمه بالمعنى يجعل من هذا التعليل وصفا قاصراً على محلّه لا يتعداه لغيره؛ والتعليل القاصر لا يصحّ التعليل به لعدم إمكانية إثباته علميا لا بطردٍ ولا بعكسٍ.
وممّا يطعن في توجيه المصنف ويشكّك في إثباته وصحته العلمية تركه لأحرفٍ مشابهة لحرفي هذا المطلب وعدم التعرض لهما. فمن ذلك:
(ﮪ
)[83]، ذكر الإمام الشاطبي هذه الكلمة مع حرفي الباب على أنّ لهما حكما واحدا
[84]، وكذا:
(ﯛ ﯜ
)[85] . وأظهر ما تظهر هذه الزيادة على قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر والأعمش؛ حيث قرؤوا بفتح الهمزة.
[86]
زيادة الألف بعد الهمزة المعضودة في نحو:( ﭯ
) [87]
قال موجّها هذا المثال: "زيدت الألف بعد الهمزة المعضودة آخرا تنبيها على صفتي البياض والصفاء، بالنسبة إلى ما ليس بمكنون وعلى تفصيل الأفراد. يدلّ عليه قوله تعالى:
(ﭮ
). وهو على خلاف حال:
(ﮮ ﮯ
) لم تزد الألف للإجمال وخفاء التفصيل: يدلّ على ذلك قوله تعالى:
(ﮮ ﮯ ﮰ
) ."
[88]
إيراده لهذا الحرف وتخصيصه لموضع الواقعة دون سواه، وتأكيده لهذا التخصيص بنفي الزيادة عن موضع الطور، غريب من المصنف، وهو تأكيد مرة أخرى على عدم تخصصه ومعرفته بكثير من مسائل هذا العلم؛ وذلك أنّ المصادر المختصّة لم تخلُ جميعها من ذكر الخلاف في هذا الحرف في جلّ مواضعه، وسأكتفي بإيراد بعض الأقوال من مقنع الداني، المصدر الذي لا ينبغي لمن كتب في علم الرسم أن يتجاوزه أو يتجاهله.روى بسنده عن الأعرج
[89] أنّ كلّ موضع فيه
( ﭯ
) فأهل المدينة يكتبون فيه ألفا بعد الواو الأخيرة.
[90] وعن عاصم الجحدري قال: "كلّ شيء في الإمام –مصحف عثمان- من ذكر
( ﭯ
) فيها ألف إلاّ التي في الملائكة."
[91] وعن محمد بن عيسى الأصبهاني قال: "كلّ شيء في القرآن من ذكر:
( ﭯ
) فإنما يكتب:
(ﮯ
) ليس فيه ألف في مصاحف البصريين، إلاّ في مكانين ليس في القرآن غيرهما: في الحج
(ﯽ
) ،
(ﯜ ﯝ
) :
(ﯡ ﯢ
) "
[92] فالمسألة أكبر وأوسع ممّا ذكره المصنف ولا وجه لتخصيص موضع الواقعة بزيادة سواء على ما في المصحف الإمام أو على مذهب كتاب المدينة أو البصرة، وكذا لا وجه لتخصيص موضع الطور بحذفها على جميع المذاهب والأقوال المتقدمة.
إنّ المعنى الذي وجّه به الزيادة في موضع الواقعة يقتضي وفق أصوله الحذف لا الزيادة ، إذْ معنى
(ﰇ
) "ما كان في الصَّدف،
[93] وأُكِنَّ من أن يمسَّه شيء"
[94] وهذا أقرب إلى البطون والخفاء الذي يقتضي الحذف لا الزيادة.
اختلاف المصاحف في رسم مجموع مادة
(ﯢ
) من شأنه أن يطعن في أصل التوجيه بالمعنى لأنّ الحرف واحد بسياقه ومعناه، وحكم رسمه مختلف؛ فلا بدّ والأمر كذلك أن تتعلق صفة رسمه بشيء آخر غير دلالته ومعناه...
توجيهات علماء الرسم للألف الزائدة بعد الهمزة "المعضودة":
أمّا
(ﯕ
) و
(ﯗ
) فأكثر علماء الرسم
[95] على أنّ الألف هي صورة الهمزة ولا تحتاج المسألة إلى توجيه وتعليل
[96]، بينما يرى آخرون على رأسهم الإمام الجعبري "أنّ الهمزة حيث لم تصوّر تطرفت الواو فجرى عليها حكم
(ﮘ
) .
[97]
وأمّا
(ﯢ
) فقيل الألف صورة التنوين في حالة الوقف
[98]، وعيب هذا التوجيه أنّه لا ينطبق إلاّ على المنون المنصوب فقط. وقيل لفصل الكلمة عمّا بعدها
[99] وضعّف التنسي هذا القول
[100]، وذهب البعض إلى أنّ الألف زيدت بعد الواوِ صورةِ الهمزةِ في هذه الكلمة قياسا وإلحاقا لها بواو الجماعة من حيث جاءت طرفا وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء
[101]، بينما يرى الكسائي أنّ الألف زيدت تقوية للهمز
[102]. ويرى آخرون أنّ زيادة هذه الألف في بعض المصاحف وكذا حذفها في أخرى سببها وعلّتها اختلاف الأحرف فقد جاءت بعضها بالنصب وهي تستلزم الألف وأخرى بغير النصب لا تستلزم الألف
[103]
زيادة الألف في الأسماء المنونة بالفتح والنصب:
قال المصنف موجّها هذه الزيادة: "وكذلك زيدت الألف في الاسم المفتوح المنون علامة على أنّه وسط بالنسبة إلى المرفوع والمخفوض وأنّه كامل متمكّن بالنسبة إلى غيره."
[104]
إذا تجاوزنا مسألة وسطية الألف وحقيقة كماله وتمكّنه فإنّ أهمّ ما يلاحظ على هذا التوجيه ما يلي:
إنّ الألف زيد في التنوين المفتوح والمنصوب دون غيرهما لأنّ الوقف عليه يكون بالألف عوضا عن التنوين، بينما يوقف على المنوّن بغير الفتح والنصب بالحذف لا بالإبدال. ومعلوم أنّ الرسم يراعى فيه الابتداء بالكلمة والوقف عليها.
إنّ الزيادة في اصطلاح علماء الرسم هي ما زيد في الرسم على خلاف اللفظ وصلا ووقفاً أو هي تلك الرموز الكتابية التي ليس لها مقابل في أصوات الكلمة وصلا ووقفاً
[105]. وكأنّ المصنف من خلال إدراجه حرف
(ﯢ
) وألف التنوين في حكم الزيادة لم يعتدّ بشرط اعتبار الوصل والوقف فيها، وهذا شذوذ آخر عن مبادئ هذا العلم ومخالفة أخرى تضاف إلى مخالفاته الكثيرة في الاصطلاح والتبويب والتوجيه والمبادئ والمسائل والتعريف...
[1] عنوان الدليل ص57.
[2] راجع تفصيل ما زيدت فيه الألف بعد الواو المتطرفة في: مختصر التبيين 2\78...، الطراز للتنسي ص336...، رسم المصحف ص286.
[3] كالتفريق بين الأفعال والأسماء وكون الفعل يقتضي الفاعل والواو أثقل الحروف والضمة أثقل الحركات والتفريق بين السكون والتحريك....إلخ
[4] عنوان الدليل ص58.
[5] مذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي ص483-484.
[6] سبأ 5. ينظر: الهجاء ص95، العقيلي ص184، مختصر التبيين 2\83، الوسيلة ص269، جميلة الجعبري ص501، دليل الحيران ص156، رسم المصحف ص286...
[7] عنوان الدليل ص 58-59.
[8] الأعراف 116، الفرقان 4، يوسف 16-18.المواضع التي أوردها المصنف وقد جاءت في مواضع أخرى منها: آل عمران 184، النور 11-13، النمل 84، الحشر 10... ينظر: مختصر التبيين 2\81، الوسيلة ص269، جميلة الجعبري ص499...، دليل الحيران ص156، رسم المصحف ص284...
[9] عنوان الدليل ص 59.
[10] البقرة 226. ينظر: العقيلي ص93، مختصر التبيين 2\82، الوسيلة ص269، الجعبري ص501، دليل الحيران ص156، رسم المصحف ص284...
[11] عنوان الدليل ص 59.
[12] الحشر 9. ينظر: العقيلي ص214، مختصر التبيين 2\83، الوسيلة ص269، الجعبري ص501-502، دليل الحيران ص156، رسم المصحف ص284...
[13] عنوان الدليل ص 59.
[14] آل عمران 112. ينظر: العقيلي ص85، مختصر التبيين 2\81، الوسيلة ص269، الجعبري ص501، دليل الحيران ص156، رسم المصحف ص284...
[15] عنوان الدليل ص 59.
[16] النساء 99. ينظر: العقيلي ص93، مختصر التبيين 2\82، الوسيلة ص269-270، الجعبري ص502، دليل الحيران ص157، رسم المصحف ص284...
[17] عنوان الدليل ص59.
[18] الفرقان 21. ينظر: العقيلي ص163، مختصر التبيين 2\83، الهجاء ص95، الوسيلة ص269، الجعبري ص501، دليل الحيران ص156، رسم المصحف ص284...
[19] عنوان الدليل ص 60.
[20] المطففين 3.
[21] عنوان الدليل ص 60.
[22] الحج 51.
[23] سبأ 5.
[24] آل عمران 184.
[25] الشورى 25.
[26] الشورى 30.
[27] الأعراف 77.
[28] الأعراف 166.
[29] الذاريات 44.
[30] الجعبري ص497.
[31] يقصد الخراز في نظمه مورد الظمآن في فنيّ الرسم والضبط.
[32] دليل الحيران 157.
[33] الوسيلة 270.
[34] الروم 39. ينظر: مختصر التبيين 2\83، الوسيلة 268، دليل الحيران 157.
[35] الأحزاب 69. ينظر: المصادر والمراجع السابقة.
[36] محمد 31. ينظر: الوسيلة ص269.
[37] الكهف 14. ينظر: الوسيلة 269.
[38] يوسف 86.
[39] الكهف 110.
[40] محمد شملول ص142.
[41] المرجع نفسه ص74.
[42] المرجع نفسه ص75. حمدي الشيخ ص54.
[43] المرجع نفسه ص75-76. حمدي الشيخ ص74-75.
[44] (أ) المرجع نفسه ص77-78.
[45] المرجع السابق ص78.
[46] المحكم ص177.
[47] رسم المصحف ص286.
[48] التنسي في الطراز ص356-363، دليل الحيران ص158، رسم المصحف ص293...
[49] محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول أبو بكر المعروف بالصولي قال الخطيب:""كان أحد العلماء بفنون الآداب، حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء، ومآثر الأشراف، وطبقات الشعراء.وحدث عن أبي داود السجستاني، وأبوي العباس ثعلب والمبرد" توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة (335هـ). إنباه الرواة 3\233، تاريخ بغداد 4\675، سير أعلام النبلاء 15\301
[50] أدب الكتاب، أبو بكر محمد بن يحيى الصولي. تصحيح وتعليق وتحشية: محمد بهجة الأثري، بعناية السيد محمود شكري الآلوسي. المكتبة العربية بغداد بالاشتراك مع المطبعة السلفية القاهرة. 1341هـ . ص246
[51] الكتاب لابن درستويه ص84. وما بين المعكوفتين [...] تصحيح من النسخ التي لم يعتمدها محقق الكتاب ومن النّص الذي نقله الأستاذ غانم قدوري الحمد في رسم المصحف ص290.
[52] رسم المصحف ص287.
[53] أدب الكاتب لابن قتيبة 225، ونسبه الصولي في كتابه للأخفش ص246.
[54] الطراز ص357 وما بعدها، الكتاب لابن درستويه ص83.
[55] المدثر 18.
[56] المدثر 23.
[57] النساء 51.
[58] الطراز ص359.
[59] رسم المصحف ص288.
[60] نسب أبو بكر الصولي هذا القول للفراء. أدب الكاتب ص646.
[61] رسم المصحف ص287-288.
[62] رسم المصحف ص288.
[63] الشورى 37.
[64] البقرة 191.
[65] الطراز للتنسي ص357.
[66] الكتاب لابن درستويه ص83.
[67] أبو العباس المُبرِّد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سُليم بن سعد، شيخ أهل النحو وحافظ العربية كان من أهل البصرة فسكن بغداد، ولد بالبصرة سنة عشرة ومائتين (210هـ) توفي سنة ست وثمانين ومائتين (286هـ). إنباه الرواة 3\241، تاريخ العلماء النحويين للتنوخي 1\53، تاريخ بغداد 4\603، سير أعلام النبلاء 13\576، الأعلام 7\144.
[68] أدب الكاتب للصولي ص246. وإلى هذا أشار ابن عاشر حين قال: "زيدت بعد واو الجمع بدلا من ضمير المفعول" نقلا عن الأستاذ أحمد شرشال هامش الطراز ص359.
[69] الطراز ص363
[70] أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين (213هـ)، قال الذهبي: العلامة الكبير ذو الفنون. من مصنفاته: غريب القرآن، غريب الحديث، مشكل القرآن، مشكل الحديث، أدب الكاتبن عيون الأخبار، طبقات الشعراء... توفي سنة ست وسبعين ومائتين (276هـ). سير أعلام النبلاء 13\296.
[71] أدب الكاتب 226.
[72] المائدة 29. ينظر: المقنع ص355، المهدوي ص60، مختصر التبيين 2\52-53-440، العقيلي ص106، الهجاء ص138، الوسيلة ص310...، الجعبري ص591...
[73] القصص 76. ينظر: المقنع ص355، المهدوي ص60، مختصر التبيين 2\52-53 ، 4\972، العقيلي ص174، الهجاء ص201، الوسيلة ص310، الجعبري ص591...
[74] عنوان الدليل ص60.
[75] يوسف 56.
[76] الزمر 74.
[77] يونس 87.
[78] الحشر 9.
[79] الهجاء ص161.
[80][80] طبعاً الصوائت القصيرة (الفتحة، الضمة، الكسرة) لا تندرج في الرسم لأنّها في الكتابة العربية تُمثّل في ضبط الكلمة وشكلها لا في رسمها.
[81] المهدوي ص60، مختصر التبيين 2\52-53. وإذا كان الداني قد ذكره في "باب ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللفظ أو لمعنى" فقد جعل له ولأمثاله فصلا خاصا كأنّه استدراك لباب الهمز حيث قال في أوّل هذا الفصل: "واتفق كُتّاب المصاحف على رسم ألف بعد الواو صورة للهمزة في قوله في المائدة
(ﯔ ﯕ ﯖ
) وفي قوله في القصص
(ﯗ ﯘ
) ولا أعلم همزة متطرفة قبلها ساكن صوّرت خطا في المصحف إلاّ في هذين الموضعين لا غير." ص355
[82] اصطلاح يطلقه علماء الرسم في مقابل "المكرر" للمتعدد في المصحف الشريف، و"للمنوع" الذي اختلفت صيغه. راجع دليل الحيران ص21-22-31.
[83] الروم 10.
[84] الوسيلة ص310.
[85] الإسراء 7.
[86] التذكرة في القراءات، أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون (399هـ). دار الهدى عين مليلة 2008م ص263. الإقناع في القراءات السبع، أبو جعفر أحمد بن علي بن خلف الأنصاري، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1419هـ 1999م ص420. النشر 2\306، إتحاف فضلاء البشر ص355، المهذب 2\87، مختصر التبيين 4\972.
[87] وردت كلمة اللؤلؤ معدّدة ومنوعة في حوالي ستة مواضع: الحج 23، فاطر 33، الإنسان 19، الواقعة 23، الرحمن22، الطور 24. والموضع الذي مثّل به المصنف هو موضع الواقعة. ينظر تحرير حكم رسمها في: المقنع ص345...، مختصر التبيين 2\85-4\872...، العقيلي ص156-185، الطراز للتنسي ص372...، دليل الحيران ص158...، سمير الطالبين ص55، المتحف ص35...
[88] عنوان الدليل ص61.
[89] هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني مولى محمد بن ربيعة، تابعي جليل اشتغل بكتابة المصاحف وهو أحد شيوخ نافع المقرئ (ت 117هـ) معرفة القراء الكبار ص43.
[90] المقنع ص347. ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصار. أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (748هـ). ص43. غاية النهاية في طبقات القراء 1\381 ترجمة رقم: 1266.
[91] المقنع ص348.
[92] المصدر السابق.
[93] وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنه. ينظر: الدّرّ المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي (911هـ) تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي. مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية القاهرة 1424هـ 2003م. ج14\ص189.
[94] وهو تفسير الضحاك، المرجع السابق: ج14\ص189.
[95] المقنع 355، مختصر التبيين 4\972، المهدوي ص60...
[96] حتى وإن لاحظوا وسجلوا مخالفة هذا الرسم للقياس كما نصّ عليه الشاطبي في الرائية حيث قال في البيت (209):
وأن تبوأ مع السَوْآى تَنوأ بها قدْ صُوِّرت ألفاً مِنْهُ القياسُ بَرَا. [أي بَرِئَ]
[97] جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد ص592.
[98] دليل الحيران ص158، وإلى هذا أشار الخراز في نظمه بقوله: ولؤلؤاً منتصبا يكون بألف فيه هو التنوينُ.
[99] يقول الخراز:
ولؤلؤاً منتصبا يكون
| بألف فيه هو التنوينُ.
|
وزاد بعضهم في سوى ذا الشكل
| تقويةً للهمز أو للفصل
|
ينظر دليل الحيران ص158.
[100] الطراز ص373.
[101] المقنع ص346، الطراز ص373، دليل الحيران ص159...
[102] المقنع ص346، الطراز ص373، الخراز ينظر دليل الحيران ص158.
[103] ينظر هامش مختصر التبيين 4\872.
[104] عنوان الدليل ص61.
[105] ينظر: الطراز ص407-408.