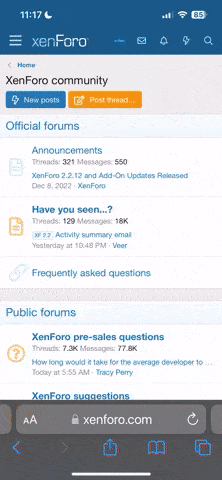حسن علي حسن خليل
New member
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هذه أول مشاركة لي في هذا الملتقى المبارك بأهله ، أعرض فيها قطعة من تفسير البحر أبي حيان رحمه الله مع تعليقي عليها ، وأنتظر مشاركة العلماء الأكارم وطلبة العلم الأفاضل ، فإني ما جئت هنا إلا متعلما للعلم من أهله وجزاكم الله خيرا.
قال الإمام أبو حيان رحمه الله :
1 - قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَقَتَادَةُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ وَجَعْفَرٌ الصَّادِقُ: الْفَاتِحَةُ مَكِّيَّةٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ : [ وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ] 1 وَالْحِجْرُ مَكِّيَّةٌ بِإِجْمَاعٍ.
- وَفِي حَدِيثِ أُبَيٍّ: [ إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي ].
- وَالسَّبْعُ الطِّوَالُ، أُنْزِلَتْ بَعْدَ الْحِجْرِ بِمُدَدٍ.
- وَلَا خِلَافَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ ، وَمَا حُفِظَ أَنَّهُ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ صَلَاةٌ بِغَيْرِ [ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ] 2
2 - وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَوَادُ بْنُ زِيَادٍ وَالزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: هِيَ مَدَنِيَّةٌ.
3 -
وَقِيلَ إِنَّهَا مَكِّيَّةٌ مَدَنِيَّةٌ. انتهى كلامه رحمه الله.
______________________
1 - قال الحسن بن علي عفا الله عنهما:
هذه الآية من سورة الحجر، والاستدلال بها مبني على مقدمات:
* أولا أنها مكية، وقد نقل فيه المصنف الإجماع.
* ثانيا أن الفعل الماضي يفيد المضي، وهو الغالب فيه، وقد يأتي للمستقبل مثل [ أتى أمر الله فلا تستعجلوه ] كأنه قال أمر الله كائن يقينا فلا تتعجلوه ، والدليل عليه هنا ظني ، وهو أن المقام مقام امتنان ، والمنة تكون بما جرى لا بما لم يجر بعد ، وهذا دليل ظني لأن الله امتن على نبيه بنهر الكوثر وهو لم يعطهُ بعدُ ، فهذا امتنانٌ بمستقبل.
* ثالثا: أن السبع المثاني هي الفاتحة، فاستدل له المصنف بحديث أبي.
-- وتخريجه كما في جامع الأصول:
عن عبد الحميد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: [ ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ] رواه الترمذي والنسائي، وله شاهد في البخاري وأبي داود والنسائي عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى وفيه: [ {الحمد لله رب العالمين} هي السَّبْعُ المثَاني، والقرآنُ العَظيمُ الذي أوتِيتُه ] وله شاهد ثالث عند أبي داود والترمذي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: [{ الحمد لله رب العالمين } أُمُّ القرآن، وأُمُّ الكتاب، والسبعُ المثاني ] وقال الترمذي حسن صحيح.
- هذا وقد نقل العلامة الألباني رحمه الله عن الباجي قوله:
" يريد قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ المَثَانِي وَالقُرْآنَ العَظِيمَ}. وسميت السبع ؛ لأنها سبع آيات ، والمثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي: تعاد ، وإنما قيل لها: (القرآن العظيم) على معنى التخصيص لها بهذا الاسم ، وإن كان كل شيء من القرآن قرآناً عظيماً ؛ كما يقال في الكعبة: (بيت الله) وإن كانت البيوت كلها لله ، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم له ". اهـ.
ثم قال الألباني رحمه الله: والحديث نص صريح في بيان المراد من الآية، وهو {الفَاتِحَة}؛ فلا يلتفت بعد ذلك إلى ما يخالفه من الأقوال مهما كان شأن قائله.
* فإذا ثبتت هذه المقامات الثلاثة سلم احتجاجه على من قال إنها مدنية ، وأما من قال نزلت مرتين فلابد من مقام رابع:
* وهو عدم ثبوت نزولها في المدينة ، والثابت عكسه ، فقد روى مسلم والنسائي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «بينا جبريلُ عليه السلام قَاعِد عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم سمع نَقِيضاً من فوقه ، فرفع رأسَه ، فقال: هذا باب من السماء فُتحَ اليوم ، لم يُفْتَحْ قَطُّ إلا اليوم، فنزل منه مَلَك، فقال: هذا مَلك نزل إلى الأرض ، لم ينزل قط إلا اليوم ، فسلَّم ، وقال: أبْشِرْ بنورَين أُوتيتَهما لم يُؤتَهما نبيّ قبلَكَ: فاتحةُ الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أُعْطِيتَه» انتهى
وخواتيم البقرة لم تنزل إلا في المدينة، وقد انفصل القرطبي من هذا الدليل بأن الذي نزل في المدينة فضلها لا ذاتها، وهو قول قريب، وقد يؤيده قوله [ أوتيتهما ] فدل على أن هذا الحدث جرى بعد نزول الخواتيم أيضا ، إلا إذا تأولت الماضي كما تقدم والله أعلم.
لطيفة: ابتداءً كلُّ قول من الأقوال يحتاج لعزو وتثبت ، وقد تركت ذلك لقلة وقتي ثم لقلة قيمته لأن العبرة بالدليل لا بالقائل ، وقد تأملت فيما حكاه البحر رحمه الله فوجدت أن التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله قال أنها مكية ، مع أنه روى الحديث الذي يمكن الاستدلال به على أنها مدنية ، وتلمح العكس في قول الصحابي الكبير أبي هريرة رضي الله عنه فهو راوي الحديث الذي يحتج به على مكيتها ومع ذلك يعزون إليه أنه قائل بمدنيتها .
- وأصل ذلك أن تعلم أن رواية دليل لا يعني أن راويه سلم بمدلوله لأنه قد ينازع في بعض مقامات الاستدلال السالفة الذكر وغيرها ، لذلك قالوا: العلم مؤسس على جمع الأدلة ، لا على الأخذ بدليل وترك آخر لأن أحدهما ليس بأولى من أخيه والله أعلم.
2 - قال الحسن بن علي عفا الله عنهما: هذه حجة لا تجدي لأن عدم العلم لا يلزم منه العلم بالعدم، وهي تشبه البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية عند النقاش هي آخر الأدلة لا أولها، لأن معناها بقاء ما كان على ما كان، فالأصل في الحلال أن يبقى حلالا فمن ادعى تغير الحكم فهو المطالب بالدليل، فإن أتى بأدنى دليل لم يجز الاستدلال عليه بالأصل ما لم تنقض دليله وشبهته والله أعلم.
هذه أول مشاركة لي في هذا الملتقى المبارك بأهله ، أعرض فيها قطعة من تفسير البحر أبي حيان رحمه الله مع تعليقي عليها ، وأنتظر مشاركة العلماء الأكارم وطلبة العلم الأفاضل ، فإني ما جئت هنا إلا متعلما للعلم من أهله وجزاكم الله خيرا.
قال الإمام أبو حيان رحمه الله :
1 - قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَقَتَادَةُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ وَجَعْفَرٌ الصَّادِقُ: الْفَاتِحَةُ مَكِّيَّةٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ : [ وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ] 1 وَالْحِجْرُ مَكِّيَّةٌ بِإِجْمَاعٍ.
- وَفِي حَدِيثِ أُبَيٍّ: [ إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي ].
- وَالسَّبْعُ الطِّوَالُ، أُنْزِلَتْ بَعْدَ الْحِجْرِ بِمُدَدٍ.
- وَلَا خِلَافَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ ، وَمَا حُفِظَ أَنَّهُ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ صَلَاةٌ بِغَيْرِ [ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ] 2
2 - وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَوَادُ بْنُ زِيَادٍ وَالزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: هِيَ مَدَنِيَّةٌ.
3 -
وَقِيلَ إِنَّهَا مَكِّيَّةٌ مَدَنِيَّةٌ. انتهى كلامه رحمه الله.
______________________
1 - قال الحسن بن علي عفا الله عنهما:
هذه الآية من سورة الحجر، والاستدلال بها مبني على مقدمات:
* أولا أنها مكية، وقد نقل فيه المصنف الإجماع.
* ثانيا أن الفعل الماضي يفيد المضي، وهو الغالب فيه، وقد يأتي للمستقبل مثل [ أتى أمر الله فلا تستعجلوه ] كأنه قال أمر الله كائن يقينا فلا تتعجلوه ، والدليل عليه هنا ظني ، وهو أن المقام مقام امتنان ، والمنة تكون بما جرى لا بما لم يجر بعد ، وهذا دليل ظني لأن الله امتن على نبيه بنهر الكوثر وهو لم يعطهُ بعدُ ، فهذا امتنانٌ بمستقبل.
* ثالثا: أن السبع المثاني هي الفاتحة، فاستدل له المصنف بحديث أبي.
-- وتخريجه كما في جامع الأصول:
عن عبد الحميد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: [ ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ] رواه الترمذي والنسائي، وله شاهد في البخاري وأبي داود والنسائي عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى وفيه: [ {الحمد لله رب العالمين} هي السَّبْعُ المثَاني، والقرآنُ العَظيمُ الذي أوتِيتُه ] وله شاهد ثالث عند أبي داود والترمذي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: [{ الحمد لله رب العالمين } أُمُّ القرآن، وأُمُّ الكتاب، والسبعُ المثاني ] وقال الترمذي حسن صحيح.
- هذا وقد نقل العلامة الألباني رحمه الله عن الباجي قوله:
" يريد قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ المَثَانِي وَالقُرْآنَ العَظِيمَ}. وسميت السبع ؛ لأنها سبع آيات ، والمثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي: تعاد ، وإنما قيل لها: (القرآن العظيم) على معنى التخصيص لها بهذا الاسم ، وإن كان كل شيء من القرآن قرآناً عظيماً ؛ كما يقال في الكعبة: (بيت الله) وإن كانت البيوت كلها لله ، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم له ". اهـ.
ثم قال الألباني رحمه الله: والحديث نص صريح في بيان المراد من الآية، وهو {الفَاتِحَة}؛ فلا يلتفت بعد ذلك إلى ما يخالفه من الأقوال مهما كان شأن قائله.
* فإذا ثبتت هذه المقامات الثلاثة سلم احتجاجه على من قال إنها مدنية ، وأما من قال نزلت مرتين فلابد من مقام رابع:
* وهو عدم ثبوت نزولها في المدينة ، والثابت عكسه ، فقد روى مسلم والنسائي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «بينا جبريلُ عليه السلام قَاعِد عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم سمع نَقِيضاً من فوقه ، فرفع رأسَه ، فقال: هذا باب من السماء فُتحَ اليوم ، لم يُفْتَحْ قَطُّ إلا اليوم، فنزل منه مَلَك، فقال: هذا مَلك نزل إلى الأرض ، لم ينزل قط إلا اليوم ، فسلَّم ، وقال: أبْشِرْ بنورَين أُوتيتَهما لم يُؤتَهما نبيّ قبلَكَ: فاتحةُ الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أُعْطِيتَه» انتهى
وخواتيم البقرة لم تنزل إلا في المدينة، وقد انفصل القرطبي من هذا الدليل بأن الذي نزل في المدينة فضلها لا ذاتها، وهو قول قريب، وقد يؤيده قوله [ أوتيتهما ] فدل على أن هذا الحدث جرى بعد نزول الخواتيم أيضا ، إلا إذا تأولت الماضي كما تقدم والله أعلم.
لطيفة: ابتداءً كلُّ قول من الأقوال يحتاج لعزو وتثبت ، وقد تركت ذلك لقلة وقتي ثم لقلة قيمته لأن العبرة بالدليل لا بالقائل ، وقد تأملت فيما حكاه البحر رحمه الله فوجدت أن التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله قال أنها مكية ، مع أنه روى الحديث الذي يمكن الاستدلال به على أنها مدنية ، وتلمح العكس في قول الصحابي الكبير أبي هريرة رضي الله عنه فهو راوي الحديث الذي يحتج به على مكيتها ومع ذلك يعزون إليه أنه قائل بمدنيتها .
- وأصل ذلك أن تعلم أن رواية دليل لا يعني أن راويه سلم بمدلوله لأنه قد ينازع في بعض مقامات الاستدلال السالفة الذكر وغيرها ، لذلك قالوا: العلم مؤسس على جمع الأدلة ، لا على الأخذ بدليل وترك آخر لأن أحدهما ليس بأولى من أخيه والله أعلم.
2 - قال الحسن بن علي عفا الله عنهما: هذه حجة لا تجدي لأن عدم العلم لا يلزم منه العلم بالعدم، وهي تشبه البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية عند النقاش هي آخر الأدلة لا أولها، لأن معناها بقاء ما كان على ما كان، فالأصل في الحلال أن يبقى حلالا فمن ادعى تغير الحكم فهو المطالب بالدليل، فإن أتى بأدنى دليل لم يجز الاستدلال عليه بالأصل ما لم تنقض دليله وشبهته والله أعلم.